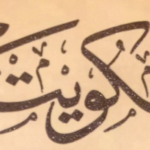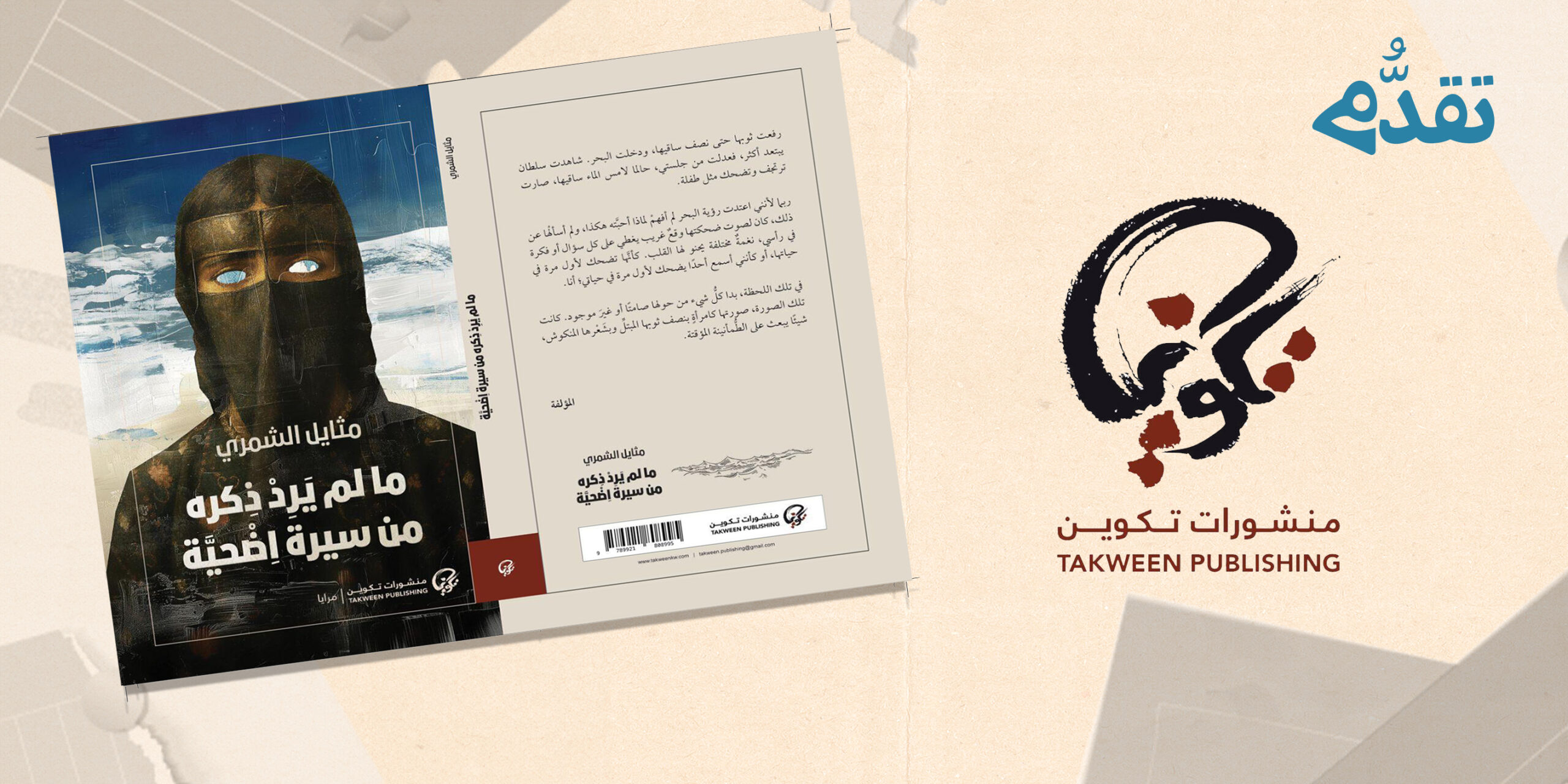
“ما لم يَرِدْ ذِكره من سيرة اِضْحيَّة”
صدر عن منشورات تكوين رواية ” ما لم يَرِدْ ذِكره من سيرة اِضْحيَّة” لـ مثايل الشمري. “الحقيقة ليست مقيَّدة بأن تُوجِد الأشياء أو تحدث، وإنَّما

يُعرف كارل ماركس المادية الجدلية بأنها المنهج الفلسفي الذي يُفسر تطورات الطبيعة والفكر الإنساني والمجتمع استناداً إلى قوانين مادية وموضوعية، لا تعتمد على وعي الأفراد أو رغباتهم، بل تتحدد بالعلاقات المادية بين البشر في سياقها التاريخي والاجتماعي. وقد خالف بذلك فلسفة أستاذه هيغل، الذي رأى أن الأفكار هي المحرِّك الأساسي للتاريخ؛ إذ أكد ماركس بأن الوجود الاجتماعي هو ما يُحدد الوعي، بمعنى أن الأفكار لا تغيّر العالم، بل الصراع الطبقي داخل نمط الإنتاج هو ما يدفع عجلة التاريخ إلى الأمام.
وفي جوهر المادية الجدلية، تبرز ثلاثة مفاهيم رئيسية:
أولاً: الصراع ووحدة الأضداد، حيث إن كل شيء يتطور نتيجة تناقض داخلي بين قواه المتعارضة، ولا شيء يبقى ثابتاً.
ثانياً: تحول الكم إلى كيف، بمعنى أن التراكمات الصغيرة تقود في لحظة ما إلى تغيير جوهري، فالكميّة تتحول إلى نوعيّة.
وأخيراً: نفي النفي، أي أن كل مرحلة تاريخية تنفي سابقتها، لكنها لا تلغيها تماماً، بل تحتفظ بعناصرها وتُعيد تشكيلها في صيغة جديدة.
وعليه، فإن النظرية الجدلية ليست مجرد فلسفة نظرية تأملية، بل هي منهج لفهم العالم والعمل على تغييره. وانطلاقاً من ذلك، سنسعى لتطبيق هذا المنهج الجدلي على الاقتصاد والسياسة، كبُعدين جوهريين في البنية المجتمعية.
فيما يتعلق بـ الاقتصاد، فهو ليس منظومة جامدة أو قوانين أبدية، بل ساحة صراع طبقي متحرّكة. فالنظام الرأسمالي لا يُمثّل طبيعة ثابتة، بل هو نتيجة تاريخية لتطور علاقات الإنتاج. ضمن هذا النظام، يوجد تناقض جوهري بين قوى الإنتاج (مثل العامل، التكنولوجيا)، ووسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج (كالملكية والسيطرة الرأسمالية)، مما يخلق صراعاً مستمراً بين طبقتين أساسيتين: البرجوازية التي تمتلك أدوات الإنتاج، والبروليتاريا التي لا تملك سوى قدرتها على العمل. هذا الصراع لا ينتهي بتسوية أو مصالحة، بل يتطور إلى لحظة تحول ثوري.
أما في السياسة، فالمادية الجدلية تكشف زيف التصورات الليبرالية التي تقدّم الدولة ككيان محايد وفوقي، وتُعرّيها باعتبارها أداة طبقية تهدف إلى حماية مصالح الطبقة المسيطرة. فالدولة ليست سوى انعكاس لعلاقات الإنتاج السائدة، وكل دستور أو نظام انتخابي أو قانون ليس إلَّا شكلاً من أشكال تثبيت الهيمنة الطبقية. ومن هنا، فإن الثورة لا تكون اقتصادية فقط، بل سياسية بامتياز، إذ تسعى لتحطيم جهاز الدولة البرجوازي وتشييد دولة البروليتاريا كمرحلة انتقالية نحو الشيوعية.
وهكذا، توضّح المادية الجدلية أن التغيير لا يأتي من أفكار مجردة أو رغبات حالمة، بل من تناقضات الواقع المادي نفسه. إنها سلاح نظري بيد الثوريين لرؤية العالم كما هو، من أجل إعادة تشكيله كما يجب.
ننتقل الآن من مستوى النظرية العامة إلى تطبيقاتها في جنوب العالم، عبر مثقفَيْن اثنَيْن شكّلا منعطفاً في تجديد المادية الجدلية: مهدي عامل وسمير أمين.
النظرية أداة اشتباك تحرري وليست تأملاً مجرداً
يتبنى مهدي عامل المادية الجدلية كمنهج تحليلي يُمارس على الواقع العربي التبعي تجديداً، مُتفقاً مع ماركس في أن الوعي نتاج للبنية التحتية. لكنه يُضيف أن هذا الوعي في العالم العربي يتشكل ضمن سياق الخضوع البنيوي للإمبريالية. وبالتالي، لا يكتفي عامل باستخدام المادية الجدلية لفهم الواقع، بل يراها سلاحاً ثورياً لتفكيك الأيديولوجيا التي تصوغ وعي الإنسان في مجتمعاتنا التابعة.
إن المادية الجدلية عند عامل تفكك البُنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية من داخلها، عبر تحليل تناقضاتها الداخلية، فهي علمٌ للحركة والتغيير، لا تعترف بالثبات أو المطلق. الواقع ليس معطى جامداً، بل بنية تاريخية متحركة، والوعي لا يسبق الواقع بل ينتج عنه.
وعند تطبيق هذه الرؤية على الواقع العربي، نجد أن الماركسية الغربية لا تصلح كنص مقدس يُستنسخ، بل هي أداة منهجية ينبغي أن تتفاعل مع خصوصية المجتمعات الكولونيالية التابعة. فالمجتمع العربي ليس رأسمالياً مكتمل البناء، بل يعاني تشوّهاً بنيوياً بفعل الاستعمار والإمبريالية. لهذا، لا يمكن الحديث عن الصراع الطبقي بمعزل عن الإمبريالية، إذ أن البنية الكولونيالية نفسها تُنتج نمط إنتاج تابع وهجين، يعيد تشكيل علاقات الإنتاج بما يخدم مصالح الخارج.
وفقاً لذلك، فإن الثورة في فكر عامل ليست اقتصادية فقط، بل هي تحرر وطني وثورة طبقية في آنٍ معاً. والدولة، في هذا السياق، ليست حامية للبرجوازية الوطنية، بل جهاز يعيد إنتاج التبعية لصالح التحالف الطبقي الكولونيالي. أما الثقافة، فهي خاضعة لهيمنة أيديولوجية قومية، دينية، أو ليبرالية، تعمل على ترسيخ وعي زائف يُكرّس الوضع القائم.
وهكذا، يكون ماركس قد وضع الأساس النظري لفهم الصراع من منطلق مادي ديالكتيكي، بينما قام مهدي عامل، بإعادة إنتاج هذا المنهج داخل الواقع المشوّه الكولونيالي، كاشفاً آليات السيطرة في المجتمعات العربية التابعة.
وبذلك تصبح النظرية أداة اشتباك تحرري وليست تأملاً مجرداً.
أما سمير أمين، فقد رفع صوت الماركسية من خارج المركز. ففي حين ركّز مهدي عامل على تفكيك البُنى الداخلية في العالم العربي، قدّم أمين قراءةً عالمية من موقع الأطراف – آسيا، إفريقيا، وأميركا اللاتينية – لفهم منظومة التراكم الرأسمالي.
سمير أمين والاختلاف في طبيعة الثورة بين المركز والأطراف
اعتمد أمين على المادية الجدلية لتحليل العلاقة غير المتكافئة بين المركز والأطراف، موضحاً أن الرأسمالية ليست مجرد نمط إنتاج طبقي داخل الدولة، بل نظام عالمي قائم على تقسيم العمل بين دول المراكز ودول الأطراف. وبهذا، تصبح المادية الجدلية عنده أداة لفهم نظام الاستغلال العالمي، حيث يُنتج الفقر في الجنوب لتتراكم الثورة في الشمال.
لذلك، في مجتمعات الجنوب، الصراع ليس طبقياً فقط، بل تحرري وطني أيضاً. وقد اتخذ أمين موقفاً نقدياً من الماركسية الأوروبية، معتبراً أن ماركس كان عبقرياً، لكن ماركسيته كانت ماركسية المركز. ولهذا طوّرها سمير أمين لتُصبح ماركسية الأطراف، تُركّز على التناقض بين شعوب الجنوب والنظام الرأسمالي العالمي، لا فقط بين البرجوازية والبروليتاريا في أوروبا.
من هذا المنطلق، تختلف طبيعة الثورة بين المركز والأطراف: في المركز يمكن أن تكون اشتراكية مباشرة، أما في الأطراف فلا بد أن تمر عبر مراحل تحرر وطني واستقلال اقتصادي قبل الوصول إلى الاشتراكية. أما المثقف، فلا مكان للحياد في هذا السياق؛ إما أن ينحاز للشعوب، أو يصطف مع الإمبريالية. لا مكان للتفسيرات الأكاديمية الباردة هنا، بل للانحياز الفعّال للوعي والممارسة.
ومن اللافت أن عامل وأمين يتقاطعان في استخدام المادية الجدلية لتحليل التفاوت البنيوي بين المركز والأطراف، وتفكيك البُنى الاجتماعية والسياسية في العالم العربي، مؤكدَين على أن المثقف لا يكون ثورياً إلا بانحيازه للشعوب وضد الأنظمة التابعة. فبينما يُحلل مهدي عامل الواقع العربي من الداخل، خصوصاً في لبنان، فإن أمين ينظر له من زاوية أوسع ضمن منظومة الاستغلال العالمية.
لقد حلل مهدي عامل أساس علاقة التبعية بأن الطبقة البرجوازية في المجتمعات الكولونيالية، بحكم موقعها الطبقي البرجوازي، تُعيد إنتاج علاقة التبعية البنيوية بالنظام الرأسمالي الإمبريالي الذي يخدم أصلاً مصالح الإمبريالية ويكرِّس التبعية؛ أمَّا سمير أمين فيُشير إلى أن العدو الأكبر هو النظام الرأسمالي العالمي نفسه، المتمركز في القوى الإمبريالية. وحتى تعريف نمط الإنتاج يختلف بينهما؛ فعامل يصفه بالمشوّه والتابع، بينما يعتبره أمين نمطاً خراجياً مستمداً من النمط الإقطاعي.
وبناءً على ما تقدم، يمكن القول إن المادية الجدلية، كما أسسها ماركس، هي حجر الأساس لفهم التاريخ والمجتمع من منظور الصراع الطبقي، لكنها ليست نصاً جامداً. لقد أُعيد إنتاجها في سياقات متعددة – من المراكز الأوروبية إلى ساحات المواجهة في الجنوب والعالم العربي – لتتماشى مع طبيعة الصراع الكولونيالي الطرفي.
في فكر مهدي عامل، تصبح المادية الجدلية أداة لفضح آليات الهيمنة الطبقية والأيديولوجية، حيث تُعاد إنتاج التبعية من خلال بُنى محلية شُكّلت على صورة المستعمِر لخدمة مصالحه واضعاً المثقف في قلب المعركة لبناء وعي طبقي نقدي. وكما يقول: “لا يمكن للمثقف أن يكون مثقفاً بأدوات إنتاجه من موقع المنبوذ أو موقع خادم السلطان”.
أما سمير أمين، فقد وسّع المادية الجدلية لتُصبح أداة تحليل للتراكم الرأسمالي العالمي، كاشفاً اعتماد النظام على الأطراف كمصدر للثروة، مقابل تراكمها في المراكز. وقد دعا إلى فك الارتباط وبناء مشروع تنموي مستقل خارج منظومة التبعية.
ختاماً، إن المادية الجدلية ليست مجرد وصف للعالم، بل دعوة لتغييره – تغييرٌ يبدأ من داخل تناقضات الواقع ومن مواجهة الاستبداد الداخلي والهيمنة الإمبريالية معاً. إنها سلاحٌ نظريٌ في يد من يريد أن يغيّر العالم، لا أن يشرحه فقط.
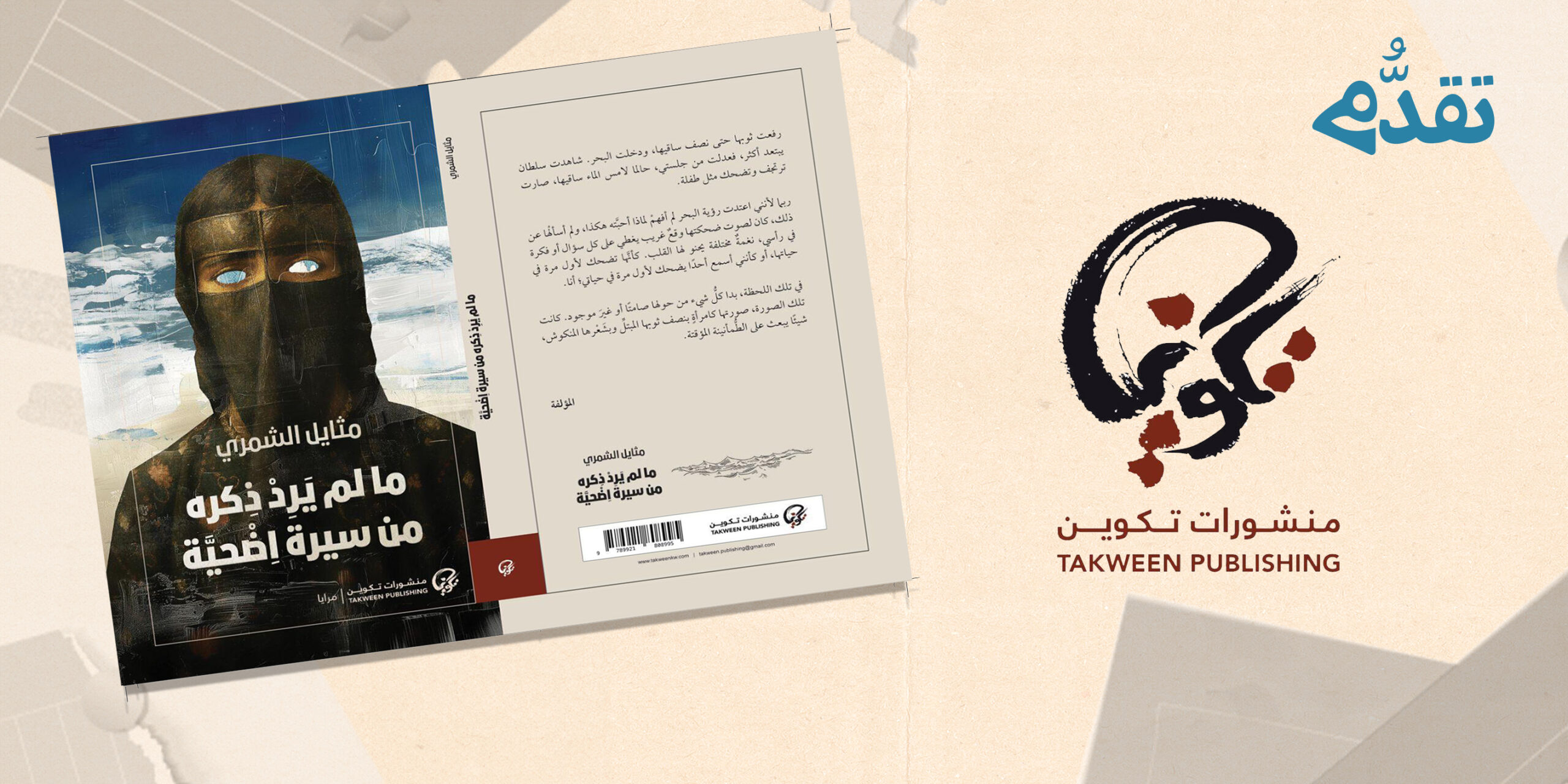
صدر عن منشورات تكوين رواية ” ما لم يَرِدْ ذِكره من سيرة اِضْحيَّة” لـ مثايل الشمري. “الحقيقة ليست مقيَّدة بأن تُوجِد الأشياء أو تحدث، وإنَّما
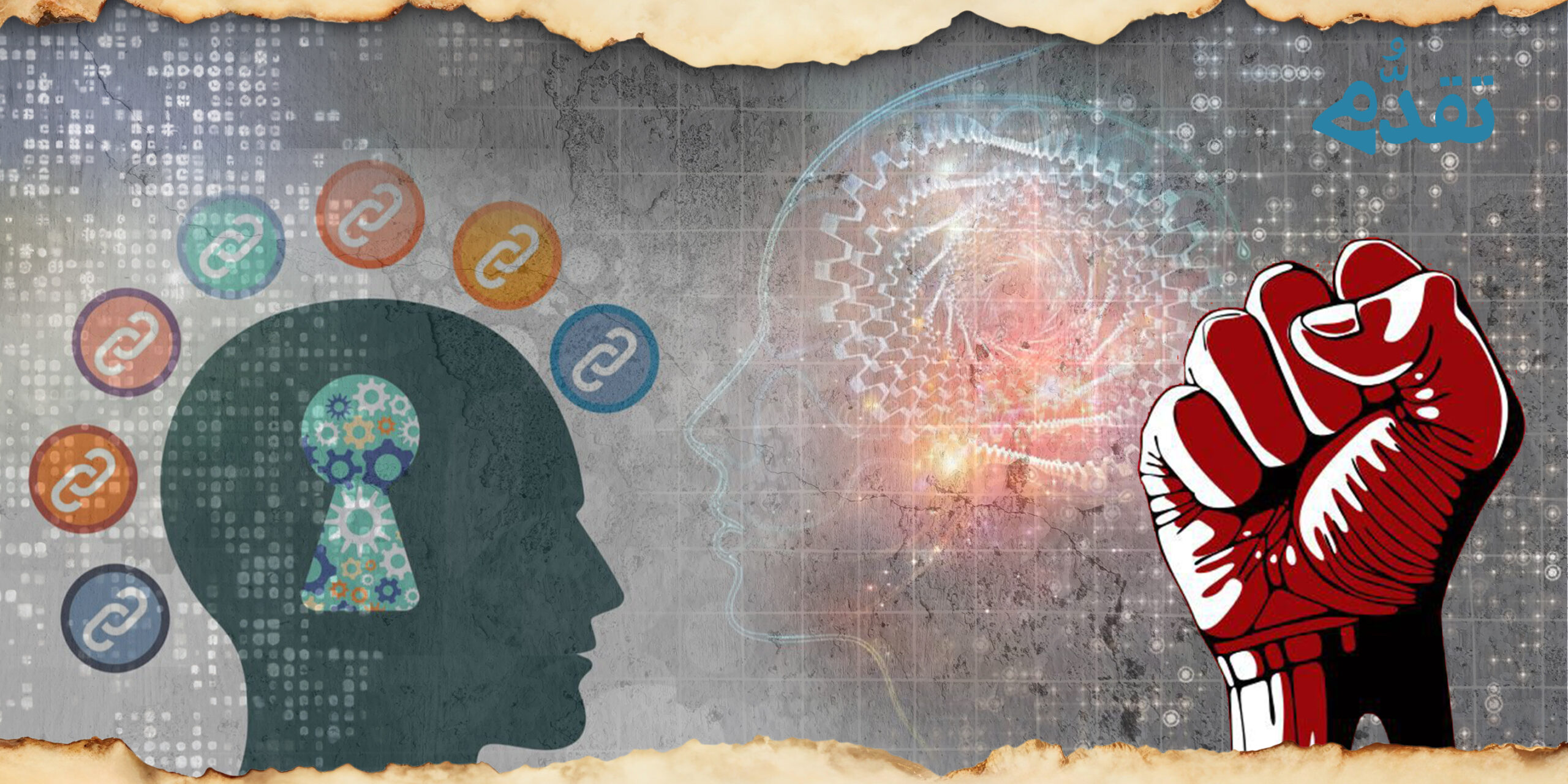
حصر الوضعية المنطقية مهمة الفلسفة بالتحليل المنطقي للغة يعني أتها تئد الفلسفة، والعلم ،والإبداع، تقيد الفلسفة بمجال واحد تصادر فيه باقي مفاهيم الفلسفة ومهمتها المناقضة لها، وتمنع حرية اختيار مفاهيم أخرى لها.

في رواية “مِخْيال معيوف” يبدأ السرد من ولادة معيوف في صحراء الشعيب غرب الكويت، حيث يقضي الأشهر الستّة الأولى من حياته عليلًا قبل نقله إلى

اللغة هي الحاضنة الأولى للهوية، والوعاء الذي تنعكس فيه الحضارة، وأداة الشعوب في صياغة وعيها ومكانتها بين الأمم. وفي زمن العولمة المتسارعة، تتعرض اللغة العربية