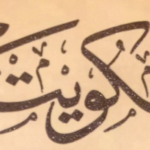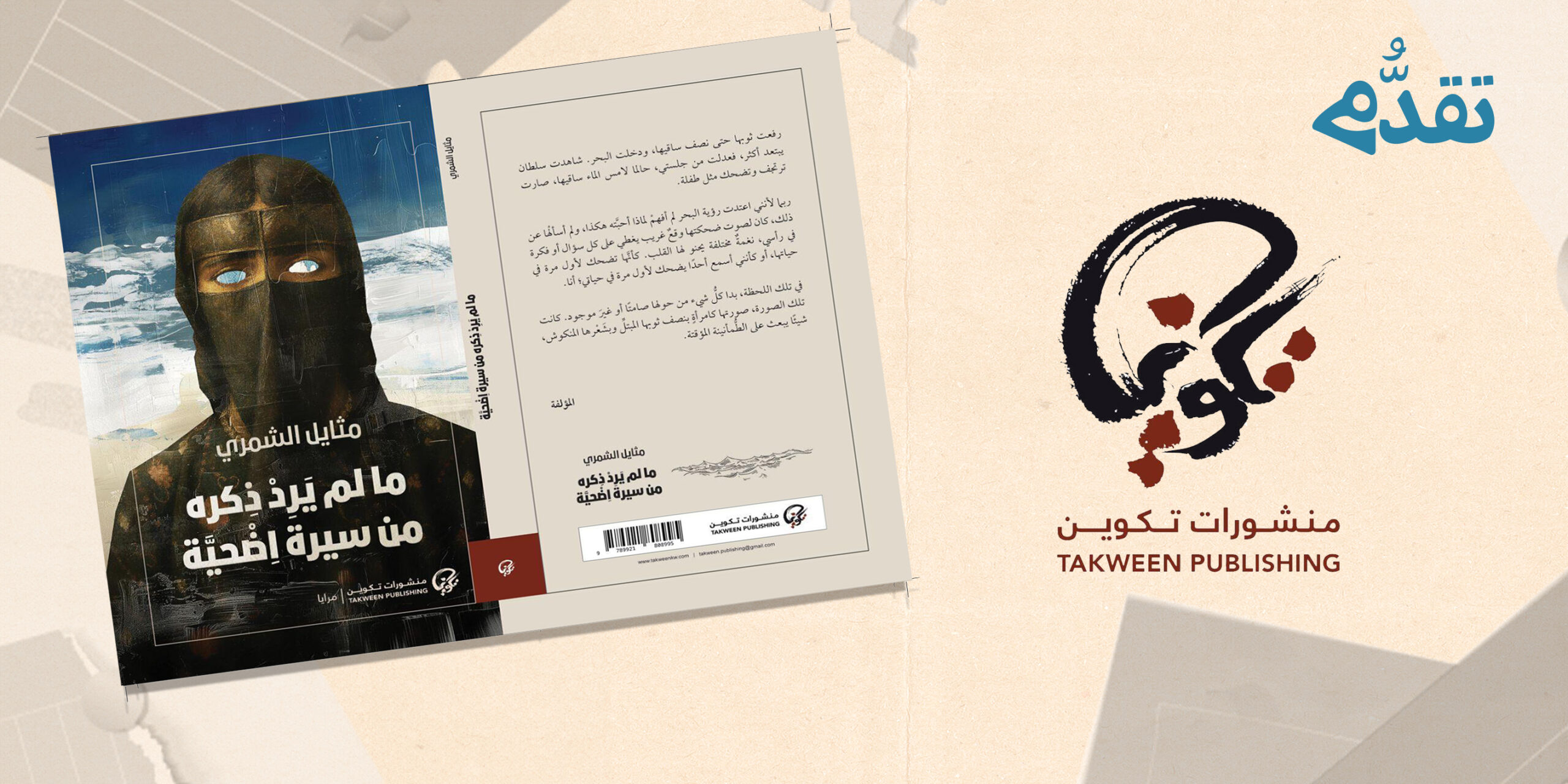
“ما لم يَرِدْ ذِكره من سيرة اِضْحيَّة”
صدر عن منشورات تكوين رواية ” ما لم يَرِدْ ذِكره من سيرة اِضْحيَّة” لـ مثايل الشمري. “الحقيقة ليست مقيَّدة بأن تُوجِد الأشياء أو تحدث، وإنَّما
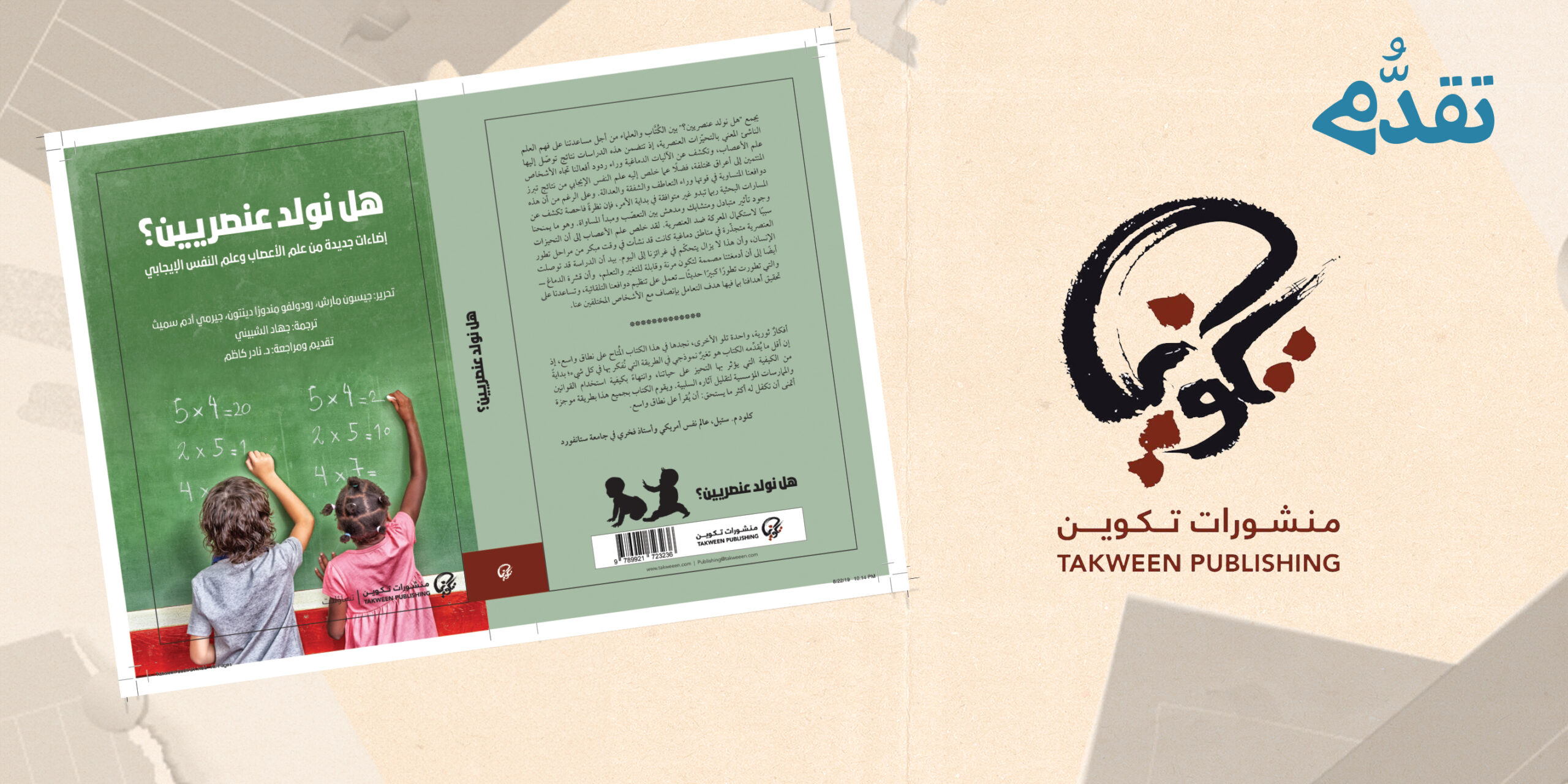
صدر عن منشورات تكوين كتاب “هل نولد عنصريين؟” (إضاءات جديدة من علم الأعصاب وعلم النفس الايجابي). تحرير جيسون مارش، ورودولفو مِندوزا دينتون، وجيرمي آدم سميث. ترجمة جهاد الشبيني، تقديم ومراجعة د. نادر كاظم.
كلمة غلاف هل نولد عنصريين
يجمع “هل نولد عنصريين؟” بين الكُتَّاب والعلماء من أجل مساعدتنا على فهم العلم الناشئ المعني بالتحيّزات العنصرية، إذ تتضمن هذه الدراسات نتائج توصّل إليها علم الأعصاب، وتكشف عن الآليات الدماغية وراء ردود أفعالنا تجاه الأشخاص المنتمين إلى أعراق مختلفة، فضلاً عما خلص إليه علم النفس الإيجابي من نتائج تبرز دوافعنا المتساوية في قوتها وراء التعاطف والشفقة والعدالة. وعلى الرغم من أن هذه المسارات البحثية ربما تبدو غير متوافقة في بداية الأمر، فإن نظرةً فاحصة تكشف عن وجود تأثير متبادل ومتشابك ومدهش بين التعصّب ومبدأ المساواة. وهو ما يمنحنا سبباً لاستكمال المعركة ضد العنصرية. لقد خلص علم الأعصاب إلى أن التحيزات العنصرية متجذّرة في مناطق دماغية كانت قد نشأت في وقت مبكر من مراحل تطور الإنسان، وأن هذا لا يزال يتحكّم في غرائزنا إلى اليوم. بيد أن الدراسة قد توصلت أيضاً إلى أن أدمغتنا مصممة لتكون مرنة وقابلة للتغير والتعلم، وأن قشرة الدماغ ــ والتي تطورت تطوراً كبيراً حديثاً ــ تعمل على تنظيم دوافعنا التلقائية، وتساعدنا على تحقيق أهدافنا بما فيها هدف التعامل بإنصاف مع الأشخاص المختلفين عنا.
أفكارٌ ثورية، واحدة تلو الأخرى، نجدها في هذا الكتاب المُتاح على نطاق واسع، إذ إن أقل ما يُقدِّمه الكتاب هو تغيرٌ نموذجي في الطريقة التي نُفكر بها في كل شيء؛ بدايةً من الكيفية التي يؤثر بها التحيز على حياتنا، وانتهاءً بكيفية استخدام القوانين والممارسات المؤسسية لتقليل آثاره السلبية. ويقوم الكتاب بجميع هذا بطريقة موجزة أتمنى أن تكفل له أكثر ما يستحق: أن يُقرأ على نطاق واسع.
كلود م. ستيل، عالم نفس أمريكي وأستاذ فخري في جامعة ستانفورد
يُقدِّم ‘هل نولد عنصريين؟’ أحدث العلوم بطريقة غاية في السهولة، ويتصدى بشكل مباشر لقضايا من المُعتاد تجنبها، ويقدم في الوقت نفسه نصائح عملية وآمالاً كبرى. كذلك تُمهد الدلائل ووجهات النظر، التي يُقدمها هذا الكتاب الثمين، الطريق لمزيد من التناول الصادق والمتكرر لمسألة العِرق.
باربرا فريدريكسون، أستاذة علم النفس جامعة ولاية كارولينا الشمالية
في هذا التحليل الدقيق، متعدد التخصصات، يبحث علماء وروائيُّون ورجال دين في جذور التحيز العنصري والعلاج المُحتمل… لمحة عن البحوث المعاصرة التي تتناول إنهاء العنصرية والنضال القائم من أجل ذلك.
Publishers Weekly
تصدير: هل العنصرية داخل أدمغتنا أم خارجها؟
بقلم الدكتور: نادر كاظم
“البربري هو من يؤمن بوجود البربرية”
كلود ليفي شتراوس
قبل بضع سنوات، شاركت في ندوة في البحرين عن «معوِّقات التعايش». بعد انتهاء مداخلاتنا كمنتدين جاءت فقرة أسئلة الجمهور ومداخلاتهم، ووصل الدور إلى شابَّة بحرينية يافعة طرحت مداخلة مؤداها: إن التعايش مستحيل لأن البشر عنصريون بطبعهم، وأنا قرأت في كتاب بعنوان: «Are We Born Racist?» أن البشر يولدون عنصريين! كان الوقت المتاح للتعليق على أسئلة الجمهور ضيقاً، فبقيت هذه المداخلة بلا ردٍّ، لكنها بقيت تتردَّد في ذهني بعد ذلك لأني كنت وقتها قد قرأت هذا الكتاب، وأعرف جيِّداً أن الكتاب لا يدافع عن ذلك إطلاقاً، بل على الضدِّ، هو يدافع عن التسامح والتعايش وتقبُّل الآخر، وأن أدمغة البشر مرنة على نحوٍ يسمح بتغيير الآراء والأفكار والصور النمطية والتوجُّهات المتجذِّرة فينا على مدى سنوات طويلة من التشكيل والقولبة والتنشئة الاجتماعية. كانت مداخلة الشابَّة قد أجابت على السؤال الذي يطرحه عنوان هذا الكتاب بـ «نعم»، هكذا بكل بساطة، في حين أن المسألة أكثر تعقيداً من ذلك.
أذكر، كذلك، أن أكثر سؤال كان يطرح عليَّ بتكرارٍ بعد نشر كتابي «تمثيلات الآخر: صور السود في المتخيَّل العربي الوسيط» في العام 2004، هو هذا: «إذا كان الغرب عنصريًّا تجاه السود، والعرب عنصريين تجاه السود، ومعظم شعوب الأرض عنصريين تجاه السود، ألا يعني هذا أن هذه هي طبيعة السود؟» ينطوي هذا السؤال على المعنى ذاته في مداخلة الشابَّة البحرينية، وهو أن العنصرية تجاه السود عنصرية طبيعية، ولكن بدل أن يكون المتهم في هذه العنصرية أدمغتنا البشرية (كما في مداخلة الشابة)، صارت طبيعة السود هي المتَّهَمة هذه المرة، أي إن السود أقلُّ ذكاءً من البيض، وهم أقرب إلى «الحيوانية» من كل شعوب الأرض الأخرى، وهذا يعني أن عنصريتنا تجاههم عنصرية مبرَّرة، أي إننا لا نفتري عليهم حين نصفهم – ونتعامل معهم على هذا الأساس- على أنهم أدنى منا في كل شيء إيجابي. وهذا ضرب من التنميط ينسحب حتى على النساء وعلى كثير من الأقليات، إذ يمكن لهؤلاء أن يجادلوا، خطأً، بأنه إذا كانت النساء خاضعات للرجال في معظم المجتمعات البشرية، ألا يعني هذا أن الذكورية الأبوية، وما تجرُّه وراءها من أفكارٍ حول تفوُّق الرجل وسيادته ودونية المرأة وخضوعها، مسألة طبيعية؟ والحقيقة أن هؤلاء لا ينتبهون إلى أن المجتمعات التي كوَّنت صورًا نمطية سلبية تجاه السود هي ذاتها المجتمعات التي كانت ذات نزعة إمبريالية توسُّعية (فتح وغزو واستعمار واحتلال…)، وهي ذاتها المجتمعات التي عرفت مؤسسات العبودية سيئة السمعة.
تشترك هاتان المقاربتان في شيء واحد، وهو أن العنصرية مبرَّرة، سواء بحكم طبيعة السود أو بحكم التصميم الداخلي لأدمغتنا. إلا أن هذه عنصرية مُذنِبة في حقيقة الأمر، أي عنصرية تشعر بالذنب وتأنيب الضمير؛ لأن العنصريَّ الحقيقي لن يشغل باله بتبرير عنصريته أصلًا، أما العنصريُّ الذي يبحث عن تبرير عنصريته فهو يبحث عن راحة البال من تأنيب الضمير الذي تسبِّبه العنصرية بما أنها ضرب من ضروب نزع الإنسانية عن فئة ما من البشر. بيد أنه في الحالتين سيكون المضي قدمًا من أجل نزع الحجاب عن أعين العنصريين، الحقيقيين والمذنبين، ليروا عنصريتهم هذه المرة على حقيقتها، لا طبيعة السود أو غيرهم، ولا التصميم الداخلي لأدمغتنا «العنصرية».
إن العنصرية تجاه الأقليات من أي لون أو دين كانت مسألة اعتيادية جدًّا في مجتمعات توسُّعية وتتاجر بالعبيد من أي لون ودين كانوا. إن المجتمعات التي استعبدت الشعوب السلافية الصهباء ما زالت إلى اليوم تسمي العبد باسمٍ مشتقٍّ من اسم هذه الشعوب: «السلافي» «slave»، تمامًا كبعض الشعوب العربية التي ما زالت إلى اليوم تسمي «الأسود» «عبدًا». إلا أن هذه المجتمعات لا تمثِّل البشرية بأكلمها، بل إنها لا تمثِّل حتى نصف سكان البشرية حتى نقول إن البشرية كلها تحمل نظرة دونية تجاه هذا الشعب أو ذاك. ومن يقول بذلك يستثني عمدًا كامل شعوب القارة الإفريقية، وسكان الصين والهند وأغلب شعوب آسيا، وشعوب أمريكا اللاتينية، وسكان أستراليا الأصليين… إلخ. ومع هذا، فإن الهدف الأساسي، في هذا النوع من الأطاريح، هو تبرير العنصرية، وإضفاء قدر من المشروعية على هذه الممارسة والنظرة اللاإنسانية. وعادة ما تسير حجة هذا التبرير المتهالك كالتالي: إذا كانت معظم الحضارات الإنسانية الكبيرة تمتلك نظرة عنصرية تجاه السود، ألا يعني هذا أن العنصرية مسألة طبيعية؟ الجواب بالنفي بكل بساطة، لا لأن الحجة برمتها مؤسَّسة على جملة مغالطات؛ بل لأنه ليس معظم الحضارات عنصرية تجاه السود أولًا، ولأن وجهة نظر السود تجاه الآخرين ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار ثانيًا، أقول إن الجواب بالنفي لا لهذا السبب أو ذاك، بل لأن أحدًا لا يملك حتى الآن الحق في أن يقول لنا إنَّ هذه النظرة طبيعية وذاك المنظور غير طبيعي.
وهذا إشكال كلاسيكي في الفلسفة والأخلاق والأنثروبولوجيا، وهو إشكال لا بد من حسمه لأنه يأتي في سياق الرغبة في الوصول إلى تعميمات عن ما يُسمَّى «الطبيعة البشرية». وقبل أن يدخل علم الأعصاب على الخطِّ، كان فلاسفة، وفلاسفة سياسيون وأخلاقيون وأنثروبولوجيون كثيرون قد أدلوا بدلوهم في هذا المسألة. تساءل هؤلاء مطوَّلًا: هل يولد الإنسان وعقله صفحة بيضاء؟ هل يولد الإنسان وفي دماغه أفكار أوَّلية وفطرية، وأنه لا يحتاج إلى تعلُّمها واكتسابها من مجتمعه ولا بالتجربة؟ هل نعرف أن (1+1=2) بالفطرة؟ هل الأخلاق والتمييز بين الخير والشرِّ مسألة فطرية؟ هل هناك دين فطري؟ هل هناك ممارسات بشرية طبيعية لا تحتاج إلى تعلُّم واكتساب؟ هل الزواج التعددي طبيعي عند البشر؟ هناك كمٌّ هائل من الإجابات على هذه الأسئلة طوال التاريخ الفلسفي والأخلاقي والأنثروبولوجي، إلا أن أحدًا لم يكن يمتلك الدليل الحاسم الذي ينهي هذا الجدل الطويل بين من يقول: «نعم»، ومن يقول: «لا». وبدا أن البيولوجيا وعلم الأعصاب يمكن أن يقدِّما لنا مِثل هذا الدليل، فإذا ثبت أن ثمة مناطق في أدمغتنا أو جينات ما مسؤولة عن هذا التصرُّف أو تلك الطريقة في التفكير، أليس معنى هذا أننا مصمَّمون ومبرمجون على ذلك؟
كان الشغل الشاغل لأنثروبولوجيي أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين هو ما يسمى «الكليات البشرية»، أي المعتقدات والتصرُّفات والعادات التي توجد لدى كل البشر. ولمعرفة هذه «الكليات البشرية»، سيكون علينا أن نكتشف الحدَّ الفاصل بين الطبيعة والثقافة، أو بين ما ينتمي إلى طبيعتنا البشرية وبرمجتنا البيولوجية، وبين ما ينتمي إلى ثقافتنا التي اخترعناها كنوعٍ من الأنواع الحيَّة يمتاز بالذكاء والتطوُّر. وبتعبيرٍ آخر، كيف يمكن التمييز بين التصرُّف الطبيعي والتصرُّف المكتسب والمبنىِّ أو المُكيَّف اجتماعيًّا؟ بالنسبة إلى برينسلاو مالينوفسكي -أحد أبرز الأنثروبولوجيين الوظيفيين في تاريخ الأنثروبولوجيا البريطانية خلال النصف الأول من القرن العشرين- فإن الإنسان يختلف عن الحيوان في حالته الطبيعية بشيء اسمه «الثقافة» أي إنه يمتاز عن الحيوان لكونه «يمتلك مجموعة من الأدوات والأسلحة والمعدِّات المنزلية، ويعيش في وسط اجتماعي، ويتواصل مع الآخرين باللغة، ولديه القدرة على صياغة مفاهيم عقلية ودينية». ويسمي مالينوفسكي كل هذا باسم «المجموعات الثقافية الأربع الكبرى» أو «المقولات الثقافية الرئيسية»، وهي تشمل: المخترعات المادية، واللغة، والنظام الاجتماعي، ومنظومة المفاهيم العقلية والقيم الروحية. وتعتبر هذه المجموعات الأربع الكبرى (أو الثقافة بتعبير آخر) هي الحدَّ الفاصل بين الإنسان والحيوان، وبين الثقافة والطبيعة بحسب مالينوفسكي؛ لأن كل الحيوانات تفتقر إلى هذه المقولات، وكل شعوب العالم تمتلكها بدرجة أو بأخرى.
ونحن ندين إلى الأنثروبولوجي الفرنسي الكبير كلود ليفي شتراوس بأفضل صياغة قدِّمت عن هذا الحدِّ الفاصل. فبالنسبة إلى شتراوس فإن الحدَّ الفاصل بين ما هو طبيعي (فطري) وما هو ثقافي (مكتسب) ينبغي أن يكون كونيًّا، أي شاملًا بحيث ينسحب على كل أفراد النوع البشري، وفي المقابل، فإن «كل ما هو خاضع لقاعدة ما ينتمي إلى الثقافة، ويمثِّل ما هو نسبي وخصوصي»، ولهذا فهو يتنوَّع من مجتمع إلى آخر. كان شتراوس يعتقد أن «تحريم سِفاح المحارِم» يمثِّل النقطة التي تلتقي عندها الطبيعة بالثقافة، فالتحريم قاعدة (أي إنها صياغة بشرية)، ولكنها قاعدة كونية موجودة، كما كان شتراوس يعتقد – في أيِّ تجمُّع بشري. ثم كرَّس شتراوس اهتمامه، فيما بعد، على اللغة؛ على أساس أن اللغة هي الحدُّ الفاصل بين الطبيعة والثقافة. إن اللغة مكتسبة عند البشر (بدليل أنك إذا تركت رضيعًا خارج المجتمع البشري، لنقل إنه تُرك في غابة مع الحيوانات، فإنه لن يتعلَّم أيًّا من اللغات البشرية)، ومع هذا فإن كل البشر يمتلكون لغة خاصة بهم مهما كانت سماتها ودرجة تعقيدها. يختلف الأمر مع اللباس -على سبيل المثال- فاللباس لا يصلح لأن يكون حدًّا فاصلًا من هذا النوع؛ لأن بعض الشعوب البشرية -كانت تسمى «بدائية» في يوم ما- كانت عارية ولم تخترع شيئًا اسمه «اللباس». وبالنسبة إلى شتراوس، فإن الأدوات أيضًا لا تصلح لأن تكون حدًّا فاصلًا لأن بعض الحيوانات قادرة على صنع أدوات أوَّليَّة وبسيطة.
ويبدو أن بعض الشكوك أخذت تراود شتراوس عند هذه النقطة، فإذا كانت بعض الحيوانات مثل الشِّمبانزي تمتلك القدرة على صنع أدوات بسيطة (مثل تركيب غصنين من شجرة معًا للوصول إلى موزة في مكان مرتفع)، فإن كل الحيوانات تمتلك نظام تواصل بسيط خاصًّا بها، أي لغة خاصة بها. الأمر الذي يعني أن اللغة بما هي نظام تواصل ليست هي الحدَّ الفاصل مهما كانت درجة تعقيد لغتنا البشرية قياسًا بلغة الحيوانات الأوَّلية والبسيطة (المشفَّرة بالرائحة أو اللون أو بالتصويت أو غيرها). اعترف شتراوس، في النهاية، بأن هذا الحدَّ الذي يمثِّل اللحظة الفاصلة لانبثاق الثقافة البشرية سيظل «لغزًا بالنسبة إلى الإنسان»، وهو لغز من اختراع الإنسان نفسه، إلا أن حلَّ هذا اللغز يكمن في «تحديد المستوى البيولوجي الذي حدثت فيه تحولات في بنية ووظيفة الدماغ»، بمعنى أن الثقافة هي نتاج تغيُّرات بيولوجية وفسيولوجية وتشريحية حدثت في أدمغتنا، وأن حلَّ هذا اللغز مرهون بتقدُّم البيولوجيا التطورية لأدمغتنا البشرية، أو علم الأعصاب كما يسمَّى اليوم.
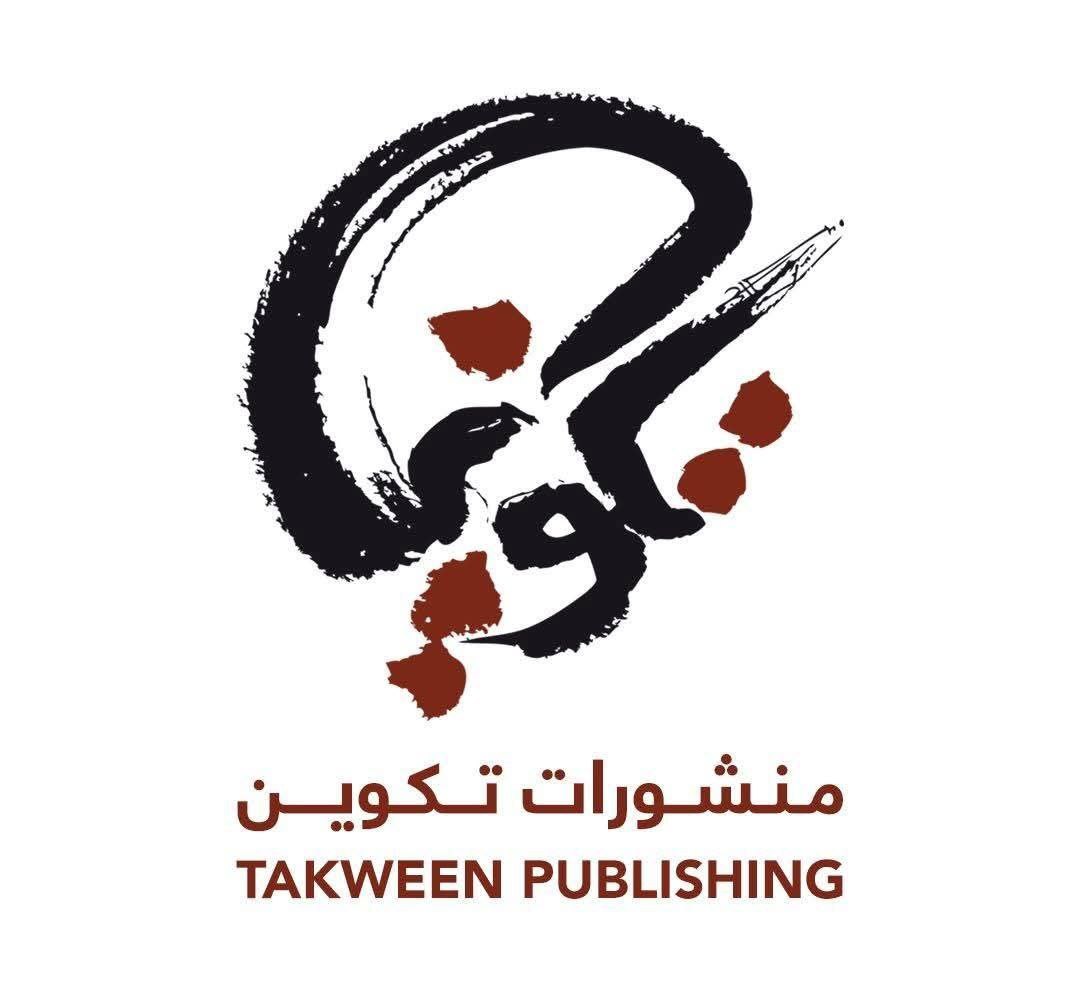
دار نشر تأسست عام 2017، مقرها الكويت والعراق، متخصصة في نشر الكتب الأدبية والفكرية تأليفاً وترجمة.
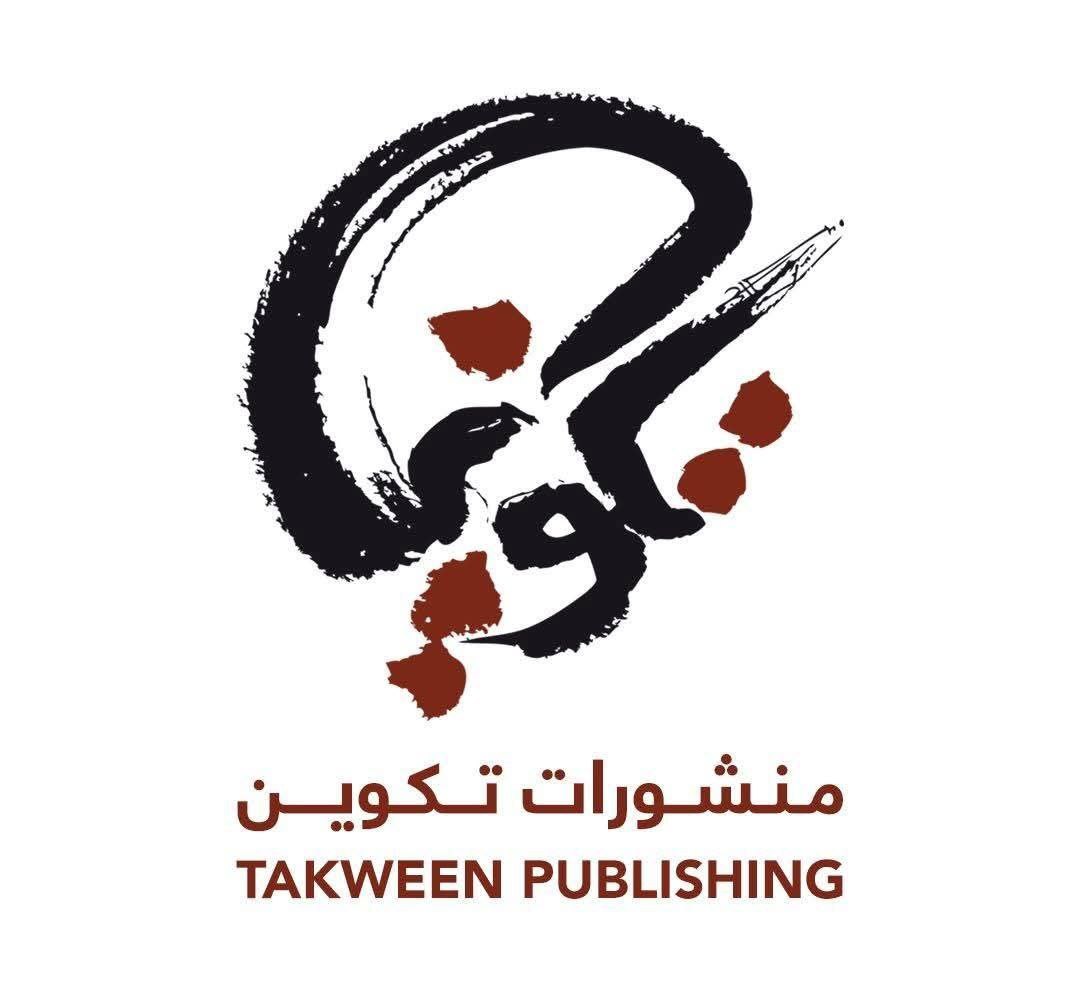
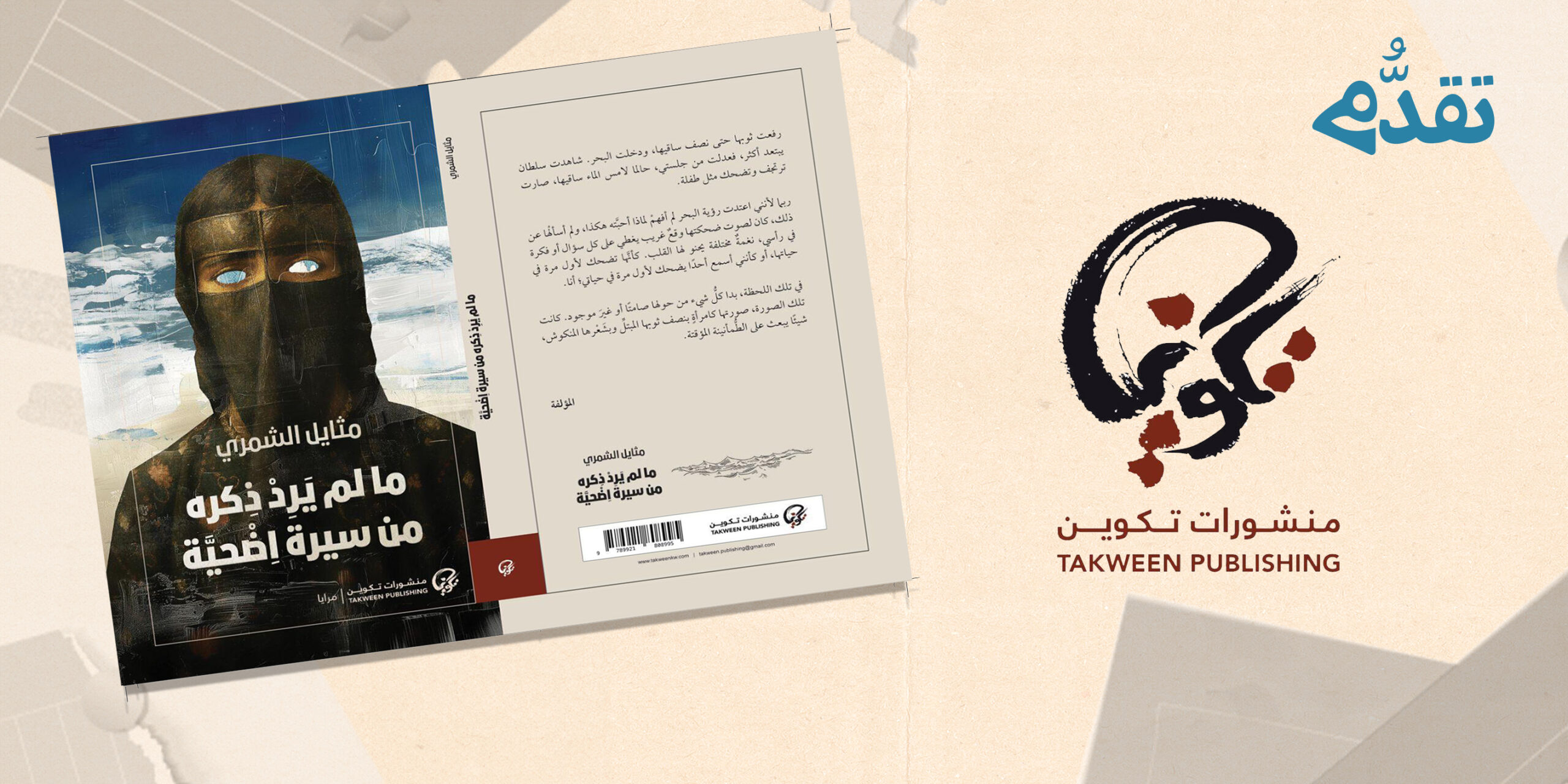
صدر عن منشورات تكوين رواية ” ما لم يَرِدْ ذِكره من سيرة اِضْحيَّة” لـ مثايل الشمري. “الحقيقة ليست مقيَّدة بأن تُوجِد الأشياء أو تحدث، وإنَّما
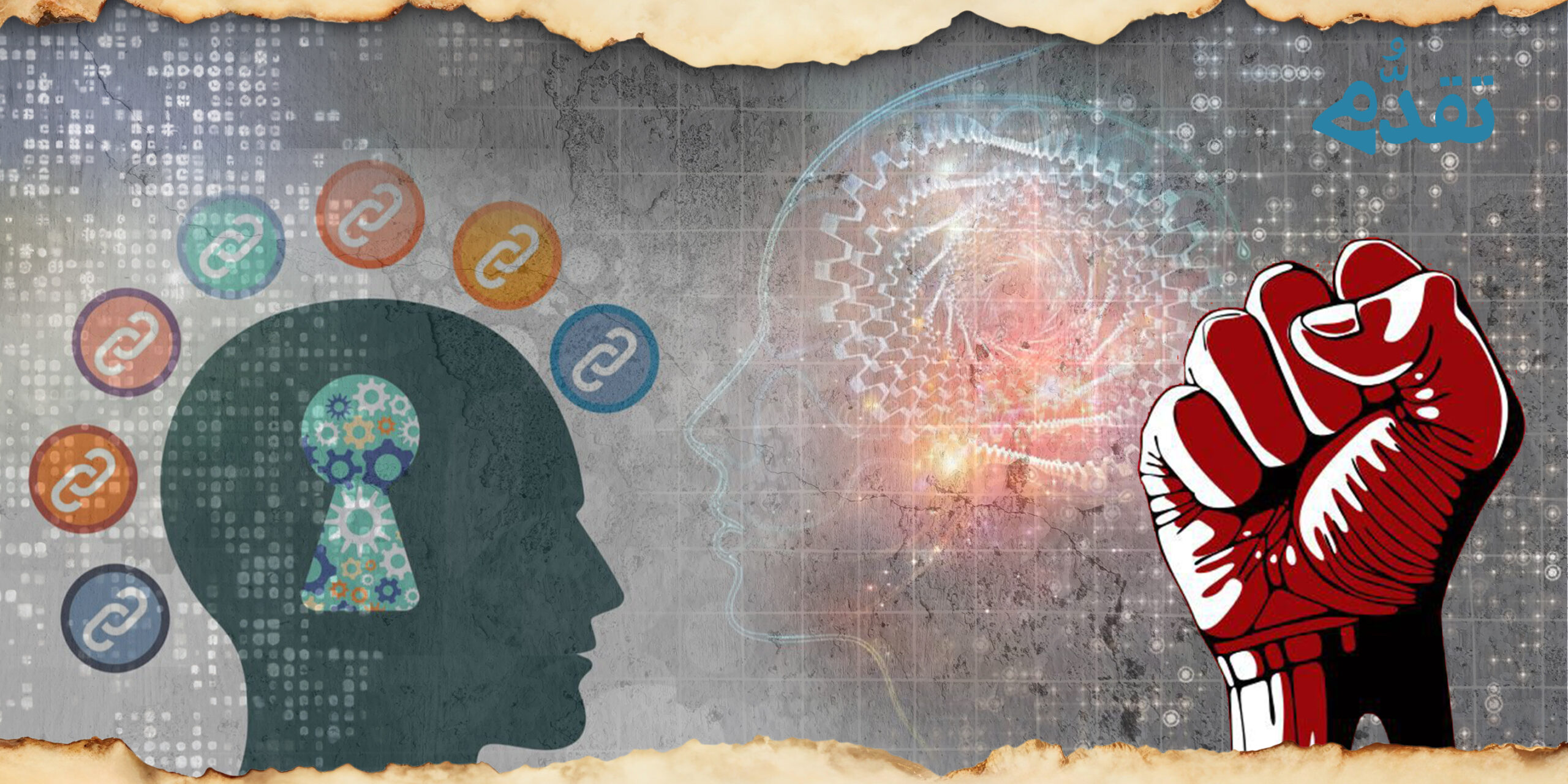
حصر الوضعية المنطقية مهمة الفلسفة بالتحليل المنطقي للغة يعني أتها تئد الفلسفة، والعلم ،والإبداع، تقيد الفلسفة بمجال واحد تصادر فيه باقي مفاهيم الفلسفة ومهمتها المناقضة لها، وتمنع حرية اختيار مفاهيم أخرى لها.

في رواية “مِخْيال معيوف” يبدأ السرد من ولادة معيوف في صحراء الشعيب غرب الكويت، حيث يقضي الأشهر الستّة الأولى من حياته عليلًا قبل نقله إلى

اللغة هي الحاضنة الأولى للهوية، والوعاء الذي تنعكس فيه الحضارة، وأداة الشعوب في صياغة وعيها ومكانتها بين الأمم. وفي زمن العولمة المتسارعة، تتعرض اللغة العربية