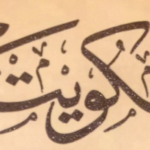جريمة دفن الآثار.. محو ذاكرة بيروت
تدمير وطمس آثار بيروت ومحو ذاكرة شعبها وتهجيره وتحويل هذه القلعة الأثرية إلى شركة خاصة تعتبر جريمة العصر. هذا ما يسميه باحثو التراث والآثار بـ “الهندسة السياسية للذاكرة”.

في الحروب الإمبريالية، لا تقتصر الصدمة على العنف المادي المتمثل في التدمير والتهجير والقتل والتشريد وإعادة رسم الخرائط الجيوسياسية، بل تمتد لتشمل إعادة تشكيل الإدراك والوعي الجماعي للشعوب المستعمَرة والمقهورة. ويتم ذلك عبر استهداف بنية – النظام الرمزي، الذي لا يقتصر على المعايير الثقافية والقيم الاجتماعية، بل يشمل البنية المعرفية والعقائدية والأيديولوجية، وما يُعَدّ مقبولاً ومشروعاً وحقيقياً في نظر المجتمع. أي أنه يشكّل التصورات المعرفية والنفسية للفرد والجماعة حول مفاهيم مثل الحرية، التحرر، الوجود، التبعية والعبودية.
هذا النظام لا يكتفي بإعادة إنتاج المعاني والسلوكيات الإنسانية القائمة، بل يبتكر معان جديدة ومتجددة لمنظومة الأفعال السياسية والاجتماعية، عبر نزعها من سياقها الإنساني والتاريخي والدفع بالتشكيك في مشروعيتها. ويتم تفعيله من خلال آليات الطاعة الرمزية المبنية على علاقات القوة والسيطرة والنفوذ. ومن هذا المنظور، تستطيع الطبقات السياسية والاجتماعية المهيمنة، المرتبطة بمصالح القوى الإمبريالية، التسلل ببطء لإعادة تشكيل الوعي الجمعي وفق أجنداتها، عبر فرض سرديات جديدة قائمة على التخويف والتهديد الوجودي.
بحسب فرانز فانون، يسعى الاستعمار إلى تفريغ المستعمَرين من رموزهم وتاريخهم النضالي وفرض رموز بديلة تُعيد إنتاج التبعية. وفي السياق ذاته يشير أنطونيو غرامشي إلى أن الطبقات المهيمنة تحافظ على سلطتها عبر ما يسميه «الهيمنة الثقافية»، أي فرض منظومات رمزية تُقنع المقهورين بقبول أوضاعهم المزرية باعتبارها نتيجة طبيعية للحروب والدمار. وهكذا تتحول الصدمة من تجربة تاريخية وصحوة جماهيرية للدفاع عن الكرامة والحرية إلى أداة لإعادة الهيمنة؛ إذ تُرسم خرائط ذهنية متخيَّلة للأحداث، وتُستَنسخ نخب تعمل تحت سيطرة بنوك التفكير الاستراتيجي الإمبريالي، وتُنشأ مؤسسات رمزية بديلة عن المؤسسات الأصيلة، ويُستخدم الإعلام المأجور لتضخيم معانٍ زائفة تُشرعن الألم والقهر والموت والدمار وتُطبّع التبعية. ومن هنا يصبح توظيف السرديات إحدى أخطر أدوات الإمبريالية لتثبيت سيطرتها، وهو ما يستدعي وعياً نقدياً يعيد للصدمة معناها الحقيقي كشرارة مقاومة ونضال، لا كوسيلة شلل واستسلام.
بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، لم يقتصر الدمار على تفكيك الدولة سياسياً وعسكرياً، بل امتد إلى تمزيق النسيج الرمزي للمجتمع. فقد حطمت القوات الأميركية الغازية المؤسسات الثقافية، ونهبت الأرشيف الوطني، ومزّقت الذاكرة الجمعية تحت شعارات «التحرير» و«الديمقراطية». بذلك أُضعفت قدرة العراقيين على الفعل السياسي والنضالي المستقل وفككته بالكامل، وصار المجتمع فريسة سهلة لتلقي «كتلة رمزية جديدة» يُعيد إنتاجها المحتل. هنا تتجلى الأزمة العضوية التي وصفها غرامشي، حيث يصبح المجتمع عاجزاً عن تمثيل نفسه والدفاع عنها، ويقبل بكل هدوء سردية المستعمر باعتبارها الحقيقة الوحيدة الممكنة والقابلة للحياة. لكن ماذا جرى بالعراق؟، لقد طُويت الخبرات والمعارف والحضارة والعلم والنضالات التاريخية تحت عنوان «الديكتاتورية مقابل الديمقراطية» كدعاية مضادة لإعادة صياغة النظام الرمزي، وبهذا غدا العراق مثالاً حياً على كيفية تحويل الصدمة الجماعية للحرب إلى أداة هيمنة سياسية وثقافية، وكيف يمكن لإعادة هندسة الرموز والقيم أن تُستخدم لصناعة خضوع طويل الأمد.
وفي الحالة السورية بعد عام 2011، أُنشئت فصائل مسلحة متنوعة بدعوى التخلص من النموذج الأسدي الحاكم بدعم خارجي لتصبح فيما بعد أدوات ضمن النظام الرمزي للإمبريالية، تعمل على تفكيك المجتمع وإعادة تشكيل وعيه الجمعي بما يخدم مصالح القوى الخارجية. حتى أشكال المقاومة المحلية البسيطة التي خرجت هنا وهناك وُضعت تحت ضغوط رمزية وسياسية جعلت كل فاعل جزءاً من صراع رمزي أوسع. هنا تعمل الصدمة والاملاءات الرمزية جنباً إلى جنب مع العدوان المادي لإعادة إنتاج الهيمنة وخلق سرديات تحجب الفاعل الحقيقي للصراع، وتشرعن التبعية عبر رموز جديدة.
لكل فعل” رد فعل”، والحدث هو فعل من حيث حركته زمانياً ومكانياً، كما في الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987. فقد شكّلت الانتفاضة لحظة تأسيسية جديدة أعادت تعريف الفلسطينيين لا كضحايا سلبيين للاستعمار الطويل منذ 1948، بل كجماعة تاريخية فاعلة تمتلك القدرة على المبادرة والمقاومة. بهذا المعنى مثلت الانتفاضة صدمة مضادة للنظام الإمبريالي الاستعماري، لأنها كسرت صورة الفلسطيني «العاجز». أو بمعنى أدق المُعجز قسراً عربياً ودولياً، وأعادت للنضال الشعبي معناه التحرري المباشر بوصفه فعلاً جماهيرياً منظماً قادراً على زعزعة منظومة الهيمنة. غير أن القوى الإمبريالية والصهيونية وحلفاءها من الرجعية العربية والفلسطينية، سارعت إلى احتواء هذا الأفق عبر إعادة هندسة معناه؛ فبدل أن يُترجم الحدث إلى مشروع تحرر وطني شامل، جرى تدريجياً نقله إلى مسار «أوسلو»، حيث تحوّل الخطاب من «تحرير فلسطين» إلى إدارة سلطة محدودة الصلاحيات. هذه السلطة، المرتبطة بالتمويل الخارجي والتنسيق الأمني، صارت الإطار الجديد لإعادة إنتاج التبعية، وهكذا أُعيد تشكيل النظام الرمزي بحيث يخدم مشروع الهيمنة ويختزل فعل المقاومة في إدارة شكلية بدل أن يحافظ على ذاكرته كمشروع تاريخي للتحرر.
وعندما أعلنت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٣، كانت الرسالة واضحة: «نحن شعب يريد الحرية». بهذا الفعل البسيط سقط قناع الطاعة الرمزية الأوسلوي الذي فُرض طويلاً على الفلسطينيين، لكن سرعان ما جرى احتواء الصدمة الجماهيرية عبر تحويلها إلى سردية «تهديد» و«خطر» وتجريدها من سياقها الاستعماري. انتقلت الأسئلة من «لماذا حدث؟» إلى «ماذا حدث؟»، وعُرضت العملية باعتبارها فعلاً «همجياً» يهدد «النظام العالمي» بدل كونها تعبيراً مشروعاً عن مقاومة الاحتلال. وبهذا الشكل استُخدمت الصدمة كـ «لحظة انهيار للمعنى» في الوعي العالمي بشكل ممنهج، فجرى تفكيك- النظام الرمزي لفظياً وتاريخياً، الذي كان يُتيح رؤية الفلسطينيين كضحايا الاستعمار الطويل وكشعب مظلوم، ليُعاد تشكيل الإدراك الجماعي محلياً وإقليمياً ودولياً، ثم تحولت الحرب ضد غزة إلى ردّ «مبرر» في المخيال العام التحريضي، بدل أن تُفهم كعقاب استعماري إبادي وتهجيري جماعي ضد شعب أعزل يطالب بحريته منذ عقود مضت.
تحويل الصدمة من أداة شلل إلى وقود للنضال
الصدمة ليست قدراً محتوماً؛ بل يمكن استردادها والإبقاء والحفاظ عليها كأداة نضالية وسياسية. يقدم غسان كنفاني نموذجاً عملياً لذلك، إذ تؤطر رواياته — مثل رجال في الشمس وعائد إلى حيفا.— الألم الشخصي والجماعي داخل سياق تاريخي وسياسي واضح، فتُظهر جذور الصدمة في بنى الاستغلال والهيمنة وتمنع عزل الجرح عن تاريخه. بهذا الأسلوب تتحول الذاكرة إلى محفز للفعل لا إلى مادة للفرجة الإنسانية. عملياً، يستدعي استرداد الصدمة ثلاث مكونات ثقافية مترابطة: بناء أرشيف مضاد يحفظ الذاكرة خارج مؤسسات الهيمنة كالمبادرين مدفوعي التوجهات وغيرهم، إنتاج سرديات فنية وثقافية وسياسية تربط الجراح والإبادة والمحو بالبنية الطبقية للإمبريالية، وتفكيك خطاب «الحياد الإنساني»، البكائيات، الذي يفصل الألم الفلسطيني الخاص عن سياقه الاستعماري السياسي.
إن تحويل الصدمة من أداة شلل إلى وقود للنضال يعني استعادة القدرة على تفسير الجراح بوصفها دلائل على بنية استغلال عالمي. حينها تصبح الصدمة بذرة مقاومة جديدة، تنبثق من داخل الألم لتقلب معادلة الهيمنة وتعيد ربط الذاكرة بالمستقبل بدل دفنها في مقبرة النسيان الإمبريالي. إن استرداد الصدمة مشروع جماعي يربط الماضي بالحاضر والمستقبل ويحوّل الألم الجماعي إلى قوة سياسية واجتماعية، وفي سياق فلسطين تعني هذه العملية إعادة توجيه السرديات وتصحيح النظام الرمزي الذي حاولت الإمبريالية والصهيونية فرضه، وبذلك تصبح الصدمة أداة لفهم الجذر الحقيقي للصراع وتقطع الطريق على كل المحاولات التي تسعى إلى تحويل الشعب الفلسطيني إلى مشارك في إعادة إنتاج تبعيته من جديد عبر حلول سياسية مقزِّمة تتنكر لحقوقه التاريخية. هذا الاسترداد يتطلب تجاوز التفسير السطحي للحروب بوصفها مجرد مآسٍ إنسانية، والتركيز بدلاً من ذلك على البنية الرمزية التي تتحكم في التصورات الجماعية، لأن إدراك الصدمة بهذا العمق يتيح بناء مقاومة مستمرة تقوم على وعي بأن الألم ليس نهاية، بل بداية لفعل تحرري مستمر يحتاج للصمود.



تدمير وطمس آثار بيروت ومحو ذاكرة شعبها وتهجيره وتحويل هذه القلعة الأثرية إلى شركة خاصة تعتبر جريمة العصر. هذا ما يسميه باحثو التراث والآثار بـ “الهندسة السياسية للذاكرة”.

لم يعد النضال الفلسطيني اليوم محصوراً في الجغرافيا، ولا مقيداً بحدود المكان أو أدوات المواجهة التقليدية. لقد أفرزت التحولات الرقمية جيلاً جديداً من الفاعلين السياسيين،

القوة الاقتصادية والسياسية المتنامية لدول الجنوب العالمي تجعل الفضاء الإعلامي العالمي متعدد الأوجه بشكل متزايد. لقد ولّى عهد الدول الغربية التي كانت قادرة على تضليل الرأي العام العالمي دون عقاب

مواجهة محاولات القوى الأجنبية لإضعاف الهوية الوطنية تتطلب تكامل جميع الأدوات الوطنية، بدءاً من التوعية والتعليم، مروراً بالحفاظ على الثقافة والاستقلال الاقتصادي، وصولاً إلى صيانة القرار السياسي