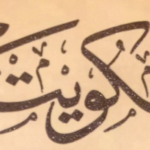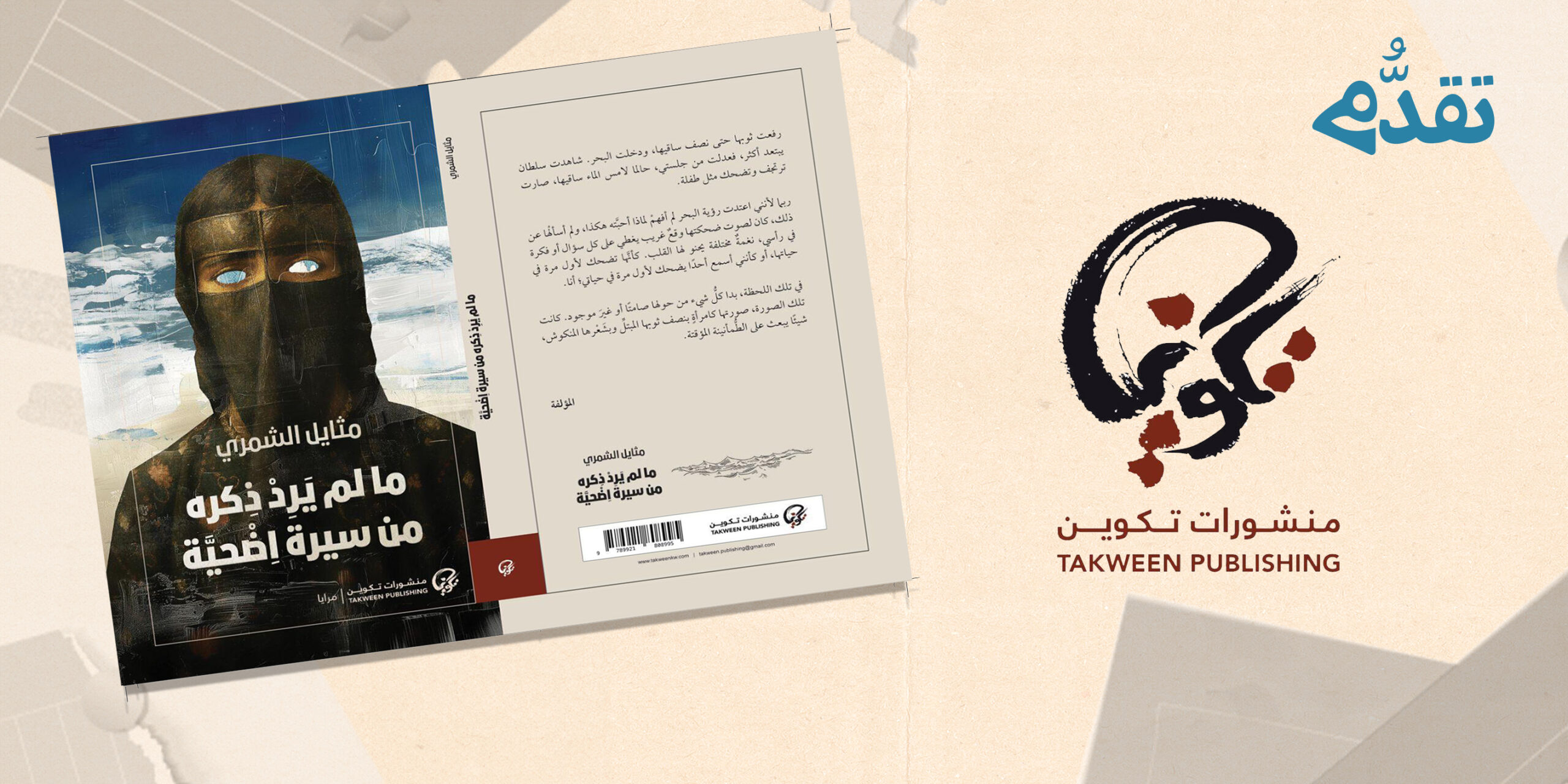
“ما لم يَرِدْ ذِكره من سيرة اِضْحيَّة”
صدر عن منشورات تكوين رواية ” ما لم يَرِدْ ذِكره من سيرة اِضْحيَّة” لـ مثايل الشمري. “الحقيقة ليست مقيَّدة بأن تُوجِد الأشياء أو تحدث، وإنَّما
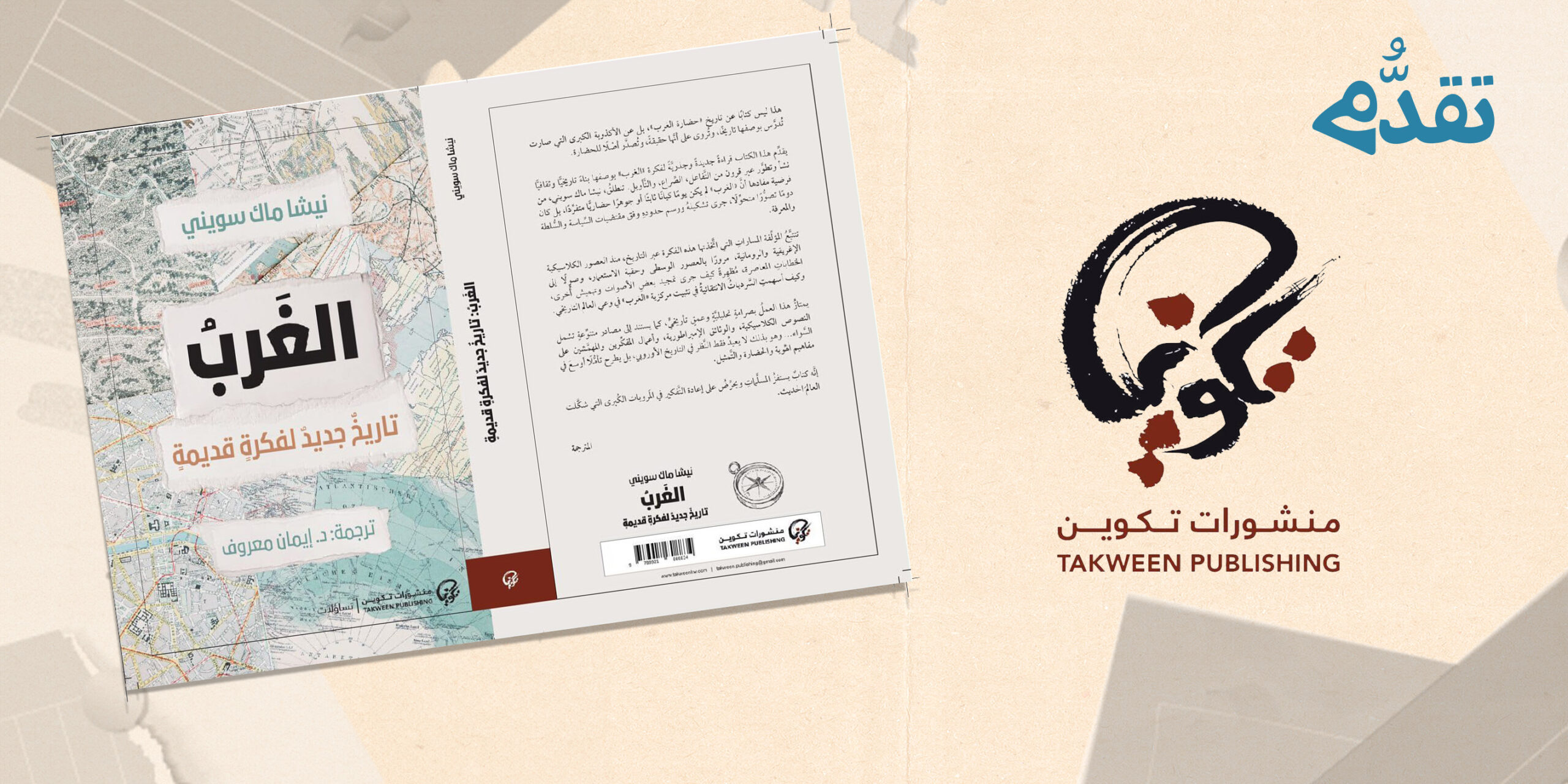
صدر عن منشورات تكوين كتاب “الـغَـربُ تاريخٌ جديدٌ لفكرةٍ قديمةٍ”، تأليف نيشا ماك سويني، ترجمة د. إيمان معروف.
كلمة المؤلفة
يتناول هذا الكتاب موضوعاتٍ تمتدُّ عبر حقبٍ مختلفة من التاريخ البشري، وتشمل الكثير من الثقافات والمجتمعات المتنوعة. لذا اعتمدتُ، أثناء عملية الكتابة، اعتماداً كبيراً على المصادر الثانوية في البحث. كما بذلتُ قصارى جهدي لاستشارة المختصين في المجالات الإقليمية والفترات التاريخية ذات الصلة، لا سيما عند التطرق إلى موضوعات تتجاوز نطاق خبرتي الشخصية. مع ذلك، من غير المرجح أن تكون جميع أجزاء هذا الكتاب دقيقة أو مفصلة أو متعمقة بالدرجة التي قد تكون عليها لو كتبها متخصصون في كل مجال على حدة. لذا، أتوقع أن يحتوي على بعض الأخطاء في الحقائق أو التفسيرات. مع ذلك، أؤمن بقيمة الأعمال التي تسعى إلى تقديم نظرة عامة تركيبية واسعة لموضوع معين. فعند توسيع نطاق رؤية الصورة الكبرى، لا مفرَّ من فقدان بعض التفاصيل والدِّقة في بعض المواضع، ولكن هناك أوقات يكون فيها التركيز على الصورة الأشمل أمراً ذا أهمية كبيرة.
المقدمة: أهميَّةُ الأصول
للأصول أهميَّة كبيرة. إذْ عندما نطرح السّؤال: «من أين أتيت؟»، فإنَّنا -في الحقيقة- غالباً ما نقصدُ السُّؤال: «مَن أنت؟». ينطبق هذا على الأفراد والعائلات والدُّول بأسْرها. كما ينطبقُ، أيضاً، على كيانٍ واسع ومعقد مثل «الغرب».
يكمنُ هذا الترابط بين الأصول والهُوية في صميم الصراعات الثقافية التي تهز الغرب في الوقت الحالي. إذ شهد العقد الماضي استقطاباً حاداً في الخطاب السياسي، وإسقاطَ تماثيل تحمل رمزيةً، وتقويضَ انتخابات من قبل رؤساء دول ما زالوا في السلطة. إنَّ أزمة الهوية، داخل الغرب، هي في جوهرها استجابة لأنماط عالمية أوسع نطاقاً. فالعالم يتغير، وأُسس الهيمنة الغربية تتزعزع. ولدينا، في هذا المنعطف التاريخي، فرصة لإعادة التفكير في «الغرب» على نحوٍ جذري وإعادة تشكيل نظرتنا إليه من جديد من أجل مستقبل أفضل. لكن لا يمكننا القيام بذلك إلَّا إذا كنا مستعدين لمواجهة ماضيه. والإجابة على سؤال «من أين أتى الغرب؟»، هي المفتاح للإجابة على سؤال «ما الذي يمكن أن يكون عليه الغرب؟»، أو «ما الذي ينبغي أن يكون عليه الغرب؟».
يشيرُ مصطلحُ «الغَرب The West» إلى تحالفٍ جيوسياسيٍّ أو مجتمع ثقافي، ويُستخدم عادةً للإشارة إلى مجموعة من الدُّول القومية الحديثة التي تتشارك في السِّمات الثقافية والمبادئ السِّياسية والاقتصادية. من بين هذه المبادئ مُثُلُ الديمقراطية التمثيلية ورأسمالية السُّوق، وعلمانية الدولة اسميًّا؛ كونها تستند إلى خلفية أخلاقية يهودية – مسيحية، ونزعة نفسية نحو الفردية. (1)
لا شيء من هذه المُثُل يقتصر حصرياً على الغرب، ولا هي سائدة فيه كليًّا، ومع ذلك، فإنَّ تكرار اجتماع معظم هذه الخصائص معاً يُعدُّ سِمةً مميزةً له. يمكن قول الشّيء نفسه عن الكثير من الرُّموز النمطية المرتبطة بـ«التغريب Westernization»، مثل الشَّمبانيا والكوكاكولا، ودور الأوبرا والمجمَّعات التجارية. لكن من السِّمات المحددة للغرب على وجه الخصوص مفهوم الأصل المشترك الذي يقودُ إلى الإحساس بتاريخ مشترك، وإرث مشترك، وهُوية مشتركة.
تتخيل أسطورةُ أصل الغرب التاريخَ الغربي على أنه سردٌ متصلٌ بلا انقطاع، يمتدُّ عبر الحداثة الأطلسية والتنوير الأوروبي، ويعود عبر إشراق عصر النهضة وظلام العصور الوسطى، ليصلَ في النهاية إلى جذوره في العوالم الكلاسيكية لروما واليونان. أصبحت هذه الرؤية هي النسخة القياسية من التاريخ الغربي، كلاسيكية ومتداولة، لكنها خاطئة. واقعيًّا، هي نسخة غير دقيقة من التاريخ الغربي، بل وموجَّهة أيديولوجيًّا، إذْ تطرح سرداً شاملاً يصوِّر التاريخ الغربي خيطاً متَّصلاً ومتفرِّداً يمتد من أفلاطون إلى الناتو (2). وعادةً ما يُشار إلى هذه السَّردية المختصرة بمصطلح «حضارة الغرب Western Civilization».
لتجنُّب أيِّ لبسٍ، هذا ليس كتاباً عن صعود الغرب بصفته كياناً ثقافيًّا أو سياسيًّا. إذْ يوجد بالفعل الكثير من الكتب التي تتناول هذا الموضوع، وتقدِّم تفسيراتٍ مختلفة لكيفية وصول الغرب إلى الهيمنة العالمية (3). بدلاً من ذلك، يتتبَّع هذا الكتاب نشوءَ نسخة معينة من تاريخ الغرب، وهي النسخة التي انتشرتْ على نطاق واسع، وتجذَّرتْ بعمق لدرجة أنها تُقبل غالباً دون تمحيص، رغم أنها إشكاليةٌ أخلاقيًّا وخاطئةٌ من واقعيًّا. يفكِّكُ هذا الكتاب، ويتحرَّى، السردية الكبرى المعروفة باسم «حضارة الغرب».
هذه النسخة من التاريخ الغربي -السردية الكبرى للحضارة الغربية- موجودة في كل مكانٍ من حولنا. ما زلت أذكر اللحظة التي أدركتُ فيها تماماً مدى عمق تجذُّرِها. كنت في قاعة القراءة بمكتبة الكونغرس؛ في واشنطن العاصمة.
حين رفعتُ بصري مصادفةً نحو السقف، أدركتُ، بشيءٍ من الانزعاج، أنني مُراقَبةٌ، ليس من قِبل أمناء المكتبة اليقظين دائماً، بل من قِبل ستة عشر تمثالاً برونزياً بالحجم الطبيعي انتصبتْ على الشُّرفة أسفل القبة المطلية بالذهب. ثمَّة تماثيل لموسى، وهوميروس، وسولون، وهيرودوت، وأفلاطون، والقديس بولس من العصور القديمة. ومن العالم الأوروبي القديم، رأيت كولومبوس، ومايكل أنجلو، وبيكون، وشكسبير، ونيوتن، وبيتهوفن، والمؤرخ إدوارد جيبون. أمَّا من العالم الجديد، في أميركا الشمالية، فقد كان هناك القانوني جيمس كينت، والمهندس روبرت فولتون، والعالِم جوزيف هنري. أدركتُ في تلك اللحظة أنَّ تصميم القاعة بالكامل (لا أقصد التماثيل فحسب، بل أيضاً اللوحات الجدارية التي تزين الجدران وحتى ترتيب رفوف الكتب) كان مُعدًّا لغرضٍ واحد: التأكيد على أننا، نحن الجالسين إلى المكاتب، نمثِّل جزءاً من تقليد فكري وثقافي يمتد عبر آلاف السنين. وأسلافنا في هذا التقليد يراقبوننا حرفياً – ربما من باب التشجيع، وربما من باب التقييم- بينما نواصل عملنا (4).
راودتني فكرتان مثيرتان للقلق. الأولى، فكرة غريزية، إذْ شعرتُ أنني لا أنتمي. راودني إحساس بأنَّ شخصاً مثلي (امرأة من عِرق مختلط) لا مكان له في هذا التقليد الذي يُنظرُ إليه عادةً على أنه موروث خاصٌّ بالنخبة من البِيض. لكنني سرعان ما رفضت هذه الفكرة السخيفة، ففي النهاية، كنت في تلك اللحظة تحديداً جالسة في موقع امتياز على مكتب القارئة. لكن بعد ذلك، راودني تساؤل أكثر عمقاً وثِقَلاً: هل تمثل هذه الشخصيات الست عشرة ماضي الغرب بالفعل؟ وهل صوَّرتْ السردية التي تربطُ بعضها ببعضٍ تاريخ الغرب بدقَّةٍ؟
استشرتْ السردية التقليدية للحضارة الغربية، إلى درجة أنها أصبحت أمراً مسلَّماً به، ونادراً ما نتوقف للتفكير فيها، بل والأكثر ندرةً أن نطرحَ تساؤلاتٍ حولها. ورغم أنها تُواجه انتقادات متزايدة (وناجحة)، فإنَّ هذه السردية لا تزال في كلِّ مكان من حولنا. نجدها في الكتب المدرسية ونصوص التاريخ الشعبي التي عند محاولتها شرح تاريخ الغرب، غالباً ما تبدأ «بالإغريق والرومان، ثم تمرُّ عبر العصور الوسطى الأوروبية، وتركز على عصر الاستكشاف والغزو الأوروبيينِ، وأخيراً تُحلِّل التاريخ الحديث»(5). غالباً ما تكون اللُّغة المستخدمة في وصف «حضارة الغرب»، في هذه الأعمال، مليئةً بالاستعارات الجينية، حيث توصف من خلال مفاهيم مثل «الإرث»، و«التطور»، و«النَّسب»(6). نسمع مِراراً أن «حضارة الغرب هي إرث تلقَّيناه من الإغريق القدماء، والرومان، والكنيسة المسيحية، عبر عصر النهضة، والثورة العلمية، والتنوير» (7). هذه الفكرة، التي تصور «حضارة الغرب» على أنها إرثٌ ثقافي متَّصل خطِّيًّا، تُرسَّخ في أذهاننا منذ الطفولة. على سبيلِ المثال، تبدأُ إحدى سلاسل كتب الأطفال المؤثرة مغامراتِها السحريةَ بوصف «حضارة الغرب» أنها «قوة حية… نار» اشتعلت أولاً في اليونان، ثم انتقلت إلى روما، ومنها إلى ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، قبل أن تستقر لعدة قرون في إنكلترا، لتصلَ أخيراً إلى الولايات المتحدة الأميركية (8) . للأصول أهميةٌ كبيرة، والطريقة التي نحدد بها من أين جاء الغرب تعكس بالضرورة تصورنا لماهية الغرب في جوهرهِ.
تُستحضَر شجرة النسب الثقافية، المتخيَّلة للغرب، صراحةً في خطابات السياسيين الشعبويِّين، والخطاب الإعلامي، وتحليلات المثقَّفين. وتشكل الأساس الرمزي والمفاهيمي الذي يستخدمه أشخاصٌ من مختلف التيارات السياسية. من بين هذه المرجعيات، ثمَّة تركيز خاص على العصور القديمة اليونانية – الرومانية بوصفها مهْد الغرب، حيث تُستخدم الإشارات إلى اليونان القديمة وروما بكثرة في الخطاب السياسي المعاصر. فعلى سبيل المثال، عندما اقتحم حشد من المتظاهرين مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021، زاعمين أنَّهم يدافعون عن القيم الغربية، حملوا أعلاماً كُتب عليها عبارات إغريقية قديمة، ولوحات تُصور الرئيس السَّابق دونالد ترامب على هيئة يوليوس قيصر، في حين ارتدى بعضهم خوذات إغريقية قديمة، وارتدى آخرون الزي العسكري الروماني الكامل(9). وفي عام 2014، عندما أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة لمكافحة الهجرة غير النظامية وتدفُّق اللَّاجئين، اختار لها اسم «عملية موس مايوروم Operation Mos Maiorum»، في إشارةٍ إلى التقاليد الرومانية القديمة (10).
وعندما أعلن أسامة بن لادن، في عام 2004، حرباً مقدَّسةً ضدَّ الغرب، وصفهُ بأنَّه «روما الجديدة»، داعياً المسلمين إلى مقاومته(11). لكنَّ سردية «حضارة الغرب» هذه لا تقتصر على الخطاب السياسي أو الأعمال التاريخية، بل هي جزء من نسيج حياتنا اليومية. نشاهدها في الأفلام والمسلسلات، حيث تظهر مشفَّرة في اختيارات المخرجين، وتصميمات الأزياء، والموسيقى التصويرية. نصادفها أيضاً منحوتةً في الحجر، ليس فقط في مكتبة الكونغرس، بل في العِمارة الكلاسيكية الجديدة للعواصم الإمبراطورية والمباني الاستعمارية في شتى أنحاء العالم (12). إنَّها منتشرة لدرجة أننا نتقبَّلها دون مساءلة. لكن، هل هي صحيحة حقًّا؟
تلك هي الأفكار التي تدافعت في ذهني مساءَ ذلك اليوم الممطر في واشنطن العاصمة. بحلول ذلك الوقت، كنت قد أمضيتُ ما يقارب عقدين من الزمن أدرِّسُ هذه الأصول المتخيَّلة للغرب على وجه التحديد، والتي يُستثمر فيها جزء كبير من الهُوية الغربية. كان مجال بحثي الأساس يدور حول كيف فهِمَ الناس في العالم الإغريقي القديم أصولهم الخاصة، والتحقيق في الأنساب الأسطورية التي صنعوها، وعبادات الأسلاف التي مارسوها، والقصص التي تروى عن الهجرات ومراحل التأسيس. ورغم أنني كنت (ولا أزال) أشعر بالامتياز لعملي في هذا المجال، فإنَّ شعورًا عميقاً بعدم الارتياح قد راودني في تلك اللحظة. أدركت أنني متواطئة، بطريقة ما، في دعم بنية فكرية زائفة، مشكوك فيها أيديولوجيًّا وغير دقيقة تاريخياً-السردية الكبرى للحضارة الغربية. منذ تلك اللحظة، بدأت أعيد توظيف الأساليب التحليلية التي استخدمتها لدراسة الهويات والأصول في العصور القديمة، وأطبقها على العالم الحديث من حولي. وهذا الكتاب هو النتيجة.
يجادلُ، هذا الكتاب، في إشكالين أساسيَّيْنِ. الإشكال الأول: إنَّ السردية الكبرى للحضارة الغربية خاطئة من الناحية الواقعية. فالغرب الحديث لا يمتلك أصلاً واضحاً وبسيطاً في العصور الكلاسيكية القديمة، ولم يتطورْ من خلال سلسلة متصلة ومنفردة تمتد من العصور القديمة عبر المسيحية في العصور الوسطى، وعصر النهضة، والتنوير، وصولاً إلى الحداثة. ولم تُنقلْ الهوية والثقافة الغربية كما لو كانت «كتلة ذهبية صافية»، على حد تعبير الأكاديمي والفيلسوف كوامي أنتوني أبياه (13). لقد أُشِيرَ إلى مشكلات هذه السرديَّة الكبرى قبل أكثر من قرن، واليومَ أصبحت الأدلة التي هي ضدها قاطعة. فكلُّ المؤرِّخين وعلماء الآثار الجادين يعترفون الآنَ بأن التفاعل المتبادل بين الثقافات «الغربية» و«غير الغربية» حدث عبر التاريخ البشري بأكمله، وأن الغرب الحديث يدين بجزء كبير من إرثه الثقافي لأسلاف غير أوروبيين وغير بيض (14).
مع ذلك، لا تزال طبيعة هذه التفاعلات الثقافية وتعقيداتها بحاجة إلى المزيد من الدراسة والفهم، فلم تتشكل بعدُ سردية كبرى جديدة تحلُّ محلَّ السردية التقليدية للحضارة الغربية. كانت المساهمة في هذا العمل جزءاً من دوافعي لكتابة هذا الكتاب. أمَّا الدافع الآخر، فقد جاء من تأمُّلي في حقيقة مثيرة للقلق، وهي أن جميع الأدلة التاريخية المتراكمة، وكل الإجماع الأكاديمي ضد هذه السردية، كان له تأثير محدود للغاية على الوعي العام. لا تزال هذه السردية حاضرةً بقوة في الثقافة الغربية المعاصرة. لماذا لا نزال (أعني مجتمعات الغرب، بوجه عام) متمسكين بشدة برؤية للتاريخ فقدت مصداقيتها بالكامل؟
أيضاً، وانسجاماً مع الإشكال الأول، يجادل هذا الكتاب في أن اختراع السردية الكبرى للحضارة الغربية، ونشْرها، واستمرارها طويل الأمد، كل ذلك بسبب فائدتها الأيديولوجية. وُجِدت هذه السردية – ولا تزال قائمةً اليوم رغم دحضها علميًّا – لأنها تؤدِّي غرضاً بعينه. بوصفها إطاراً مفاهيميًّا، قدمت تبريراً للتوسع الغربي والإمبريالية، كما دعمت استمرار أنظمة الهيمنة العِرقية البيضاء. هذا لا يعني أن السردية الكبرى للحضارة الغربية كانت من اختراع عقل مدبِّرٍ شرير، يتآمر بوعيٍّ لصياغة رؤية زائفة للتاريخ تخدم مصالحه. بل على العكس تماماً. لقد نُسجت هذه القصة تدريجيًّا وعشوائيًّا، مصادفةً، بقدر ما كانت بحكم التخطيط المتعمد. إنَّها سردية كبرى تتكون من سرديات أصغر، مترابطة ومتشابكة، استُخدمت كل واحدة منها منفصلةً لخدمة أهداف سياسية محدَّدة.
إنَّهم يصورون أثينا الكلاسيكية على أنَّها منارةٌ للديمقراطية، فتمثِّل ميثاقاً تأسيسيًّا للديمقراطية الغربية الحديثة (15). ويزعمون أن قدامى الرومان كانوا أوروبيين بالأساس، ممَّا أصَّلَ لفكرةِ التراث الأوروبي المشترك (16). ناهيك عن أسطورة الحروب الصليبية بوصفها صراعاً حضاريًّا بسيطاً بين العالم المسيحي والإسلام، وهي سردية استُخدمت لتبرير الجهاد المناهض للغرب من جهة، و«الحرب على الإرهاب» من جهة أخرى (17). لقد وُثِّقت الفائدة الأيديولوجية لتلك السرديات المصغَّرة، وغيرها كثير، ورُوِيت كلُّ واحدةٍ منها لأنَّها تتماشى مع توقعاتِ ومُثُل مَن يرويها. على الصعيد الفردي، هذه القصص متنوعة ومثيرة للاهتمام، وآمل أن يستمتع القرَّاء باستكشاف هذا التنوع المبهر في صفحات هذا الكتاب. أمَّا على الصعيد الجمعي، فهي تشكل السردية الكبرى للحضارة الغربية، وتجسِّد أسطورة أصل للغرب (18).
الغرب، بالطبع، ليس الكيان السياسي- الاجتماعي الوحيد الذي أعاد بناء روايةٍ عن ماضيه تتماشى مع احتياجاته وصورته عن ذاته المعاصرة. في الواقع، إنَّ إعادةَ تصوُّرِ التاريخ لأغراض سياسية ممارسةٌ شائعة جداً، نشأتْ منذ بدء تدوين التاريخ نفسه – بل وربما قبل ذلك بكثير، واستمرتْ عبر التاريخ الشفهي وسرد القصص داخل المجتمعات. فعلى سبيل المثال، يُقال إنه في أثينا، خلال القرن السادس قبل الميلاد، أُضيفت أبياتٌ جديدة إلى الإلياذة لهوميروس لتوحي بأن أثينا كانت تسيطر على جزيرة إيجينا في عصر الأبطال. ومن غير المفاجئ أن هذه الإضافات أُدرجت في الوقت نفسه الذي كانت تحاول فيه أثينا فرض سيطرتها الفعلية على تلك الجزيرة (19). وفي العصر الحديث، بعد إعلان قيام الدولة القومية الحديثة في تركيا عام 1923، نُفِّذ برنامج تاريخي وأثري واسع النطاق عُرف بـ«أطروحة التاريخ التركي Turkish History Thesis»، استهدف تعزيز الهوية القومية التركية وربطها بالأراضي الأناضولية (20). أمَّا في الصين، وتحت قيادة شي جين بينغ، فقد رُوِّجَ بقوة لسردية جديدة حول دور الصين في الحرب العالمية الثانية، وهو أمر قد يكون مثيراً للقلق أو مشجِّعاً، بحسب وجهة نظر متلقِّيه (21).
في يوليو 2021، وبينما كانت القوات الروسية تُحشد على الحدود الأوكرانية استعداداً للغزو العسكري، نشرَ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطروحة تاريخية تدَّعي وحدة الأصل عبر التاريخ ما بين الشعبين الروسي والأوكراني.
ليس من الضروري أن تكون خبيثًا أو مخادعاً لكي تعيد كتابة التاريخ وفقاً لأجندة سياسية، كما أنه ليس من الضروري أن تقوم بتزييف التاريخ لتحقيق ذلك. يمكن أن تتجسَّد إعادة كتابة الماضي أيضاً في اختيار إدراج حقائق تعرضت للتجاهل أو الإقصاء من السَّردية التقليدية. على سبيل المثال، في عام 2020، نشر الصندوق الوطني في بريطانيا تقريراً حول الروابط بين الاستعمار والعبودية والمباني التاريخية التي يشرف عليها. أشعلَ هذا التقرير التوترات أكثر خلال نقاش وطني محتدم أساساً حول ميراث بريطانيا الإمبريالي (22). ثمَّة رأي، في هذا الجدل، دعا إلى ضرورة أن تحظى الحقائق غير المريحة حول الاستعمار والعبودية والاستغلال بمكانةٍ أكبر في المناهج الدراسية، وكذلك في المتاحف والمواقع التراثية. على الرغم من أنَّ هذا الموقف يستند إلى حقائق تاريخية، فإنه يحمل أيضاً بُعداً سياسيًّا جوهريًّا، إذْ يستند إلى مبادئ سياسية تدعو إلى تحقيق عدالة اجتماعية أكبر، والاعتراف بالجرائم التاريخية. أما الرأي المعارض – الذي يرى أن هذه الموضوعات غير المريحة لا ينبغي أن تحظى بهذا التركيز، ويجب بدلاً من ذلك تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية من التاريخ – فهو أيضاً مدفوع بأجندة سياسية، لكنها أجندة تسعى إلى الإبقاء على الوضع الرَّاهن.
يُبرِزُ هذا الجدل نقطتين أساسيتين: أولاهما، كلُّ التاريخ هو تاريخ سياسي. واختيار إعادة كتابته أو إعادة النظر فيه أو حتَّى مراجعته هو فعل سياسي. وبالمثل، فإنَّ اختيار عدم إعادة كتابته هو أيضاً فعل سياسي. ثانيهما، الحقائق التاريخية نفسها ليست دائماً موضع خلاف. إنَّما النقاش غالباً ما يدور حول أيٍّ من تلك الحقائق يجب أن تحظى بالأولوية، وأين ومتى ينبغي التركيز عليها. بالتأمل في هاتين النقطتين، نستنتجُ أنه لا يوجد خطأ جوهريٌّ في كتابة التاريخ من منظور سياسي. في الواقع، هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يُكتب بها التاريخ.
لكنَّ المشكلة تكمن في كتابة تاريخٍ يتناقض مع الحقائق المتاحة. وهذه من أكبر الإشكالات في السردية الكبرى للحضارة الغربية. فالأساس المُثبت الذي تستند إليه هذه السردية قد انهار منذ زمنٍ، ورغم أنَّ بعض عناصرها الفردية ما زالت قائمة، فإنَّ السردية العامة لم تعدْ تتماشى مع الحقائق التي بتنا نعرفها اليوم. مع ذلك، لا يزال بعضهم، في الغرب، يتشبَّث بهذه السرديَّة الكبرى لقيمتها الأيديولوجية. وهنا نصل الآنَ إلى الإشكال الثاني في هذه السرديَّة: لم تعد الأيديولوجيا التي استندتْ إليها قبلاً تعكس مبادئ الغرب الحديث اليومَ. فالمبادئ التي توجِّه المجتمع الغربي في منتصف القرن الحادي والعشرين تختلف عن تلك التي كانت سائدة في منتصف القرن التاسع عشر، عندما بلغت هذه السَّردية أوجها، وعن تلك التي كانت قائمة في منتصف القرن الثامن عشر، عندما بدأت هذه السرَّدية في التَّشكُّل لأول مرة. بحسب آراء الكثيرين، داخل الغرب اليوم، لم تعد أفكار تفوُّق العِرق الأبيض والإمبريالية تمثِّل جوهر الهوية الغربية. بل حلَّت محلَّها أيديولوجيا قائمة على الليبرالية، والتسامح الاجتماعي، والديمقراطية. (مع ذلك، ثمة أيضاً عددٌ كبير من الأشخاص داخل الغرب ممَّن لا يتفقون مع هذا التحوُّل، ويفضلون العودة إلى نموذج الهُوية الغربية في القرن التاسع عشر. سأتناول هذه الفئة بمزيدٍ من التفصيل في الخاتمة).
يجب أن نتخلص من السَّردية الكبرى للحضارة الغربية، ونضعها جانباً باعتبارها خاطئةً من الناحية الواقعية وعفا عليها الزمن من الناحية الأيديولوجية. إنَّها أسطورة أصْلٍ لم تعد واقعيةً، فهي لا تقدم سرداً دقيقاً عن التاريخ الغربي، ولا تشكِّل أساساً أيديولوجياً مقبولاً للهُوية الغربية. لذا، فإنَّ هدفي في هذا الكتاب تفكيك هذه السَّردية الكبرى من خلال تحليل السرديات الأصغر المؤلِّفة لها، ثُم الكشف عن المكونات الأيديولوجية التي تستند إليها.
ونظرًا لأنَّ موضوع هذا الكتاب يتعلق بمفهوم مجرَّدٍ (رغم أنه مفهوم قوي ومؤثر للغاية)، كان من السهل أن ينزلق إلى مجالات نظرية بحتة. لتفادي ذلك، استندتُ في سرديتي إلى حياة أربع عشرة شخصيةً تاريخية حقيقية.
ربما بعض هذه الأسماء مألوفة، في حين أن بعضها الآخر أقلُّ شهرة. لكن مِن الشاعر المستعبَد إلى الإمبراطور المنفي، ومن الرَّاهب الدبلوماسي إلى البيروقراطي المحاصر، تعيد قصصهم رسْمَ ملامح التاريخ الغربي من منظور جديد. لا أكتفي في كل فصل بتقديم قصة حياة شخصية تاريخية استثنائية فحسب، بل أقدِّمُ أيضاً رؤيةً شاملةً للعصر والمكان اللَّذين عاشَ فيهما كلٌّ منهم، مع وضعهم في سياقٍ أوسع إلى جانب الشخصيات المهمة الأخرى التي عاصرتْهم.
يتناول النصف الأول من هذا الكتاب عدم الدِّقة التاريخية في السَّردية الكبرى للحضارة الغربية، إذْ يعمل على تفنيد الوهم القائل بوجود خطٍّ ثقافي نقي ومتصل دون انقطاع، وذلك من خلال تحليل أصوله المزعومة. نختار أول شخصيتين في هذا القسم من العالَم الكلاسيكي، الذي يُفترض أنه مهْد الغرب. إلَّا أنَّ قصتيْهما تكشفانِ عن أن قدامى الإغريق والرومان لم يصنفوا أنفسهم جزءاً من هوية «غربية» أو «أوروبية» حصرية (الفصلان: الأول والثاني). تعود السِّير الذاتية الثلاث التالية إلى ما يُعرف بـ «الفترة المظلمة» في العصور الوسطى، لكنها توضِّح كيف بُنيَ التُّراثانِ الإغريقي والروماني، أو رفضهما، أو إعادة تصورهما في سياقات إسلامية، وأوروبية وسطى، وبيزنطية، على التوالي (الفصول: الثالث والرابع والخامس). أما آخر سيرتين في هذا القسم، فتنتقلانِ بنا إلى عصر النهضة والفترة الحديثة المبكرة، آنَ رُسمت الحدود الحضارية بطرائق مختلفة ومتناقضة، عبر تقسيم كلٍّ من القارة الأوروبية والكيان الأوسع للمسيحية بطريقة تنفي فكرة وجود «غرب» متماسك (الفصلان: السادس والسابع).
يناقش النصف الثاني من الكتاب كيف قامت «حضارة الغرب» بدور الأداة الأيديولوجية، ويتتبَّع ظهورها وتطورها وصولاً إلى السردية الكبرى التي أصبحت مألوفةً اليوم. تستعرض الفصول الثلاثة الأولى في هذا القسم كيف ساهم تغيُّر الأفكار في القرنين السادس عشر والسابع عشر حول الدين والعلم، والتوسع العالمي والإمبريالية، والعقد السياسي في الظهور التدريجي لفكرة «حضارة الغرب» (الفصول: الثامن والتاسع والعاشر). ويعكس الفصلان اللَّاحقان كيف تطورت فكرة «حضارة الغرب» إلى شكلها الناضج الذي قدَّم دعاماتٍ للإمبريالية الغربية وأنظمة الهيمنة العِرقية المنتشرة (الفصلان: الحادي عشر والثاني عشر).
أمَّا آخر فصلين من الكتاب فيستعرضانِ أكبر التحديات التي تواجه الغرب و«حضارة الغرب» اليومَ – تحديات النقد الداخلي والمنافسة الخارجية – ويظهرانِ التَّحولات في الواقع الذي نعيشه، والحاجة المُلحَّة لإعادة التفكير الجذري في هُوية الغرب الأساسية؛ وأسطورة أصل «حضارة الغرب» (الفصلان الثالث عشر والرابع عشر).
تعدُّ هذه الشخصيات، الأربع عشرة، بديلاً شخصيًّا لي عن التماثيل البرونزية التي أثارتْ لديَّ، في مكتبة الكونغرس، ذلك الشُّعور العميق بعدم الارتياح. لكن، على عكس تلك المجموعة من «الأسلاف المتخيَّلينَ»، لم أختر الأفراد الذين أروي سِيرهم في هذا الكتاب لأنَّهم الأكثر أهمية أو نفوذاً في عصورهم. ولا أدَّعي تقديم «معرضٍ للعظماء» في هذا الكتاب. إنَّما هذه الشخصيات الأربع عشرة، التي أتناولها هنا، لأشخاص عكست حيواتهم وأعمالهم روح عصورهم، ومن خلال تجاربهم وأفعالهم وكتاباتهم، يمكننا أن نتلمَّسَ تطور الأفكار حول الإرث الحضاري والسُّلالاتِ الثقافية المتخيَّلة. لم تكن هذه الشخصيات الخيارات الوحيدة التي كان يمكن أن أتناولها في هذا الكتاب، بالطبع، وأنا متأكدة من أنَّ كل قارئ سيختار شخصياتٍ مختلفة لو شَرع في مشروع مشابهٍ. بيدَ أنَّ هذه الشخصيات تحقِّقُ غايتي المرجوَّة. فهي تثبت أنَّ السردية الكبرى للحضارة الغربية ليست فقط غير صحيحة، بل إنَّها مفلسة أيديولوجياً أيضاً. كما أنَّها تكشف، على المستوى الإنساني الفردي، لماذا ينبغي علينا التخلص من هذه السردية نهائيًّا. وأخيراً، تقترح هذه القصص مجموعةً أكثر غنىً وتنوُّعاً من الأصول التاريخية، يمكننا مِن خلالها البحث عن نسخة جديدة للتاريخ الغربي تحلُّ محلَّ سَرديته القديمة.
المراجع
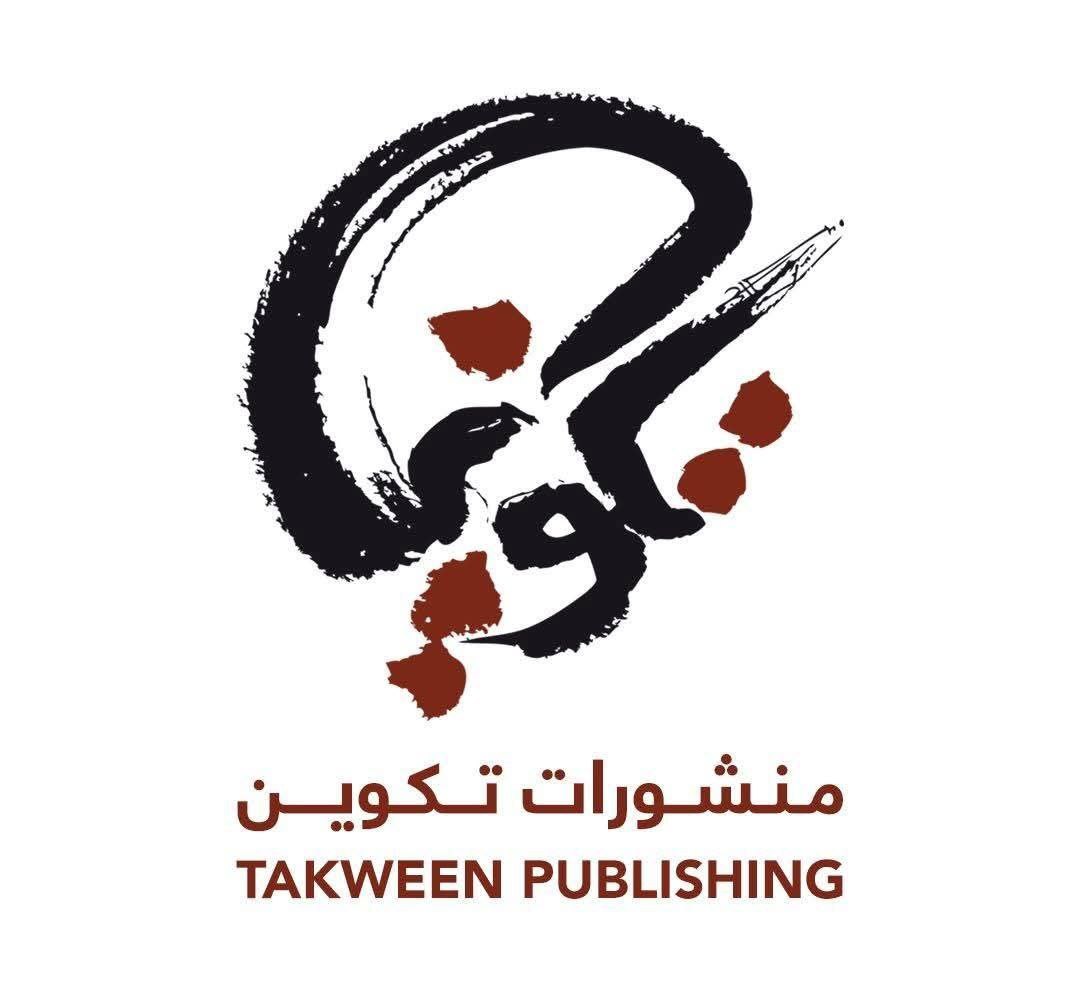
دار نشر تأسست عام 2017، مقرها الكويت والعراق، متخصصة في نشر الكتب الأدبية والفكرية تأليفاً وترجمة.
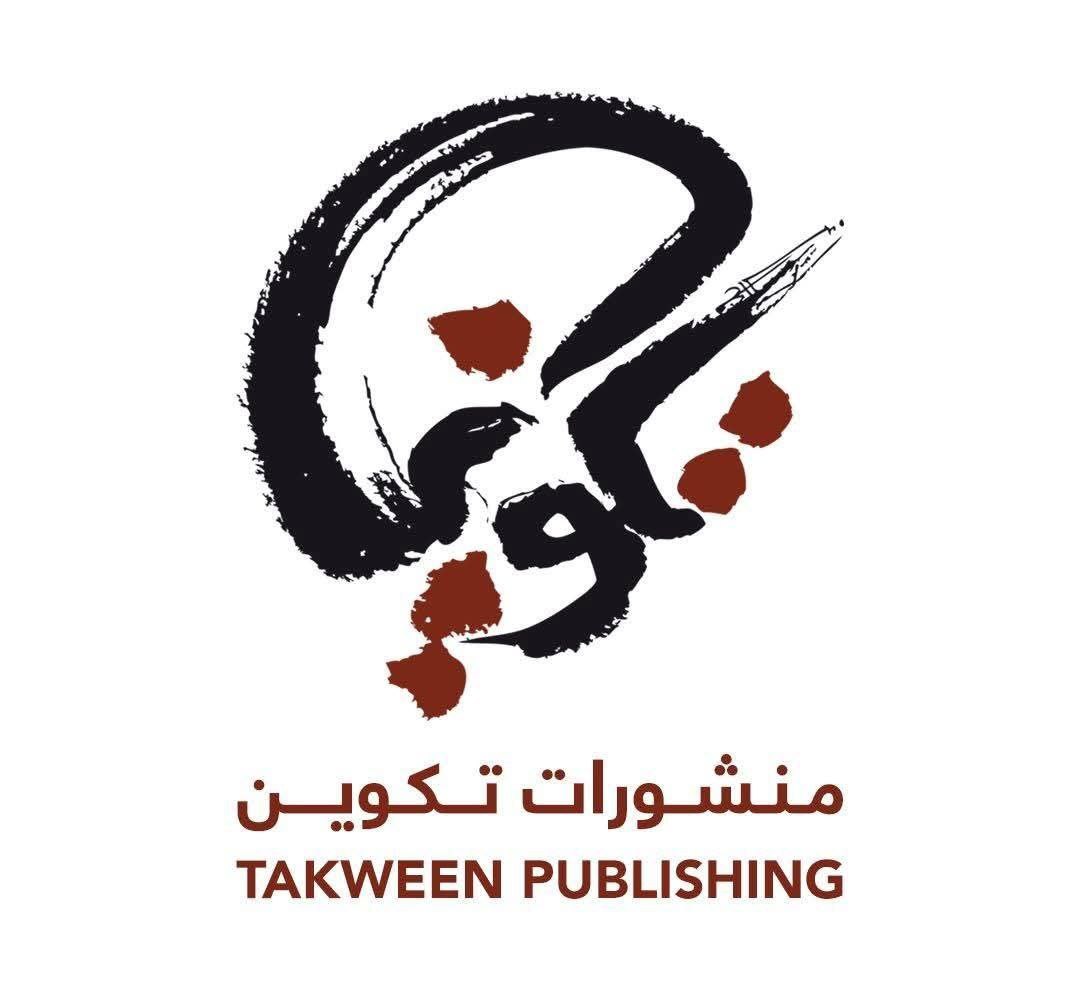
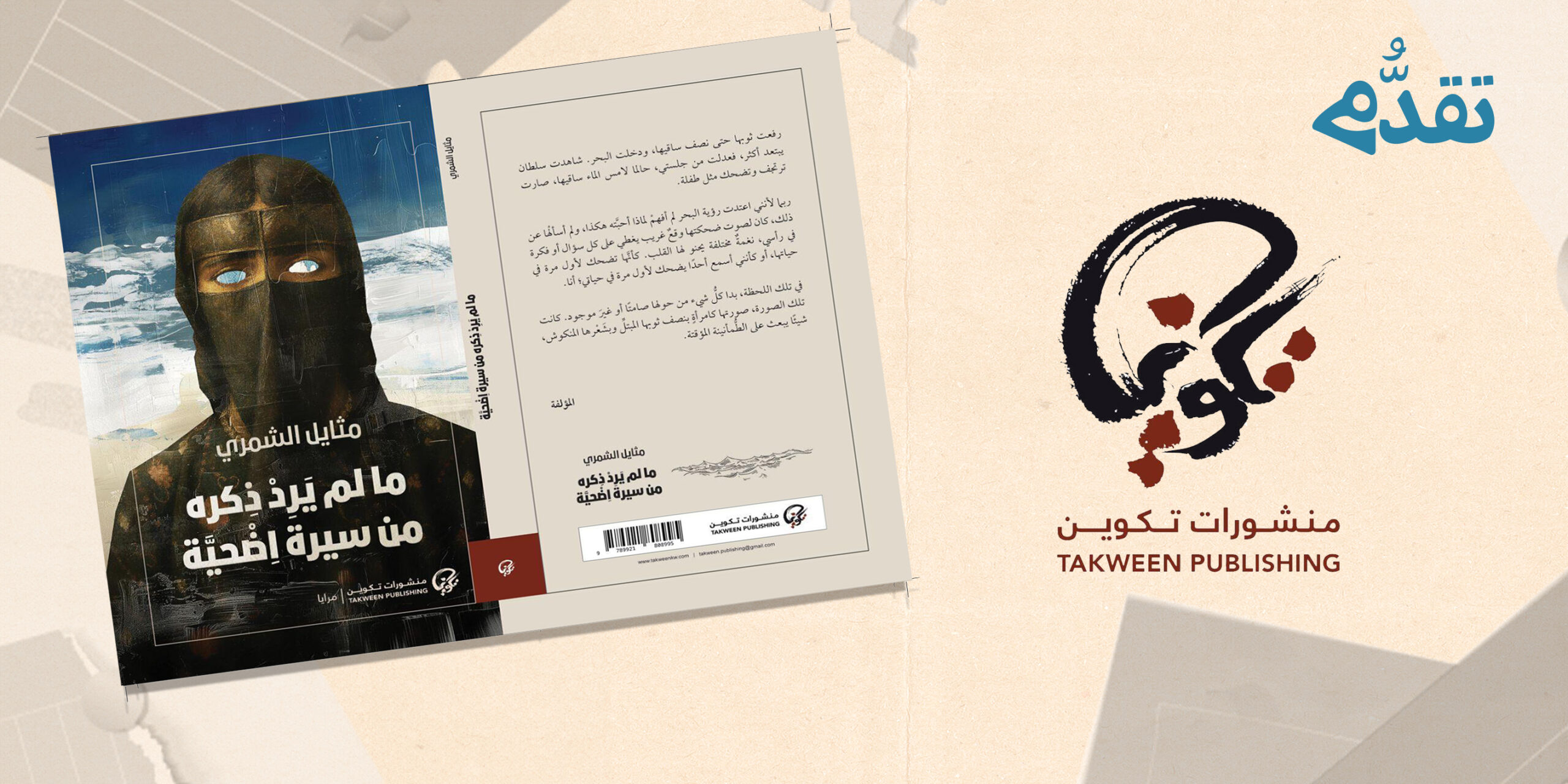
صدر عن منشورات تكوين رواية ” ما لم يَرِدْ ذِكره من سيرة اِضْحيَّة” لـ مثايل الشمري. “الحقيقة ليست مقيَّدة بأن تُوجِد الأشياء أو تحدث، وإنَّما
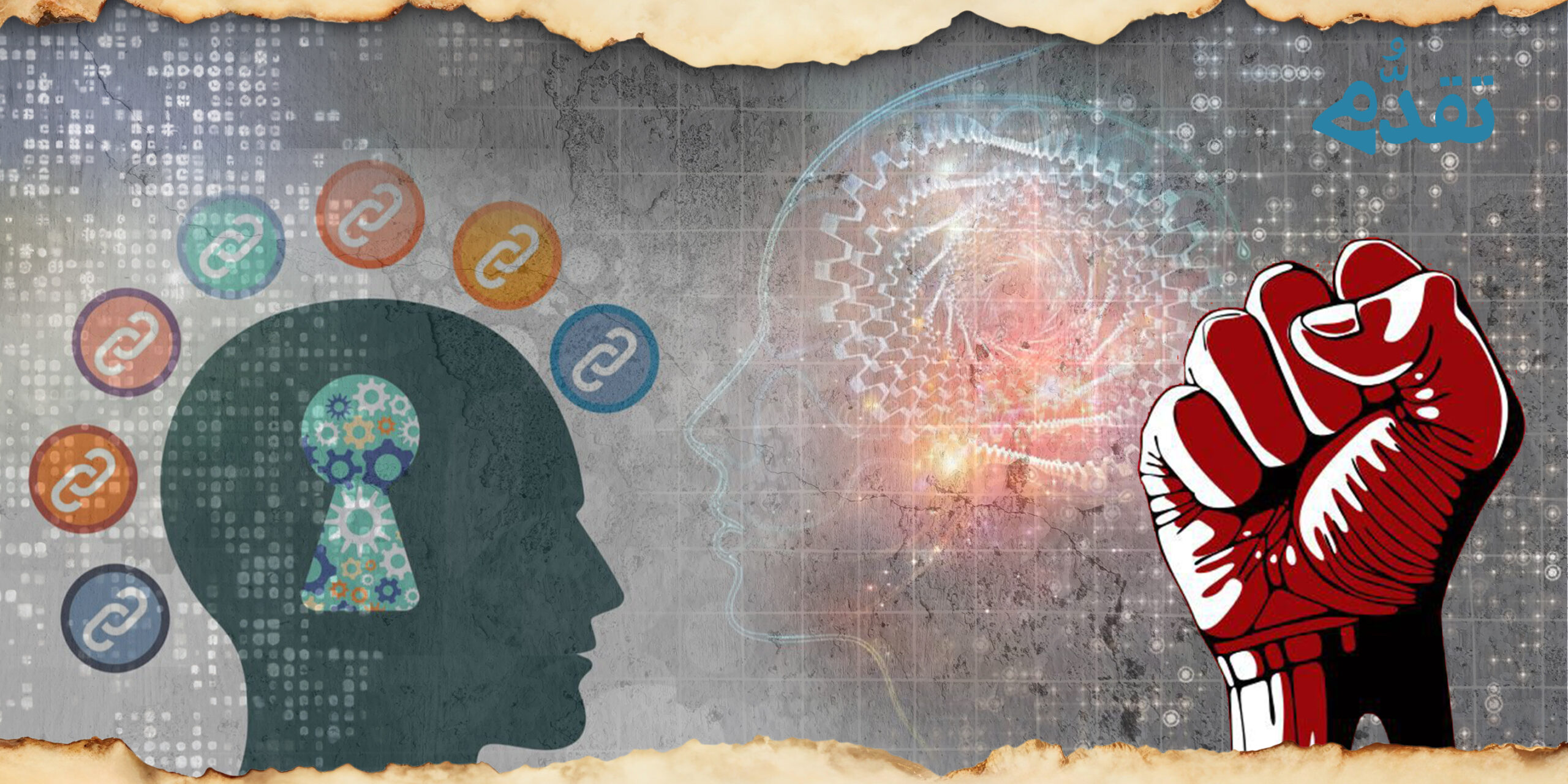
حصر الوضعية المنطقية مهمة الفلسفة بالتحليل المنطقي للغة يعني أتها تئد الفلسفة، والعلم ،والإبداع، تقيد الفلسفة بمجال واحد تصادر فيه باقي مفاهيم الفلسفة ومهمتها المناقضة لها، وتمنع حرية اختيار مفاهيم أخرى لها.

في رواية “مِخْيال معيوف” يبدأ السرد من ولادة معيوف في صحراء الشعيب غرب الكويت، حيث يقضي الأشهر الستّة الأولى من حياته عليلًا قبل نقله إلى

اللغة هي الحاضنة الأولى للهوية، والوعاء الذي تنعكس فيه الحضارة، وأداة الشعوب في صياغة وعيها ومكانتها بين الأمم. وفي زمن العولمة المتسارعة، تتعرض اللغة العربية