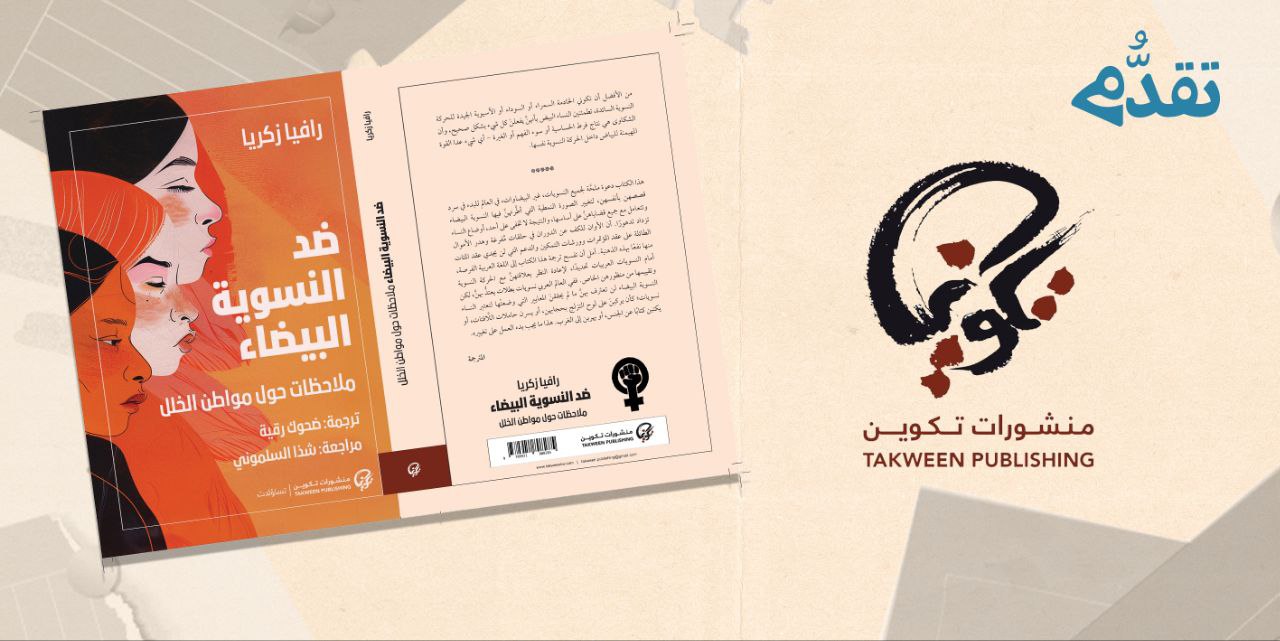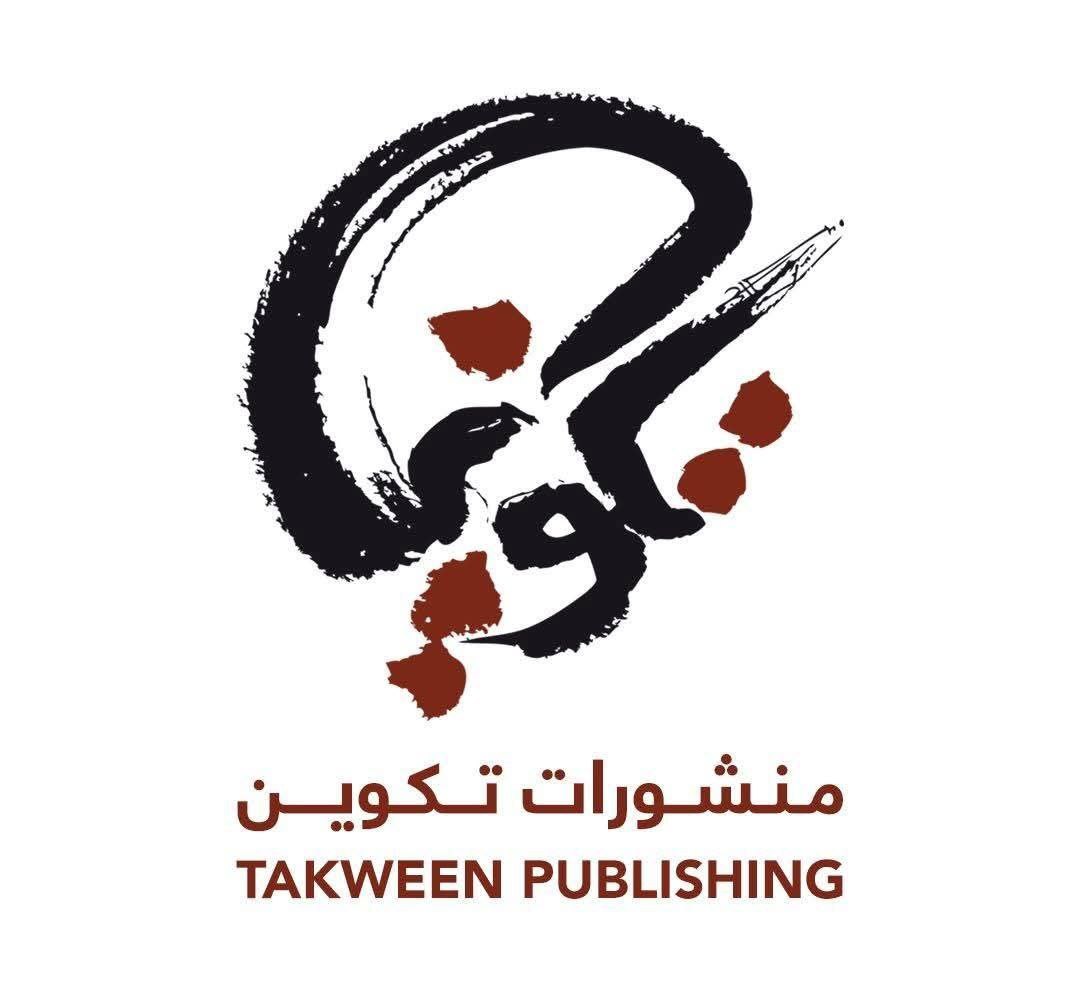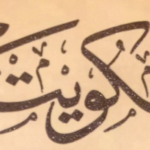صدر عن منشورات “تكوين” ضمن سلسلة تساؤلات كتاب: ضد النسوية البيضاء (ملاحظات حول مواطن الخلل) للكتابة رافيا زكريا، ترجمة ضحوك رقية، ومراجعة شذا السلموني.
كلمة غلاف ضد النسوية البيضاء
من الأفضل أن تكوني الخادمة السمراء أو السوداء أو الآسيوية الجيدة للحركة النسوية السائدة، تطمئنين النساء البيض بأنهنَّ يفعلنَ كل شيء بشكل صحيح، وأن الشكاوى هي نتاج فرط الحساسية أو سوء الفهم أو الغيرة – أي شيء عدا القوة المهيمنة للبياض داخل الحركة النسوية نفسها.
***
هذا الكتاب دعوة ملحَّة لجميع النسويات، غير البيضاوات، في العالم للبدء في سرد قصصهن بأنفسهن، لتغيير الصورة النمطية التي أطَّرتهنَّ فيها النسوية البيضاء وتتعامل مع جميع قضاياهنَّ على أساسها، والنتيجة لا تخفى على أحد، أوضاع النساء تزداد تدهورًا. آن الأوان للكف عن الدوران في حلقات مُفرغة وهدر الأموال الطائلة على عقد المؤتمرات وورشات التمكين والدعم التي لن يجدي عقد المئات منها نفعًا بهذه الذهنية. آمل أن تفسح ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية الفرصة، أمام النسويات العربيات تحديدًا، لإعادة النظر بعلاقتهنَّ مع الحركة النسوية وتقييمها من منظورهن الخاص. ففي العالم العربي نسويات بطلات يعتدُّ بهنَّ، لكن النسوية البيضاء لن تعترف بهنَّ ما لم يحققنَ المعايير التي وضعتْها لتعتبر النساء نسويات؛ كأن يركبنَ على لوح التزلج بحجابهن، أو يسرن حاملات اللَّافتات، أو يكتبن كتابًا عن الجنس، أو يهربن إلى الغرب. هذا ما يجب بدء العمل على تغييره.
المترجمة
ملاحظات من المؤلفة
عندما أصف امرأة بأنها نسوية بيضاء فأعني بذلك المرأة التي ترفض الاعتراف بالدور الذي لعبه البياض والامتياز العرقي المرتبط به وما زالا يلعبانه في تعميم اهتمامات الحركة النسوية البيضاء وأجنداتها ومعتقداتها بوصفها اهتمامات وأجندات ومعتقدات الحركة النسوية كلها والنسويات جميعهن. أن تكون المرأة بيضاء اللون لا يعني بالضرورة أن تكون نسوية بيضاء. كما أنه من الممكن جدّاً، أن تكون بيضاء ونسوية ولا تكون نسوية بيضاء. يصف هذا المصطلح مجموعة من الافتراضات والسلوكيات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحركة النسوية الغربية السائدة، أكثر مما يصف هوية أتباعه العرقية. وفي نفس الوقت، لا يمكن إنكار حقيقة أن معظم النسويات البيضاوات هنّ بالفعل من العرق الأبيض، وأن البياض بحد ذاته في صلب الحركة النسوية البيضاء.
قد تكون النسوية البيضاء امرأة تحترم بكل صدق مفاهيم «التقاطعية»، بمعنى الحاجة إلى حركة نسوية تعكس أوجه عدم المساواة البنيوية على أساس العرق، والدين، والطبقة، والإعاقة، وما إلى ذلك، وكذلك الجندر، لكنها تخفق في فسح المجال أمام النسويات الملونات اللاتي يتعرضن للتجاهل أو الكبت أو الاستبعاد من الحركة النسوية. قد تشارك النسويات البيضاوات في مسيرات للحقوق المدنية، تضم صديقات سوداوات، وآسيويات وسمراوات، وفي بعض الحالات يكنّ هنّ أنفسهن سوداوات، وآسيويات وسمراوات، لكن ولاؤهن يكون لهياكل تنظيمية أو نظم معرفية تكفل بقاء خبرات واحتياجات وأولويات النساء السوداوات والآسيويات والسمراوات مهمشة. وعلى نحو أعم، أن تكوني نسوية بيضاء، يعني ببساطة أن تكوني إنسانة تقبل المزايا التي يمنحها التفوق الأبيض على حساب الملونات، في الوقت الذي تدعين فيه دعم المساواة الجندرية والتضامن مع “جميع” النساء.
هذا الكتاب نقد للبياض داخل الحركة النسوية. ويستهدف الإشارة إلى ما يجب استئصاله، وما يجب تفكيكه، لكي يحل محله شيء جديد، شيء أفضل. كما يوضح سبب عدم نجاح المبادرات التي تضم نساء سوداوات أو آسيويات أو سمراوات إلى الهياكل القائمة. ولأنه كتاب نقدي، لم يكن من الممكن عرض تنوع وجهات النظر الموجودة بين النساء السوداوات والآسيويات والسمراوات. يقوم آخرون بهذا العمل، لكن لكي يُعطى هذا الجهد حقه، لا بد من إنجاز مشروع التفكيك هذا. يتناول هذا الكتاب ما يفعله “البياض” داخل الحركة النسوية، ولا بد من القيام بعمل مماثل حول كيفية عمل البياض ضمن حركات المثليات والمثليين والمتحولين والكويريين.
ليس الهدف هنا إقصاء النساء البيضاوات من الحركة النسوية، بل استئصال البياض، بكل اعتباراته عن الامتياز والتفوق، وذلك لتعزيز حرية جميع النساء وتمكينهن.
المقدمة: مجموعة نسويات في حانة
إنها أمسية خريفية دافئة، وأنا أجلس في إحدى حانات مانهاتن رفقة خمس نساء أخريات. المزاج لطيف ومريح. تعمل اثنتان منهما في مجال الكتابة والصحافة، مثلي، والثلاث الأخريات في مجال الإعلام والنشر. جميعهن، باستثنائي، بيضاوات. كنت متحمسة لانضمامي إليهن في ذلك المساء، وحريصة على إثارة إعجابهن وتكوين صداقات مع نساء عرفتهن مهنيّاً من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني فقط.
انتصب الحاجز الأول مع مجيء النادل للسؤال عن طلباتنا. “دعونا نفتح إبريق سانجريا!” قالت إحداهن، ووافقتها الأخريات بحماس، ثم التفتن إليَّ بحثاً عن الموافقة. “إنني أتناول بعض الأدوية في هذه الفترة، لكن من فضلكن يا رفيقات، تفضلن واشربن، سأشرب بشكل غير مباشر من خلالكن”، قلت بابتسامة رَمت قوتها إلى إخفاء ارتباكي وارتباكهن. ما قلته هو الحقيقة، لكني شعرت بالخجل من قولها. إنهن يعرفن أنني مسلمة، وتخيلتهن يتساءلن على الفور عمَّا إذا كنت متشنجة من وجودي بينهن. فأضفت بعد رحيل النادل: “ليس للدين علاقة بالأمر، لا فكرة لديكن عن مدى رغبتي في كأس الآن”. ضحكن جميعهن. الآن سيطر عليَّ شعور بالقلق من أن تكون هذه الضحكة قسرية وأن اختبار الانتماء هذا قد باء بالفشل.
لم يطُل الأمد أمام الحاجز الثاني، عندما انتشين جميعهن، إلاي، بفعل السانجريا وبدأن يتبادلن كثيراً من القصص الشخصية، ويتقاربن بالطريقة المفترضة عندما يفعل النبيذ فعله في حانات مانهاتن في الأماسي الدافئة. توقعت ما سيحدث، عندما نظرت إليَّ إحداهن، وهي كاتبة نسوية معروفة، بخبث “إذاً، يا رافيا… ما قصتك؟” سألتني بطريقة تآمرية، كما لو أنني أخفي سرّاً مغرياً.
“أجل”، أضافت إحدى الأخريات، وهي محررة في مجلة أدبية، “بالفعل، أخبرينا كيف تمكنت من المجيء إلى هنا.. أعني إلى أمريكا؟”
إنه السؤال الذي أمقته، وتعلمت تفاديه بإحدى نكات كوميديا الموقف. والتي أؤديها الآن أيضاً، لكنني أعلم أن الكوميديا لن تكفي، وستبدو تهرباً صارخ الوضوح. لكنني مستعدة لهذه اللحظة، لأسباب ليس أقلها، الصعوبة البالغة التي واجهتها عدة مرات في السابق لتجاوز هذا الأمر. في كثير من الأحيان (كما أُمسرِح في كوميديا الموقف) أقدم بعض الأكاذيب البيضاء. أخبر الناس بأنني أتيت إلى أمريكا عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري للالتحاق بالجامعة ثم طاب لي المقام.
إنها ثلثا كذبة فقط. الحقيقة أنني أتيت إلى أمريكا عروساً شابة. في إحدى الليالي بعد العشاء، جالسة على حافة سريري في كراتشي في منتصف التسعينيات، وافقت على زواج مدبَّر. كنت في السابعة عشرة من عمري، وعدني زوجي، الذي يكبرني بثلاثة عشر عاماً، وهو طبيب باكستاني أمريكي، “بالسماح” لي بالالتحاق بالجامعة بمجرد زواجنا. دفعتني أسباب أخرى إلى الموافقة، لكن إمكانية الالتحاق بالجامعة في الولايات المتحدة، الأمر الذي لن تسمح به أسرتي المحافظة أبداً (أو ليست قادرة على تكبد تكاليفه)، كان السبب الأساسي. كانت حياتي حتى ذلك الحين مقيدة بشتى الطرق، ولا تكاد تتجاوز الجدران المحيطة بمنزلنا. لم يسبق لي تجربة الحرية، لذلك وافقت على الزواج بكل سرور.
عند وصولي إلى الولايات المتحدة، انتقلت مباشرة إلى ناشفيل، تينيسي. وهناك التحقت بالكلية المعمدانية الجنوبية (حيث كانت لا تزال مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالكنيسة، وتوعدها بجهنم وبئس المصير لغير المعمدانيين أمر معروف)، وهي الكلية التي اختارها لي زوجي الجديد وسجلني فيها وكان عليَّ أن أدفع رسومها عن طريق القروض الطلابية. بعد التخرج فيها، توسلت إليه للحصول على إذن للالتحاق بكلية الحقوق، التي تقدمت إليها، وحصلت على منحة دراسية جزئية. رفض، ثم لان، ثم “غيَّر رأيه”، مذكراً إياي بأن وعده الزوجي كان السماح لي بالالتحاق بالجامعة، وليس بكلية الحقوق.
طفح الكيل بي من طبيعة علاقتنا التي قامت على صفقة أساساً. إذ لم تغير السنوات السبع التالية الأمور نحو الأفضل. وخلال شجارنا الأخير، تأثر ضابط الشرطة الذي وصل إلى المكان بزوجي الذي أصبح هادئاً ولطيفاً فجأة، فطلب مني “إصلاح الأمر”. ولم أعلم إلا بعد فترة طويلة أن هذا ما يقوله ضباط الشرطة للنساء اللاتي يطلبن مساعدتهم، طوال الوقت.
لم “أصلح الأمر”، بل قضيت الليلة حاملة طفلتي النائمة بين ذراعيَّ. وفي صباح اليوم التالي، بعد أن غادر زوجي إلى المستشفى للقيام بجولاته الصباحية، أخذتها، مع حقيبة ملابس صغيرة، وصندوق ألعاب، وفراش قابل للنفخ، وتوجهت بالسيارة إلى ملجأ للعنف المنزلي، لم يكن مميزاً ولا معروفاً. أرشدتني إليه امرأة شقراء الشعر تضع ظل عيون أزرق فاتح. قالت لي عندما التقينا في أحد مواقف سيارات ك مارت: “اتبعي سيارتي فحسب”، ففعلت، شغلت أغنية بارني للأطفال داخل سيارتي للحفاظ على هدوء ابنتي.
فكرت في نتائج سرد النسخة المختصرة من قصتي لجماعة المشروبات الأدبية هذه. فحتى لو أضفت إليها بعض التفاصيل ستبدو النسخة المنقحة من الحقيقة مقتضبة ويكتنفها الغموض. وبوح الأسرار ركيزة بناء الصداقات، لذلك يمكنني أن أبدأ الآن في حَبْك هذا النسيج، وتمتينه بسداة ولحمة قصتي.
لكن شعرت أيضاً أنني لا أستطيع تقديم النسخة غير المحررة. لأن سرد حقيقة تلك المحنة، وما كابدته بعد ذلك في كفاحي من أجل بناء حياتي الخاصة كأم عزباء شابة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لا يبدو مناسباً بالتأكيد لحانة النبيذ ورفيقاتي الأنيقات، المخمورات بعض الشيء، الصاحبات اللواتي يلبسن موضة الصحوة للظلم الاجتماعي. لقد أخبرت الحقيقة كاملة لنساء من هذا النوع من قبل، وحصلت على رد الفعل نفسه دائماً. تتسع العيون، تملؤها نظرات الصدمة والجدية، توضع الأيدي على الأفواه، وتلتف الأذرع حول كتفي، عندما أنتهي، يكون هناك تعاطف حقيقي، فيبدأن بالتنقيب الحثيث في ذاكرتهن عن قصص مشابهة، قصة عمة، صديقة، قصة لها صلة بالعنف. ثم يحدث أحد أمرين.
إذا حالفني الحظ، تلقي امرأة ما دعابة أو تقترح نخباً وننتقل إلى مواضيع أخرى، أنخرط فيها بحماس. وفي كثير من الأحيان، عندما لا أكون محظوظة، يسود صمت غير مريح بينما يحدق الجميع إلى الطاولة أو إلى الكؤوس. ثم يبدأ التقاط الحقائب والهواتف وابتداع أسباب المغادرة وسط تصريحات من قبيل “كم كانت هذه الجلسة جيدة” و”لا بد أن نعيدها مرة أخرى” و”شكراً لك على مشاركة قصتك». الكلمات حسنة النية، لكن النبرة جلية لا لبس فيها. لا أتذكر أبداً أننا «أعدنا تلك الجلسة مرة أخرى”.
أعرف السبب. ثمة انقسام داخل الحركة النسوية لم يُفصَح عنه صراحة، لكنه ظل يمور تحت السطح على مدى سنوات. إنه الانقسام بين النساء اللاتي يكتبن عن النسوية ويتحدثن عنها والنساء اللاتي يعشنها، النساء اللاتي لديهن صوت مقابل النساء اللاتي لديهن التجربة، بين اللاتي يقمن بإعداد النظريات والسياسات واللاتي يحملن ندوباً وقُطُوباً جراء الصراع. وعلى الرغم من أن مصدر هذا الانقسام ليس عرقيّاً دائماً، فالحقيقة، بوجه عام، أن النساء اللاتي يحصلن على أجور مقابل الكتابة عن الحركة النسوية، ويقدن المنظمات النسوية، ويضعن السياسات النسوية في العالم الغربي، هنّ من البيضاوات ومن الطبقة الوسطى العليا. هؤلاء هنّ مثقفاتنا، “خبيراتنا”، اللواتي يعرفن أو على الأقل يزعمن أنهن يعرفن ماذا تعني النسوية وكيفية عملها. على المقلب الآخر، هناك النساء الملونات، ونساء الطبقة العاملة، والمهاجرات، والأقليات، ونساء السكان الأصليين، والنساء المتحولات، والمقيمات في الملاجئ – كثير منهن يعشن الحياة النسوية لكن نادراً ما يتسنى لهن الكلام أو الكتابة عنها. ثمة افتراض مبهم في أن النساء القويات بحق، النسويات “الحقيقيات”، هؤلاء اللاتي تربين على أيدي نسويات بيضاوات أخريات، لا يقعن فريسة حالات إساءة المعاملة.
لا شك أنهن يقعن فريسة ذلك. لكن تضافر عديد من العوامل، أهمها إمكانية حصولهن على الموارد، يفضي إلى عدم اضطرارهن إلى الذهاب إلى الملاجئ أو الحاجة إلى موارد عامة. بالمقابل، يتعين على النساء الملونات، وهن في أغلب الأحيان مهاجرات وفقيرات، أن يطلبن المساعدة من الغرباء ومن الدولة، فهن المحتاجات والمستضعفات بالتأكيد. إنه وضع معقد، لكنه يعزز صورة النسويات البيضاوات بوصفهن منقِذات والنساء الملونات بوصفهن منقَذات ويحافظ عليها.
وهكذا، تتغلغل مخاوف مبهمة من الصدمات المعيشة داخل النسوية البيضاء، وهذا بدوره يؤدي إلى شعور بالنفور وعدم الراحة من النساء اللاتي مررن بها. لطالما شعرت بذلك لكنني لم أتمكن إلا أخيراً من ربطه بالافتراضات الاجتماعية الضمنية حول من يتعرض للصدمة. فمن خلال إبراز معاناة النساء السمراوات والسوداوات والآسيويات من الرَّض النفسي بوصفه “أمراً عاديّاً”، وأن مظلومياتهن تنبع من ثقافتهن، وتصوير معاناة البيضاوات بوصفها حالات شاذة، أخطاء فردية، تؤكد الثقافة البيضاء، بما في ذلك الحركة النسوية التي انبثقت منها، نفسها بوصفها متفوقة.
لهذا السبب شقَّ عليَّ الاعتراف بالصعوبات التي كابدتها. أعلم أن الاعتراف بكوني واحدة من هؤلاء “الأخريات” غير البيض -وخاصة التعريف بنفسي على أنني قاسيت بعض الوقت، وعشت في خوف على حياتي، وانتقلت من ملجأ إلى ملجأ، حاملة ندوب تلك الصدمة- سيكسبني مديحاً آنيّاً من النساء البيض. إذ سيقلن، في تلك اللحظة، ما هو ملائم، ويعجبن بشجاعتي، ويطرحن أسئلة حول ماهية الاختباء من الرجل المسيء، وما ينطوي عليه أمر أن تكون المرأة أمّاً عزباء. لكن حيازتي لهذه الهوية المرفوضة ستتيح لهن أيضاً الحط من قدراتي العقلية إلى ما دون النساء اللاتي يقمن بالعمل الحقيقي للنسوية، ويرسمن حدودها ومعاييرها الفكرية والسياسية. في نظرهن، تناضل النسويات “الحقيقيات” من أجل القضية في المجال العام، دون أن يعيقهن عبء التجربة القاسية المتقلقل.
ما أشعر به في تلك اللحظات ليس متلازمة الدجال. فأنا أعرف أنني كابدت أموراً أكثر من رفيقاتي في تلك الليلة، وتخطيتها. لكنني أعلم أيضاً أن عالم هؤلاء الرفيقات ينقسم إلى نساء ملونات لديهن “قصص” يروينها (أو تُروَى بالنيابة عنهن) ونساء بيضاوات يتمتعن بالسلطة ومنظور نسوي متأصل. هنا تكمن الميكانيكيات والرافعات والبكرات عن كيفية تباين تجارب النساء السمراوات والسوداوات والآسيويات، والتي صنفتها النسويات البيضاوات في أذهانهن تحت عنوان “لا تنطبق عليَّ”.
وهنا أيضاً يمارس “التماهي” طغيانه الثقافي، مستخدماً لغة التفضيل الشخصي لتبرير قصور الخيال الأبيض الجمعي وجموده. تمتلئ الأقسام الأكاديمية، ودور النشر، وغرف الأخبار، ومجالس إدارة المنظمات غير الحكومية الدولية القوية، ووكالات الحقوق المدنية في العالم الغربي بالنساء البيضاوات من الطبقة الوسطى. ولكي يرحب بي في مساحات السلطة هذه، لا بد أن “أحاكيهن”، أن “أكون على مقاسهن”. وإذا كانت المساحات بيضاء ومن الطبقة الوسطى (وهي كذلك)، فيجب أن أكون معروفة بإنسانيتي على وجه التحديد بالنسبة إلى البيض وأبناء الطبقة الوسطى.
على المستوى السطحي، يمكنني أن أظهر هذا التقارب من خلال الإشارة إلى الصحوة النسوية النشيطة في الجامعة، وحوادث المواعدة المؤسفة على التطبيقات المختلفة، والتفاصيل المختارة عن الحياة الحضرية الثرية، وإلى المثابرة على روتين العناية بالبشرة. كما يمكنني إظهاره من خلال عدم ذكر أنواع التجارب التي تعتقد البيضاوات أنها لا تنطبق عليهن – على سبيل المثال، أنواع معينة من العنف المنزلي، أنواع معينة من الهجرة، وأنواع معينة من الصراعات الداخلية.
يعزز تقديس التماهي إغفال أنواع معينة من التجارب الحياتية من التسلسل الهرمي للسلطة النسوية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب واسعة النطاق على الفكر النسوي وممارسته. العديد من المؤسسات المشاركة في صنع السياسات النسوية لا تكتفي برفض اعتبار التجربة الشخصية للمرشحات من النساء الملونات منظوراً مفيداً لنقلها، بل في الواقع، يتم التعامل مع هذه التجربة كعقبة أمام المرشحات، تحت زعم أو خوف من أن هؤلاء المرشحات سيكن “أقل موضوعية” بسبب تجاربهن الشخصية تلك. خلال السنوات الست التي قضيتها في مجلس إدارة منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، لم أرَ قط أيّاً من سجينات الرأي الكثيرات اللواتي سلطت المنظمة الضوء على حالاتهن يُدعين إلى المشاركة في المناقشات السياسية أو يرشحن لعضوية المجلس. حتى الملجأ الذي عملت فيه كانت لديه قاعدة تمنع المقيمات فيه من التطوع أو العمل مدة طويلة فيه.
تكمن كذبة التماهي الكبرى في الزعم بأن هناك منظوراً حياديّاً حقيقيّاً، ومنطلقاً أساسيّاً واحداً، يقاس كل شيء آخر على أساسه. التماهي هو الشخصنة في لبوس الموضوعية. السؤال الذي لا يفترض بنا طرحه عندما نواجه “مشكلة” عدم القدرة على التماهي الكافي، نتماهى مع من؟ وهكذا غالباً ما تُسرد قصص النساء الملونات لكن المنظور الذي يُكتسب من عيش هذه القصص لا يصبح أبداً جزءاً من نظرية المعرفة النسوية.
ليس الانقسام الوظيفي بين الخبرة والتجربة وليد الصدفة قطعاً. إذ بنت العديد من النسويات البيضاوات مسارات مهنية ناجحة في النقد والسياسة على أساس الخبرة المنهجية، ومراكمة المؤهلات، وإجراء البحوث، والنشر في المجلات والكتب. طالبن بحقهن في مساحات مهنية يمكن من خلالها بناء الأفكار وتفكيكها. وعلى اعتبار أن الوصول إلى الفرص التعليمية والمهنية يوزع على نحو غير متكافئ لصالح البيض، يصبح هذا التركيز على الخبرة نوعاً من حراسة بوابات السلطة التي تعزل الملونات، فضلاً عن نساء الطبقة العاملة، والمهاجرات، والعديدات من المجموعات الأخرى. إذاً، يعتبر إدخال نوع مختلف من السلطة إلى هذه المساحة، المؤسسة على تجارب معيشية قد لا تشاركها تلك “الخبيرات”، تهديداً لمشروعية مساهمتهن في حقوق المرأة – كما لو أن الفكر النسوي وممارسته العملية لعبة محصلتها صفر، حيث يحل أحد أنواع المعرفة محل الآخر.
يؤدي هذا القلق بشأن تحدي أولوية الخبرة، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحدي البياض وتفرده بالسلطة، إلى نوع معين من الحسابات العنصرية. فإذا ما اقترنت تجربة أو خاصية ما بمجموعة غير بيضاء، تصنف تلقائيّاً بوصفها عديمة القيمة، وبالتالي تصبح المرتبطات بهذه التجربة لا قيمة لهن. هذه هي الطريقة التي تحمي بها الهيمنة نفسها: قمع الاختلاف ومعاقبته بتجريده من شرعيته. تقع هذه الأنواع من الأحكام القيمية المتعمدة في جوهر التفوق الأبيض. وهذه هي الطريقة التي يعمل بها التفوق الأبيض داخل الحركة النسوية، حيث تضمن نساء الطبقة الوسطى العليا البيضاوات اللاتي يتربعن على عرش الهرم أن تبقى مؤهلاتهن هي المعايير الأكثر قيمة داخل الحركة النسوية نفسها.
شعرت وأنا جالسة في حانة النبيذ، ومدركة لكل هذا، بنيران غضبي تضطرم من اضطراري إلى “الحفاظ على مزاجي مرِحاً”، لكي ألبي توقعات نساء غير معتادات على كل الأشياء المخيبة بالنسبة إلى نساء مثلي. لكن صوتاً في أعماقي أصرَّ قائلاً: “لقد قطعت شوطاً طويلاً”. أعرف بالضبط ما يعنيه ذلك: أريد أن يكون لي صوت بطريقة نادراً ما تحصل عليها مثيلاتي من النساء، الأمهات العَزْباوات، والعرائس المهاجرات، والناجيات من سوء المعاملة، والنساء اللاتي ليست لديهن شبكات أمان أو علاقات أو شهادات جامعية عُليا. وأنا على وشك الحصول عليه، أقول لنفسي: أنا على وشك الوصول. إنه الفرق فحسب بين أن أكون فخورة بحقيقتي أو أن أفرض رقابة عليها.
اخترت الخيار الثاني. فأخبرتهن بمرح: “أوه، لقد تزوجت في سن صغيرة وأتيت إلى الجامعة في الولايات المتحدة، واتضح لاحقاً أنه إنسان حقير”، برمت عينيَّ، وتابعت: “فطلقته ولم ألتفت إلى الوراء أبداً”. إنها الكمية المناسبة من المعلومات فحسب. “هنيئاً لك!”، هتفت إحداهن. “واو، أنا لم أتزوج مرة واحدة حتى الآن وأنت مطلقة!”، ضحكت أخرى تجلس عند نهاية الطاولة. واستمر الحديث بسلاسة. عندما جاءت فاتورة أباريق السانجريا الثلاثة، قسمت بالتساوي بيننا جميعاً. دفعت حصة كاملة، على الرغم من أنني شربت علبة كوكا كولا واحدة. لكن من سيأبه لملاحظة ذلك.
*
في السردية المتعلقة بالجندر وحده التي هيمنت على الحركة النسوية السائدة، يتم تحريض جميع النساء ضد جميع الرجال، أي ضد من يسعون إلى المساواة معهم. لكن، في هذا الصراع، أعطت النساء البيضاوات لأنفسهن الحق في التحدث نيابة عن جميع النساء، يسمحن من حين إلى آخر للنساء الملونات بالتحدث لكن فقط عندما يفعلنها بأسلوب النساء البيضاوات ولغتهن، ويتبنين أولويات البياض وقضاياه وذرائعه. لكن الافتراض بأن النساء الملونات والنساء البيضاوات يواجهن نفس الأضرار إزاء الرجال فهو افتراض خاطئ. إذ تتمتع جميع النساء البيضاوات بالامتياز العرقي الأبيض. لا تتأثر النساء الملونات بعدم المساواة الجندرية فحسب، بل وأيضاً بعدم المساواة العرقية. هكذا، تفرض النسوية اللاعرقية كلفة هوياتية على النساء الملونات، ما يؤدي إلى استئصال جزء أساسي من تجربتهن الحياتية وواقعهن السياسي. وهذا ما يجعل من المستحيل رؤية الطرق التي لا تخدم بها النسوية المتمحورة حول البيض احتياجاتهن.
أثناء نشأتي في باكستان، رأيت والدتي وجدتي وخالاتي يتحملن معاناة رهيبة من جميع الأنواع. تحملن الهجرات، وخسائر الأعمال التجارية المدمرة، والأزواج غير الأكفاء، وخسارة العلاقات، والتمييز القانوني، وأكثر من ذلك بكثير، دون أن يستسلمن لليأس أبداً، ودون أن يتخلين إطلاقاً عن أولئك الذين اعتمدوا عليهن، ودون أن يفشلن أبداً في فرض حضورهن. إن شكيمتهن، وحسهن بالمسؤولية، وتعاطفهن، وقدرتهن على الأمل، هي أيضاً من الصفات النسوية، لكنها لا تندرج في الصفات التي تجيزها حسابات النسوية الحالية. ففي نظام قيم النسوية البيضاء، يُنظر إلى التمرد، وليس الشكيمة، على أنه الفضيلة النسوية المثالية، وبالتالي، فإن قدرة أسلافي من الأمهات على التحمل توصف بأنها دافع ما قبل نسوي، ومضلل، وغير مستنير، وغير قادر على إحداث التغيير. لا يمكن للنسويات الباكستانيات أن يحظين باهتمام ما لم يفعلن شيئاً يسهُل التعرف عليه في مجال الخبرة النسوية البيضاء – أن يركبن على لوح التزلج بحجابهن، أو يسرن حاملات اللافتات، أو يكتبن كتاباً عن الجنس، أو يهربن إلى الغرب. ضاعت حقيقة أن الشكيمة قد تكون صفة نسوية بقدر التمرد في قصة النسوية التي كتبتها واحتلتها بالكامل النساء البيضاوات.
وهذا أيضاً يعود إلى إرث التفوق الأبيض: لم تُفصل النظرة البيضاء إطلاقاً عن الحركة النسوية نفسها. بل أصبحت النوع الوحيد للنسوية الذي نعرفه أو نملك لغة له حتى. وهذا يعني أنه في معظم الأوقات عندما تتحدث النساء عن “النسوية”، ينتحلن غير متعمدات لون البياض وإيقاعه.
أدين في تحليلي بكثير لعمل المنظِّرة السياسية غاياتري تشاكرا فورتي سبيفاك، التي أشارت مقالتها الرائدة “هل يستطيع التابع أن يتكلم؟”، أولاً إلى الكيفية التي يفترض بها الأوروبيون أنهم يعرفون الآخر، ويضعونه في سياق المضطهَد. وشكّل تعليق سبيفاك الشهير، “الرجال البيض ينقذون النساء السمراوات من الرجال السمر” الإطار النظري الذي دعم هذا الكتاب بشكل كبير. لقد أوضحت سبيفاك أن التابع لا يستطيع الكلام، أما أنا فمعنية بالإشارة إلى كيف يُمنح التابع الآن بعض الفرص للكلام، لكن لا يُسمع، لأن أسس التفوق الأبيض (الذي يمثله الاستعمار والاستعمار الجديد بشكل أفضل) لم تُفكَّك. لكن بخلاف عمل سبيفاك، فهذا ليس كتاباً عن النظرية النسوية، بل عن الممارسة النسوية وسلالاتها الإشكالية، مشاكل الماضي والأشكال الجديدة التي اتخذتها في حاضرنا.
ما زالت النسويات في كل مكان يرتبطن بسلالة النسويات البيضاوات ونظريتهن المعرفية نتيجة عدم القدرة على فصل البياض عن أجندة الحركة النسوية. تتعلم تلميذات المدارس السوداوات عن سوزان ب. أنتوني، ويتشربن من دون علم تبجيل امرأة، قالت لفريدريك دوغلاس، وقد أزعجها التقدم المحرز في التعديل الخامس عشر: “سأقطع ذراعي اليمنى قبل أن أعمل أو أطالب ببطاقة الاقتراع للزنجي وليس المرأة”. النسويات الجنوب آسيويات، اللاتي يعشقن بطلات جين أوستن بوصفهن نماذج للقوة، والذكاء، والتقدير، يتشربن أيضاً وجهات نظر أوستن الإمبريالية، ومبرراتها لاستيلاء المستعمرين البيض على الأراضي دون معرفة أصيلة. في حالات لا حصر لها مثل هذه، يجعل تقديم النسوية البيضاء غير النقدي، بوصفها النسوية النهائية والوحيدة، النساء الملونات يعتمدن منطق التبرير لا شعوريّاً.
ثمة ترياقان لعلاج هذا.
الأول، يجب علينا استئصال التفوق الأبيض من داخل الحركة النسوية. لا بد من إعادة ملء المساحة غير المتناسبة التي احتلها البياض داخلها، والإيحاء الضمني بأن هذا الخلل يعود إلى أن النساء البيضاوات وحدهن نسويات فعليّاً، من خلال روايات قوية عن الحركات النسوية الأخرى: تلك التي قمعتها أو أخرستها قوة الهيمنة الاستعمارية والبياض، وتلك التي حجبها التفوق الأبيض في الماضي والحاضر.
الثاني، بما إن السياسة تولّدها التجربة، فيجب إعادة معايرتهما في المفردات الضرورية للحركة النسوية. إن إسقاط تجارب النساء السوداوات والسمراوات والآسيويات يعني إسقاط سياساتهن، كما يجب إعادة تقييم كلتيهما بصورة عاجلة بوصفهما جزءاً لا يتجزأ من العمل النسوي. من أجل إيضاح تجربتهن، يجب أن تعمل النسويات بمختلف أنواعهن على تطوير سلالاتهن الخاصة، وتناول النساء في حياتهن وفي تاريخهن، اللاتي لا يعتبرن “نسويات” لأنهن لا يعكسن مشاريع النساء البيضاوات وأولوياتهن. شرعت في هذا العمل العديد من الكاتبات الملتزمات بسرد قصص النساء الملونات. إن التعبير عن التجارب وتوثيقها أمر قيم في حد ذاته، عملية حيوية للتأكيد والتضامن الجماعي. لكنها أيضاً حافز لتنشيط الحياة السياسية، بحيث تتجاوز إستراتيجيات وأهداف الحركة النسوية مصالح البيض والطبقة الوسطى لاستقطاب جميع النساء اللاتي قصصهن وسياساتهن غير منظورة في الوقت الحاضر، واللواتي أصبحت احتياجاتهن أشد إلحاحاً، بعد أن حرمن منها على نحو ممنهج وأهملت لعدة قرون. علاوة على ذلك، يعتبر توثيق التجربة قيماً بوصفه تأكيداً للإنسانية والتضامن والتجربة الجماعية، وهي أنواع مهمة من الرعاية الذاتية للنساء الملونات وغيرهن من النساء المهمَّشات.
ستكون قصة النسوية الجديدة مختلفة عن تلك التي نعرفها اليوم. لا يكفي وجود روايات بديلة عن النساء الملونات بحد ذاتها، يجب أن تؤثر فعليّاً في محتوى ومسار الحركة من أجل المساواة الجندرية. وقبل أن يحدث هذا، يجب أن تعي النساء البيض كم أثَّر الامتياز الأبيض في الحركات النسوية وما زال يؤثر في أجندة الحركة النسوية اليوم. ليست هذه اقتراحات جديدة، لكن لطالما قوبلت بالتجاهل بإصرار يثير القلق.
سئمت من التظاهر بالاندماج، تماماً مثلما تتشبث النسويات البيض في السلطة بمخاوفهن، وفلاترهن، والطرق الماكرة وغير الماكرة التي يتبعنها في معايير الإدراج والاستبعاد. أريد أن أكون قادرة على الاجتماع في حانة وإجراء محادثة صادقة حول التغيير، حول التحول، حول كيف يمكننا الإطاحة بنظام فاشل وبناء آخر جديد وأفضل.
مكتبة ومنشورات تكوين
-
دار نشر تأسست عام 2017، مقرها الكويت والعراق، متخصصة في نشر الكتب الأدبية والفكرية تأليفاً وترجمة.
View all posts