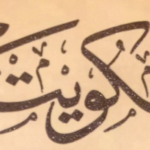جريمة دفن الآثار.. محو ذاكرة بيروت
تدمير وطمس آثار بيروت ومحو ذاكرة شعبها وتهجيره وتحويل هذه القلعة الأثرية إلى شركة خاصة تعتبر جريمة العصر. هذا ما يسميه باحثو التراث والآثار بـ “الهندسة السياسية للذاكرة”.

هذا المقال يناقش التجويع كأداة استعمارية مركبة تُستخدم ضد الفلسطينيين في غزة، لا لضبط الغذاء فحسب بل لإخضاع الوعي والسلوك. بالاعتماد على وثائق رسمية وشهادات ميدانية، يقدم المقال تحليلاً لآثار التجويع على الإدراك والانفعال الجماعي، ويخلص إلى اعتباره جريمة حرب تتطلب مقاومة شاملة واستجابات مستدامة.
مقدمة
منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، والتي اتّخذت طابع حرب إبادة ومحو، تبنّت “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، سياسة التجويع ومنع إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين كأداة من أدوات العقاب الجماعي. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها “إسرائيل” هذه الاستراتيجية؛ فمنذ سيطرت حركة حماس على قطاع غزة في يونيو 2007، فرضت “إسرائيل” حصاراً شاملاً على القطاع، شمل المعابر والحدود، سواء تلك التي تديرها “الحكومة الإسرائيلية”، مثل معبر كرم أبو سالم، ومعبر بيت حانون (إيريز)، أو تلك التي تديرها الحكومة المصرية، مثل معبر رفح. وقد تحكمت “إسرائيل” من خلال هذا الحصار في تدفّق الموارد الحياتية، وبخاصة الغذاء والدواء، بل إن “إسرائيل”، عبر منسق أعمال الحكومة في المناطق، أعدّت عام 2012 وثيقة تُحدّد 2،279 سعرة حرارية يومياً فقط لكل فرد في غزة، لضبط الحد الأدنى للبقاء دون تحسين شروط الحياة، في تجسيد صارخ لإدارة الحياة والموت عبر الحصار.
خلال حرب الابادة والمحو الجارية منذ أكتوبر 2023، أُغلق معبر رفح مراراً، وتعرض للتدمير الجزئي نتيجة القصف الإسرائيلي في 7 مايو 2024، مما أدى إلى تعطل دخول المساعدات الطبية والإنسانية عبره، رغم كونه المنفذ الأساسي للقطاع. وقد تكدست المساعدات عند الجانب المصري من الحدود، في شاحنات ومخازن، يراها السكان دون القدرة على الوصول إليها، في ظل عجز الدولة المصرية عن إدخال تلك المساعدات لأسباب سياسية متعلّقة بالتنسيق الأمني والضغط الدولي.
تشير التقارير الدولية إلى أن 92% من الأطفال بين 6 أشهر وسنتين لا يحصلون، مع أمهاتهم، على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية، مما يعرضهم لمخاطر جسدية ونمائية دائمة. كما ارتفع عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج من سوء التغذية بنسبة 80% في مارس 2024 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وتم توثيق وفاة 57 طفلاً بسبب الجوع ونقص الغذاء، بينما تلقى أكثر من 62 ألف طفل العلاج نتيجة سوء التغذية الحاد خلال الشهرين الماضيين مارس ونيسان 2025.
يُظهر هذا الحصار المركّب — العسكري والسياسي، المقرون بسياسة التجويع — كيف يمكن إدارة الحياة والموت من خلال التحكم في تدفق الموارد، ضمن حرب إبادة ممنهجة نفسية ومعرفية، تستهدف الوجود الفلسطيني.
يدعي الاحتلال الاسرائيلي أن هذه السياسات تهدف إلى تسريع استسلام حركة حماس وتحقيق ما تسميه “النصر المطلق”، من خلال الضغط العسكري وتجويع السكان المدنيين. لكن الواقع يظهر أن التجويع لم يعد مجرد أداة عسكرية أو نتيجة جانبية لحرب إبادة، بل تحول إلى سلاح نفسي واستعماري مركب يستهدف البنية النفسية والمعرفية للإنسان الفلسطيني. تسعى “إسرائيل”، بدعم من حلفائها الغربيين، والأميركيين إلى تضييق الخناق على سكان غزة بهدف إرغامهم على مغادرة القطاع في إطار سياسة تهجير ناعمة.
أولاً: التجويع كسلاح نفسي واستعماري
يُستخدم التجويع في فلسطين كسلاح نفسي واستعماري إحلالي بالغ الفتك، يتجاوز أثره حدود الجسد ليطال الإرادة والعقل الفلسطيني. لا يقتصر هذا العنف على تقليص أو منع وصول الموارد الغذائية، بل يمثل نمطاً من العنف المنظم الذي يسعى إلى إعادة تشكيل الوعي الفلسطيني تحت شروط القهر والعجز والتهديد الوجودي الدائم، بهدف كسر قدرة الأفراد على الصمود والبقاء. في هذا السياق، يتجلى مفهوم فوكو عن “السلطة الحيوية”، إذ تمارس السلطة الاستعمارية الصهيونية تحكماً صارماً في حدود الحياة والموت، من خلال التحكم بتدفق الموارد الأساسية وعلى رأسها الغذاء، عبر الحواجز والمعابر، وتقييد الاستيراد، وتدمير الأراضي الزراعية، واستهداف الصيادين، وحتى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، هكذا، تُحول حياة الفلسطينيين إلى “حياة مُدارة” تعتمد على قرارات السلطة المحتلة، فيُفرض عليهم نمط من الوجود القائم على الهشاشة والاعتمادية، ما يضعف قدرتهم النفسية والمعرفية على المقاومة أو حتى تصور مستقبل مستقل.
في سياق الحرب النفسية من خلال التجويع التي تشنها “إسرائيل” على الفلسطينيين في قطاع غزة، يتحول الجسد الجائع إلى ساحة صراع غير مرئية، يُستخدم فيها التجويع كسلاح صامت لتفكيك الإرادة الفردية والجمعية. فالجوع المزمن لا يقتصر على تدهور الحالة الصحية، بل يؤدي إلى انهيار الوظائف المعرفية مثل التركيز والذاكرة واتخاذ القرار، ما يُضعف الحافز على المقاومة ويُعيد تشكيل الوعي الفلسطيني تحت الضغط القاسي للحياة اليومية.
في ظل هذا الواقع الكارثي، يطفو تساؤل أخلاقي وسياسي جوهري: أين تقف المنظمات الدولية أمام هذه الجريمة المستمرة؟ إن غياب الفعل الحاسم لا يعني بالضرورة تواطؤاً مباشراً، لكنه يكشف عن شكل أخطر من التواطؤ، يتمثل في الصمت، التراخي، والاكتفاء بالتصريحات الرمزية، مما يكرس حالة من القبول الضمني بانتهاك القانون الدولي الإنساني.
طوابير طويلة من الأطفال والنساء يصطفون بانتظار فتات الطعام، إن وُجد، متشبثين بأمل البقاء وسط مخاطر القصف والقتل المستمرة. هذا ليس مجرد نقص في الغذاء؛ إنه جزء من استراتيجية أوسع يستخدم فيها التجويع كسلاح نفسي منهجي. وفي خضم هذه الظروف المروعة، تبرز قصص فردية تدمي القلب وتكشف عمق المأساة، مثل شهادة أحد العاملين في مطعم شمالي غزة. يروي هذا العامل كيف طلبت فتاتان صغيرتان قطعة بيتزا واحدة، هتفتا: “غالية غالية، شو يعني! خلينا نحقق حلمنا وناكل بيتزا قبل ما نموت، محدش عارف”. هذه الكلمات البسيطة ليست مجرد رغبة بريئة في وجبة عادية، بل هي صرخة تكشف واقعاً أصبح فيه أبسط حق من حقوق الحياة حلماً بعيد المنال تحت وطأة الحصار الخانق والقصف المستمر، وتهدف في جوهرها إلى تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وكسر إرادتهم. بعد فترة وجيزة من هذه اللحظة، شهدت غزة قصفاً آخر. وعند العودة إلى المطعم، عُثر على قطعة البيتزا تلك مغمسة بالدماء على الطاولة، لتتحول إلى رمز مأساوي لوجبة أخيرة لم تتحقق. هذه اللحظة، التي كان من المفترض أن تكون مجرد رغبة بسيطة، أصبحت شهادة حية ومؤلمة على العري الإنساني والأخلاقي لحياة الأطفال الفلسطينيين، الذين تُسلب منهم أبسط حقوقهم في الأمان والعيش الكريم. الخطورة الأكبر لا تكمن فقط في الحرمان البيولوجي، بل في البُعد النفسي والمعرفي لهذه الممارسات، فالتجويع يتحول هنا إلى أداة لهدم الكرامة والحقوق.
هذا الواقع لا ينفصل عما يسميه الفيلسوف جورجيو أغامبين “بالحياة العارية”، حيث يُجرد الإنسان من الحماية ويُترك مكشوفاً للموت أو البقاء وفق الشروط التي يفرضها الاحتلال، حيث الحصار المطبق والدمار الهائل وانعدام الأمن المستمر جعلوا من البقاء على قيد الحياة تحدياً يومياً ومستمراً عبر عملية تطهير عرقي صامت من خلال التجويع والموت. إن الهدف من وراء هذه السياسات هو تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
هذه السياسات لا تُخفى أهدافها، فتصريح وزير “الدفاع الإسرائيلي” السابق أفيغدور ليبرمان في العام 2014 إبان حرب “الجرف الصامد” حول “ضرورة فرض معاناة لا تُطاق على سكان غزة” يكشف بوضوح عن النية المبيتة لإخضاع السكان عبر التجويع. وهو ما يلتقي مع مفهوم “السياسة النيكروية” لأشيل مبيمبي، التي ترى في إدارة الموت، ومنه هندسة التجويع، أداة استعمارية لفرض السيطرة وتحقيق الإخضاع والتهجير بقوة الحرمان من الغذاء والماء.
ويمتد هذا التحليل إلى فكر فرانز فانون، الذي يرى في التجويع الاستعماري أداة لسحق الفاعلية السياسية وتحويل الإنسان المستعمَر إلى جسد يلهث خلف البقاء، على حساب كرامته ووعيه. هذا الإخضاع النفسي يُعيد ترتيب أولويات الإنسان، ويُضعف مقاومته، مما يجعل التجويع شكلاً من الحرب الباردة ضد الوعي والذاكرة والمقاومة والبقاء.
ورغم أن القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجرم استخدام الغذاء كسلاح، فإن “إسرائيل” تواصل هذه السياسة في ظل إفلات كامل من العقاب. وفي ضوء ما توثقه التقارير من استشهاد أطفال بسبب الجوع وتهديد مئات الآلاف بسوء تغذية حاد، يتجلى بوضوح أن التجويع في غزة تجاوز حدود كونه مجرد وسيلة ضغط، ليصبح استراتيجية ممنهجة تهدف إلى تفكيك الإنسان الفلسطيني من الداخل، تجريده من قدرته على التفكير والنضال، وإجباره على الاستسلام للهروب الغريزي حفاظاً على حياته وبقائه.
ثانياً: الأثر المعرفي للتجويع والضغط النفسي
لا يقتصر التجويع على تدمير الجسد وإضعاف الإرادة، بل يمتد ليُحدث خللاً جوهرياً في العمليات العقلية العليا، في مقدمتها الذاكرة والتركيز وضبط الانفعالات واتخاذ القرار. فبحسب الدراسات العصبية الحديثة، يؤدي الحرمان الغذائي إلى ارتفاع مزمن في إفراز هرمونات مثل الكورتيزول والغريلين، مما يعطل التوازن الكيميائي الحيوي للدماغ، خصوصاً في الفص الجبهي والحُصين، وهما منطقتان مركزيتان في ضبط الانتباه والسلوك (Morris&Dolan, 2021).
هذا الخلل الإدراكي لا ينتج فقط عن الجوع كعامل بيولوجي، بل عن السياق الذي يُفرض فيه: حالة طوارئ دائمة، فوضى شعورية، وتهديد وجودي مستمر – وهي ليست لحظة استثناء بل نمط حكم استعماري دائم بدأ مع الحصار على قطاع غزة بدأ منذ العام 2007. هذا التأثير المعرفي العميق هو ما يجعل من التجويع أداة لـ “الهندسة الإدراكية- المعرفية”، حيث يُعاد تشكيل وعي السكان وسلوكهم في اتجاهات محددة: يزداد الاندفاع واليأس والقبول القسري للحلول المفروضة مقابل ضمان الحد الأدنى من البقاء. ويعزز هذا ما يصفه أغامبين بـ “نزع الحماية القانونية والمعرفية”، حين لا يُجرد الأفراد من الطعام فحسب، بل من القدرة على إدراك واقعهم ورفضه. وهنا تتحقق السلطة الحيوية الفوكويّة في أعلى أشكالها: سلطة تنزع عن الإنسان أدوات الفهم والرفض، لا الحياة فقط.
تتحول هذه الدينامية المعرفية إلى ما يمكن تسميته بـ “التجويف المعرفي”، حيث تُهدم البُنى العقلية النقدية لدى الأفراد، ويتم دفعهم نحو سلوكيات أولية بحتة تتعلق بالبقاء اللحظي. وكما يؤكد فانون، فإن المستعمَر الجائع لا يُفكر، بل يبحث ويركض ويصرخ ويتشبث بالحياة كيفما كان. ومن هذا المنظور، يصبح الجوع ليس فقط سلاحاً جسدياً، بل أداة سيطرة على الإدراك الجماعي، ما يجعل التجويع الممنهج استراتيجية لخلق “إنسان قابل للتطويع السياسي”، يخضع لا فقط لأنه ضعيف، بل لأنه لم يعد يمتلك الطاقة المعرفية للمقاومة.
ويتجسد هذا الطرح بوضوح في الواقع اليومي لسكان غزة، حيث تشير تقارير ميدانية إلى أن عائلات كاملة باتت تقضي أيامها في طوابير لساعات طويلة من أجل الحصول على وجبة بسيطة، فيما اضطر البعض إلى غلي الأعشاب أو أكل علف الحيوانات، فقط لإسكات الجوع (هيومن رايتس ووتش، 2024). تقول إحدى الأمهات في شهادة وثقتها منظمة الصحة العالمية: “لم أعد أفكر إن كان أطفالي سيتعلمون أو يلعبون. كل ما يشغلني: هل سأتمكن من إطعامهم قبل أن ينهاروا من الجوع؟” WHO), 2024). هذه الشهادة تكشف كيف يُعاد تشكيل وعي الإنسان المحاصر، حيث يُقصى المشروع السياسي والاجتماعي لحساب الانشغال التام بالجسد الجائع، وهو ما يتقاطع مع هدف الاستعمار في تحويل المجتمعات إلى وحدات مشتتة منهكة، غير قادرة على التفكير أو الفعل الجماعي.
ثالثاً: استخدام التجويع والضغط النفسي كسلاح في الحرب: حالة غزة
إن استخدام “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، للتجويع الممنهج في قطاع غزة تجاوز كونه أداة ضغط ظرفي ليُرقى إلى مستوى استراتيجية مُهندسة بعناية تستهدف البنية النفسية والمعرفية للسكان لتحقيق أهداف سياسية محددة. فالحصار الشامل المفروض كما ذكرنا سابقاً منذ عام 2007، والذي منع دخول الغذاء والدواء، يُمثل الركيزة الأساسية لهذه السياسة الممنهجة. ويتجلى ذلك في هذه المرحلة في قصف مستودعات الطعام والمطابخ الجماعية، كما حدث في استهداف مركز توزيع الأونروا في يناير 2024، مما يُدمر قدرة السكان على إعالة أنفسهم ويُقوض أي أمل في توفر مصادر غذائية آمنة (منظمة العفو الدولية، 2024). وعلاوة على ذلك، فإن توزيع المساعدات بطرق مهينة أمام وسائل الإعلام، كما حدث في فبراير 2024 بإلقائها عشوائياً من الجو، لا يُلبي الحاجة الفعلية للغذاء فحسب، بل يُعمق الشعور بالذل والعجز وفقدان الكرامة الإنسانية، مما يُرسخ حالة من الضعف النفسي والاستسلام الداخلي. هذه الحالة الممنهجة من الضغط النفسي والمعرفي تُعد أداة فعالة لدفع السكان نحو فقدان الأمل في البقاء والصمود، والتفكير في الهجرة كخيار اضطراري. ومن بين أبرز أدوات هذا الضغط، تبرز الندرة الشديدة في الغذاء، التي لا تقتصر على نقص المواد الأساسية فقط، بل تمتد إلى غياب القدرة المنتظمة على الحصول على الطعام الكافي والملائم، ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي على مستوى الفرد والأسرة. إن خلق مثل هذه البيئة من العوز الغذائي الحاد يؤدي إلى ما يُعرف بـ”اقتصاد الندرة القسرية” (Forced Scarcity Economy)؛ وهي إستراتيجية تستخدمها قوة الاحتلال (اسرائيل) عمداً كأداة للسيطرة والإخضاع من خلال التلاعب المتعمد بتوزيع الموارد، كما ناقش ذلك Alex de Waal في تحليله لاستخدام المجاعة كسلاح في النزاعات السياسية. في مثل هذه الحالات، يُجبر الأفراد على الدخول في أنماط تنافسية عنيفة من أجل البقاء، مما يفضي إلى تفكك النظام الاجتماعي، وتآكل الثقة المجتمعية، وازدياد الفوضى والعنف الداخلي.
وبالتالي، فإن هندسة التجويع هنا لا تهدف فقط إلى إلحاق الضرر الجسدي، بل إلى تفكيك البنية النفسية والاجتماعية للسكان بهدف تحقيق أهداف سياسية تتمثل في الاستسلام القسري والتهجير الجماعي وزعزعة الاستقرار الداخلي.
يتفق هذا التحليل مع رؤى كل من إيفرت وسيزير حول استخدام التجويع كأداة لإفقاد الهوية واستلاب القدرة على الفعل التاريخي. ففي رواية إيفرت “Erasure”، يبرز التجويع الرمزي كأداة لإضعاف الكرامة والهوية في سياقات الضغط الاجتماعي والسياسي، وهو ما نراه واضحاً في هذه الحالة، حيث يؤدي الحصار الشامل والتجويع المتعمد إلى تدمير القدرة على التفكير المنطقي وصناعة الأمل، مما يعكس التجويع كأداة لتفكيك الهوية الفلسطينية. كما أشار في روايته إلى الهويات المستلبة، والتي نجد صدى لها هنا، حيث يُستهدف الفلسطينيون في غزة ليس فقط من خلال العقاب الجسدي ولكن بتفكيك البنية النفسية لهم، مما يجعلهم أكثر قابلية للتأثر والاستسلام.
أما إيميه سيزير في “خطاب حول الاستعمار”، فيعتبر الجوع جزءاً من استراتيجية الاستعمار الرامية إلى تجريد المستعمَر من إرادته وتحويله إلى موضوع اقتصادي، وهو بالضبط ما يحدث في غزة، حيث يتم تقويض القدرة على التفاعل مع الواقع السياسي أو مقاومته من خلال التجويع المنهجي الذي يُجرد الفلسطينيين من قدرتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية واعية لصالحهم. ففي ظل هذا التجويع، يفتقر الأفراد إلى القدرة على التخطيط والعمل الجماعي، مما يدفعهم إلى الانزلاق في استجابات غريزية للبقاء فقط.
رابعاً: شهادات ميدانية موثقة على الأثر النفسي والمعرفي
تكشف الشهادات الميدانية المروعة من قطاع غزة عن أثر عميق يتجاوز حدود التجويع كحالة طارئة، لتسلط الضوء على توظيف ممنهج لما يمكن وصفه بـ “الهندسة النفسية للتجويع”. ففي هذا السياق، يتحول الجوع إلى نمط قهري مُعاد إنتاجه يومياً، لا يعيد تشكيل تجربة البقاء على المستوى الجسدي فحسب، بل يمتد ليخترق المستويين النفسي والمعرفي بعمق. وكما جاء في شهادة مدرس في الأونروا (9 مارس 2024): “الطلبة لا يستطيعون التركيز، ولا حتى التحدث. الضغط والتجويع دمّرا قدرتهم على التواصل أو الفهم”.
يُسهم هذا النمط القهري من التجويع المُمنهج في تفكيك قدرة الأفراد على التفكير المنطقي واتخاذ القرارات المستقلة، ويضعف قدرتهم على الاستمرار في المقاومة، محولاً سلوكهم تدريجياً إلى ردود فعل غريزية هدفها الوحيد البقاء على قيد الحياة كما أشارت إليه شهادة أم من شمال غزة (الهلال الأحمر الفلسطيني، 18 فبراير 2024): “في الأيام التي لا نجد فيها شيئاً نأكله، أشعر أنني لا أستطيع التفكير، لا في الأطفال، ولا في الهروب من القصف. التجويع يسرق مني عقلي”. هذا التحول ليس مجرد مظهر لمعاناة إنسانية، وهو أمر لا يمكن قبوله أبداً خاصة في ظل الانتشار المخيف لبوادر مجاعة حقيقية، بل هو نتيجة مباشرة لهندسة نفسية ومعرفية حربية خبيثة.
تهدف هذه الهندسة النفسية للتجويع إلى تدمير وحدة الذات وتشتيت القدرة على اتخاذ القرار المستقل عبر الحرمان المتعمد من الغذاء. وتحت وطأة التجويع الشديد، تتراجع بشكل حاد القدرة على التفكير النقدي المعقد، وتبرز حلول واستجابات ذات أنماط بدائية تقتصر على تلبية الحاجة الآنية للبقاء. وكما أشارت إليه شهادة مسعف من الهلال الأحمر (تقرير إعلامي داخلي، 26 يناير 2024): “رأيت أمهات في طوابير توزيع الطعام يفقدن وعيهن من شدة الإهانة والتجويع، ثم يعدن ويقفن من جديد، لأنه لا خيار آخر أمامهن”. وهكذا، يتحول التجويع الممنهج في قطاع غزة إلى سلاح دقيق يُستخدم لخلخلة البنية النفسية والمعرفية للمجتمع الفلسطيني المستهدف، وتقويض قدرته الفردية والجمعية على التعافي الذاتي وإعادة بناء مجتمعه.
إن هذا التكتيك يتجاوز حدود إحداث ضرر جسدي، ليطال النسيج الإنساني ذاته، ويهدف في نهاية المطاف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني بالكامل بهدف إعادة تركيب مكوناته سياسياً واجتماعياً بما يخدم الأجندة الحربية الإسرائيلية – الأميركية في قطاع غزة.
خامساً: التداعيات الأوسع للحصار والتجويع على المجتمع
يتجاوز تأثير الحصار والتجويع الأبعاد الفردية ليطال الأسس الهيكلية للمجتمع. فالتجويع والإرغام على اتخاذ قرارات قهرية لا يؤثر فقط على الأفراد، بل يمتد ليطال النظم الاجتماعية والسياسية. ففي ظل حرب الإبادة والتجويع المستمرة التي تستهدف البلديات والعائلات والعشائر والنظام السياسي، يتعرض البناء الاجتماعي لتدمير شامل (تقارير الأوتشا، 2023-2024). ويُضاف إلى ذلك التحذيرات المستمرة من خطر المجاعة في جميع أنحاء غزة طالما استمرت حرب الإبادة والتجويع وقيود الوصول الإنساني.
فتدمير البنية التحتية الحيوية يُقوض قدرة المجتمع على تنظيم نفسه وتلبية احتياجاته الأساسية، مما يزيد من الاعتماد على المساعدات الخارجية ويُضعف النسيج الاجتماعي. كما أن استهداف العائلات والعشائر يُفاقم أزمة الثقة ويزيد من تدهور الأمن المجتمعي. ويؤدي نقص الموارد إلى صراعات داخلية على الغذاء والمياه، مما يُنذر بتفشي الفوضى وتآكل أواصر التعاون الاجتماعي، كما حدث في مناطق نزاعات أخرى.
سادساً: التحديات التي تواجه الاستجابة المدنية
في ظل الانهيار البنيوي لمؤسسات الحكم المحلي والتفكك المجتمعي الناتج عن النزوح المستمر وتدمير معظم البنى الخدماتية في قطاع غزة، تبرز الحاجة الملحة إلى تفعيل أطر مدنية قاعدية لاستعادة التماسك الأهلي. غير أن هذه المبادرات تواجه عقبات بنيوية حادة، أبرزها الانقسام السياسي الفلسطيني، وتآكل دور مؤسسات الوساطة التقليدية العربية، وتقييد دور وكالة الغوث والهلال الأحمر الفلسطيني (مقابلات داخلية، 2024). ويُضاف إلى ذلك الانتقادات الشديدة الموجهة للخطط “الإسرائيلية” الجديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية، والتي تعتبرها وكالات الإغاثة انتهاكاً للمبادئ الإنسانية الأساسية، ويُفاقم ذلك محاولات خارجية تسعى جاهدة لتقويض السيادة الفلسطينية على المساعدات، مما يعيق كافة الجهود للاستجابة المدنية الشعبية الفاعلة.
في خضم هذا المشهد المعقد من التحديات البنيوية والتدخلات الخارجية، يصبح الافتراض بأن الهندسة النفسية والمعرفية للتجويع تمثل أداة حرب لإعادة تشكيل المجتمع الفلسطيني ليس مجرد احتمال نظري، بل استراتيجية مُمنهجة تستغل حالة الضعف المؤسسي لفرض واقع جديد. هذا التقاطع الحاد بين الانهيار المحلي والقيود على العمل الإنساني يرسخ صورة قاتمة لمستقبل غزة، حيث لا يستهدف التجويع الجسد فحسب، بل يسعى لتفكيك أسس المجتمع وقدرته على التعافي، مما يزيد من خطر التهجير القسري وتأجيج النزاعات الداخلية في ظل الضغوط الهائلة. وأمام هذا التعقيد، يبرز تساؤل محوري حول مستقبل القطاع وقدرة مجتمعه على استعادة تماسكه في مواجهة محاولات إعادة الهندسة القسرية هذه، مما يضع مسؤولية مضاعفة على عاتق المجتمع الدولي لدعم الجهود المدنية القاعدية وضمان وصول المساعدات بشكل كامل، قبل أن يستفحل خطر إعادة تشكيل المجتمع بالكامل وتعميق الانقسامات الداخلية والعنف وتكريس التهجير.
سابعاً: المسؤولية القانونية الدولية
تجاوزت السياسة “الإسرائيلية” في غزة حدود الحصار إلى استغلال ممنهج من خلال هندسة التجويع نفسياً، مما يُحدث آثاراً مستديمة على البنية النفسية والمعرفية للمجتمع. وبموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف، يحظر بشكل قاطع تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وتدمير المواد الغذائية اللازمة لبقائهم (اتفاقيات جنيف، البروتوكول الأول، المادة 54). وقد ترقى هذه الأفعال إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
الخاتمة والتوصيات
في سياق ما يشهده قطاع غزة من تدمير ممنهج للبنية التحتية المؤسساتية واستهداف للأطر المجتمعية، والتخطيط الممنهج لتفكيكها واقصائها، تكتسب أهمية دعم المؤسسات المجتمعية والإنسانية المحلية والجمعيات الوطنية الإنسانية، وفي مقدمتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بعداً استراتيجياً لضمان استمرارية الخدمات الأساسية. وقد برهنت الجمعية، بصفتها مؤسسة وطنية وإنسانية ملتزمة بمبادئ الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر، على قدرتها في مواصلة تقديم الرعاية الصحية الأساسية والدعم النفسي والاجتماعي في ظل أقسى الظروف، بما في ذلك الحروب المتكررة والحصار طويل الأمد. وتعتمد الجمعية في عملها على مبادئ الحياد وعدم التحيّز، وتولي أهمية قصوى لضمان توزيع المساعدات بناءً على الاحتياج الفعلي فقط، دون تأثر بالاعتبارات السياسية أو العسكرية. كما طوّرت نظماً رقابية ومالية فعّالة تضمن الشفافية والمساءلة، ما يعزز من قدرتها على إيصال المساعدات للفئات الأكثر تهميشاً بكفاءة ونزاهة، في بيئة تتسم بتحديات هيكلية وأمنية متفاقمة.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، يُقترح أيضاً دعم المؤسسات المجتمعية الإنسانية من خلال توفير آلية رقابة محلية مستقلة يُشارك فيها ممثلون من كلا الجنسين، بهدف الإشراف على عمليات التوزيع وضمان عدالتها. كما تبرز الحاجة إلى تعزيز أنماط العمل المدني الشعبي (مثل الحارات والمناطق) التي تستجيب بشكل مباشر للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وهو ما يتطلب دعم هذه المبادرات وتطوير قدراتها من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازم، لتمكينها من أداء دور الوسيط المجتمعي بفعالية. وفي هذا الإطار، تكتسب المنظمات النسوية الفلسطينية أهمية خاصة، لما تمتلكه من خبرة تراكمية في مجالَي العمل الإنساني والمجتمعي، وقدرتها على الوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة. وعلى صعيد موازٍ، لا يمكن إغفال أن استخدام التجويع والتلاعب النفسي والضغط النفسي كسلاح حرب يشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، ويستدعي المساءلة القانونية للمسؤولين عن هذه الممارسات. ويستوجب ذلك تحركاً فورياً من المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين وتأمين تدفق كافٍ ومستمر للمساعدات الإنسانية. كما يجب تجاوز منطق الاستجابة الطارئة القائم على الإطعام المؤقت، والعمل باتجاه دعم مبادرات الزراعة المحلية وتعزيز إنتاج الغذاء، بما يسهم في تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي والاستدامة الاقتصادية على المدى البعيد.
نشير إلى الجهود والمبادرات التي يبذلها أفراد المجتمع ومنظماته المحلية لمعالجة الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية في ظل الظروف الصعبة، مثل توفير الغذاء والدعم النفسي وتنظيم المساعدات. في سياق المقال، يُنظر إلى هذه الاستجابات على أنها ضرورية لمواجهة آثار التجويع الممنهج.



تدمير وطمس آثار بيروت ومحو ذاكرة شعبها وتهجيره وتحويل هذه القلعة الأثرية إلى شركة خاصة تعتبر جريمة العصر. هذا ما يسميه باحثو التراث والآثار بـ “الهندسة السياسية للذاكرة”.

لم يعد النضال الفلسطيني اليوم محصوراً في الجغرافيا، ولا مقيداً بحدود المكان أو أدوات المواجهة التقليدية. لقد أفرزت التحولات الرقمية جيلاً جديداً من الفاعلين السياسيين،

القوة الاقتصادية والسياسية المتنامية لدول الجنوب العالمي تجعل الفضاء الإعلامي العالمي متعدد الأوجه بشكل متزايد. لقد ولّى عهد الدول الغربية التي كانت قادرة على تضليل الرأي العام العالمي دون عقاب

مواجهة محاولات القوى الأجنبية لإضعاف الهوية الوطنية تتطلب تكامل جميع الأدوات الوطنية، بدءاً من التوعية والتعليم، مروراً بالحفاظ على الثقافة والاستقلال الاقتصادي، وصولاً إلى صيانة القرار السياسي