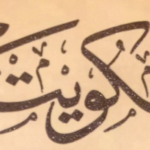في مواجهة مشروع «قانون يادان» الهادف لتوسيع تعريف مكافحة السامية ومعاداتها في فرنسا
بينما أسهم النضال ضد الإبادة الجماعية في فلسطين في بلورة جيل جديد من المناضلين المناهضين للإمبريالية والصهيونية، يسعى أنصار الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض تجريم معاداة

يشهد الوضع العام في لبنان مزيداً من الأزمات والتعقيدات الخطيرة المترابطة مع تطورات المنطقة، ومع محاولات استكمال السيطرة الإمبريالية على الإقليم في إطار مشروع “الشرق الأوسط الجديد”، الذي تَرسم خرائطه الجديدة الولايات المتحدة الأميركية ويقوم بتنفيذه الكيان الصهيوني، في سياق إعادة الاعتبار لوظيفة هذا الكيان التي اهتزت بفعل المقاومة، خاصة بعد عملية “طوفان الأقصى”.
ويمكن الجزم بأن المشاريع الإقليمية التي يُمكن أن تُهدد، ولو حتى في المستقبل، المشروع الأميركي – الصهيوني، هي عرضة للاستهداف، ما لم تخضع دولها لسقف ما تخططه واشنطن وما تنفذه تل أبيب.
وبالتالي، تستمر، بشكل أو بآخر، الحرب المتنقلة المفتوحة لتحقيق الأطماع التوسعية في الأرض والثروات، في محاولة تصفية القضية الفلسطينيّة وإسقاط أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، حتى وفق “حل الدولتين”، بدليل استمرار حرب الإبادة الجماعية والمجازر والدمار في غزة، و”تهويد” الضفة وتقطيع أوصالها، وصولاً إلى قرار “الكنيست” الأخير بضمها، وفي العدوان المستمر على لبنان، وفي تفتيت وإخضاع سوريا، والإمعان في ضرب اليمن، وفي الاستفراد بقوى “محور المقاومة”، كل على حدة، وفي إسقاط ما قيل عن “وحدة الساحات”، وصولاً إلى إيران.
وترجع أهم أسباب هذا التوحش العدواني إلى التلازم بين أزمة الرأسمالية النيوليبرالية ومركزها الرئيسي الولايات المتحدة الأميركية التي تعبر اليوم عن يمينيتها المتطرفة وشعبويتها في مجيء ترامب إلى رئاستها، وهو الذي يدعي وقف الحروب بالقول، في حين يعمل على تأجيجها عسكرياً واقتصادياً وتجارياً، وبين الطبيعة العنصرية والمطامع التوسعية للكيان الصهيوني الغاصب.
وفي خضم ما يجري على صعيد المنطقة، حيث نعيش مرحلة انتقالية بالغة الخطورة على جميع الصعد، لم نشهد مثيلاً لها منذ “سايكس – بيكو”، فإن الوضع اللبناني لا يخرج عن هذا السياق، خاصة بعد الحرب العدوانية الصهيونية المغطاة أميركياً والتي لا تزال وتيرتها مستمرة، بشكل أو بآخر.
فالعدوان على لبنان يستمر عبر التصعيد العسكري شبه اليومي الذي تنفذه “إسرائيل” في الجنوب والبقاع والضاحية وعدد من المناطق، من خلال القصف الجوي وتدمير أماكن سكنية وما تدعيه من ضرب منشآت ومواقع واستهداف مقاومين، إضافة إلى إستمرار إحتلال عدد من المواقع والنقاط الحدودية، ومحاولات التقدّم ضمن الأراضي اللبنانية، بما يُشكل إنتهاكاً سافراً لاتفاق “وقف الأعمال العدائية”. وتشير الخروقات “الإسرائيلية” الميدانية التي تتم بغطاء أميركي، وفي ظل صمت وتواطؤ ما سمّيَ بلجنة “المراقبة والتنفيذ” التي تترأسها الولايات المتحدة، وهي المنحازة والداعمة للعدو الصهيوني، إلى محاولة جعل التوافقات التي صاغتها “إسرائيل” مع واشنطن، أمراً واقعاً.
ومع العدوان العسكري، يستمر الضغط السياسي المشبع بالتهديدات المتعددة باتجاه ما يسمّى بـ “نزع السلاح” ومعه الضغط الاقتصادي والاجتماعي الذي تمارسه الإدارة الأميركية و”حلفاؤها” بحجة عدم تنفيذ ما يسمّى بـ”الإصلاحات”، بما يعني، وفق هذه الضغوطات، أنه لا إعمار ولا عودة للنازحين في الجنوب ولا عون مالي، بل استمرار للاحتلال وللاعتداءات.
المشروع الأميركي: خلق الانقسامات والصدامات في المنطقة
إن العدو الصهيوني، الذي لا يحتاج إلى ذرائع في نهجه العدواني والتوسعي منذ تأسيس كيانه العنصري حتى اليوم يوصل رسائله، عبر التصعيد والقصف وتشريد المدنيين، أو عبر تبني الإدارة الأميركية لمطالبه وشروطه، والدفع لفرضها على لبنان، بإستخدام وسائل الضغط الدبلوماسي، وسواها، دون أدنى مراعاة للموقف الرسمي اللبناني الذي يتبنى فكرة “حصرية السلاح”، ويخضع للضغوط في هذا المجال، لكنه يرى أن “حل الموضوع” يتطلب حواراً داخلياً، وأن مسار التفاوض، بالنسبة للسلطة اللبنانية يبدأ من إنسحاب “إسرائيل” من التلال الخمس وتطبيق الإتفاق والقرار 1701 بالتزامن مع “نزع السلاح”، فيما يرى العدو الصهيوني، ومعه “الراعي” الأميركي، وبعض الأصوات الداخلية أن لا تقدم بموضوع “سحب السلاح” وأن “حزب الله” يماطل ويكسب الوقت لإعادة بنيته العسكرية المقاومة للإحتلال، علماً أن الموقف المعلن من أمينه العام يطرح أولوية تنفيذ الإتفاق الأول قبل الشروع بإجراء اتفاق جديد، بما يشمل الانسحاب وإعادة الإعمار والعودة والضمانات، أما موضوع السلاح فهو قضية داخلية تُحل في إطار الإستراتيجية الدفاعية والأمن الوطني.
وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى ما يعمل عليه المشروع الأميركي في المنطقة من خلق الانقسامات والصدامات ذات الطابع الطائفي التي تتمدد في المحافظات السورية من اللاذقية والساحل إلى حمص ودمشق والتي وصلت إلى ذروتها في السويداء، والتي تولد المزيد من المخاوف من توسيع رقعة الاقتتال والتفجيرات الأمنية التي قد يكون لها انعكاساتها السلبية على الوضع في لبنان، وبالتالي فإن الضغط سيكون من اتجاهين جنوباً عبر “إسرائيل” وشمالاً وشرقاً عبر سوريا.
فالعلاقات اللبنانية – السورية تمر بتوتر متصاعد، وتثار عدة قضايا مثل ملف “المساجين والموقوفين الإسلاميين” ومسألة النازحين السابقين والنازحين “الجدد”، وموضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية بما يشمل المسألة المتعلقة بلبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، إضافة إلى قضية “الودائع السورية” في المصارف اللبنانية، والتهريب وسوى ذلك.. وقد بدأت ملامح الضغوط بالظهور، من خلال التضييق على حركة المعابر الحدودية، والحديث عن حشودات قتالية، إضافة إلى تجميد التفاوض حول الملفات العالقة. ولا يمكن عزل كل ذلك عن أولويات الإدارة الأميركية في تركيزها على السيطرة على سوريا موحدة أو مفتتة، كما تريد “إسرائيل”، أما لبنان فيتم الضغط عليه وإطلاق التهديدات من كل الإتجاهات وبمختلف الأشكال بما فيها دفعه للالتحاق بسوريا، في إطار تسارع خطوات التطبيع بين الحكم السوري الجديد والكيان الصهيوني.
كما تصل الضغوط إلى الموضوع المتعلق بقوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني، حيث يجري التهديد بسحبها، مع إعلان “إسرائيل” عن موقفها الرافض للتجديد لقوات “اليونيفيل”، وإعلان الإدارة الأميركية أنها تدرس وقف دعمها لها، بما يؤدي إلى خلق فراغ أمني يستفيد منه العدو الصهيوني.
ويتبدى الضغط أيضاً في الجانب المالي من خلال فرض عقوبات على أشخاص معينين، بحجة تجفيف الموارد المالية للمقاومة، والتضييق على الحوالات المالية لبعض المهاجرين، ومن ثم حظر مصرف لبنان التعامل مع مؤسسة “القرض الحسن” من قبل المصارف والمؤسسات المالية.
رسائل زيارات برّاك المكوكية
وتتمثل الحلقة الأخيرة من “المسلسل الأميركي” في الزيارات المكوكية التي يقوم بها الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك إلى المنطقة (سوريا ولبنان)، وما يرشح عنها من ضغوط إضافية لجهة وضع مهل زمنية لـ “نزع السلاح” واستعجال “الإصلاحات” وسوى ذلك، وهذه الزيارات تُشكل محطة مفصلية خطيرة على طريق تنفيذ المشروع الأميركي – الصهيوني في المنطقة، وتهدف إلى تحقيق إنجاز سياسي سريع لرئيسه في لبنان وسوريا وفق مشروع “الشرق الأوسط الجديد”. وتندرج المهلة الأميركية المعطاة للبنان في سياق مهل مشابهة لفلسطين وإيران (60 يوماً).
إن إختيار برّاك لا يعكس إستمرار الضغط الأميركي على لبنان وسوريا بوصفهما الدولتين الوحيدتين على حدود فلسطين المحتلة اللتين لم توقعا إتفاقيات تطبيع فحسب، بل كما يتبين هو لتصعيد العدوان والدفع بخيار التقسيم ورسم خرائط جديدة كمقدمة للتطبيع عبر الإحتلال والضم والإلحاق وخلق الفتن الطائفية والمذهبية في البلدين وما بينهما، من أجل تقسيم أو تفتيت سوريا وتسريع توقيع اتفاق التطبيع السوري – “الإسرائيلي”، وحسم موضوع تسليم سلاح “حزب الله” في لبنان، والتحكم بتحديد موقع تركيا دوراً ونفوذاً في سوريا والإقليم. وهذا الضغط المتزايد يعكس حاجة ترامب الملحة لتحقيق إنجازات سريعة، وللاستثمار السياسي بعد العدوان على إيران، بعد أن تبين له أن ملفات التفاوض الأخرى دونها عقبات قد يصعب تجاوزها بالسرعة المطلوبة.
وقد تضمنت ورقة برّاك الأولى طلب أجوبة واضحة من الحكومة اللبنانية، حول قرارها بنزع سلاح “حزب الله” وفق روزنامة زمنية محددة، كما جاءت تصريحاته محكومة بسياسة استخدام “العصا والجزرة”، حسب تعبيره.
السلطة اللبنانية لم تعرض الورقة لا على الحكومة ولا على مجلس النواب، ولم يُنشر مضمونها رسمياً، كما لم يُكشف عن الرد عليها، رغم أن الشعب هو من يدفع ثمن القرارات والتسويات، وما عُرف عن المفاوضات إقتصر على تسريبات وتحليلات إعلامية.
وقد تبين أن الرد اللبناني اقتصر على ورقة موحدة من قبل الرؤساء الثلاثة تضمنت مجموعة أفكار تتمحور حول التمرحل والتزامن بتنفيذ “إسرائيل” للاتفاق الأول مع تسليم السلاح وتنفيذ الإصلاحات.
ومع وصول الرد الأميركي على “الرد اللبناني” عبر السفارة الأميركية في لبنان، قبل عودة برّاك الى لبنان في زيارته الثالثة في 22 تموز/ يوليو الماضي لاستلام قرار الحكومة اللبنانية بـ” تسليم” سلاح “حزب الله” وفق آلية واضحة، تم تسريب تهديدات في الإعلام الصهيوني حول “ضم طرابلس وقسم من البقاع إلى سوريا مقابل انسحاب جزئي من الجولان واعتبار مزارع شبعا سورية”، بغرض خلق الفتن الطائفية والمذهبية في البلدين وما بينهما، وبالتالي تنفيذ المخطط الأميركي – الصهيوني التقسيمي، كما دخلت بريطانيا على خط الضغوط عبر إقتراح إنشاء أبراج للمراقبة على الحدود الجنوبية، بغرض قيام مراقبة دولية للبنان وتعزيز دورها فيه.
عاد برّاك للتأكيد على ما تضمنته الورقة الأميركية وكل ما جاء فيها، متجاهلاً “الرد” اللبناني، ورمى مجدداً مسؤولية “نزع السلاح” على الدولة اللبنانية، من خلال جدول زمني، وفي أسرع وقت ممكن، معلناً “عدم قدرة” واشنطن على تقديم الضمانات التي يطلبها لبنان مصرحاً بأن “الولايات المتحدة لا تستطيع أن تفرض على إسرائيل شيئاً ولا يمكن أن تمنعها من فعل أي شيء” وبأن بلاده “ليس لديها ما يجبرها على مساعدة لبنان في حال تخلفت الدولة عن القيام بما هو مطلوب منها”، وأنها تنظر إلى مؤسسة الجيش اللبناني كقوات لحفظ “السلام” (ضمناً مع العدو الصهيوني)، وليس كقوات عسكرية هجومية”. وهذا الاشتراط يفسر الطلب بتدمير السلاح “المُستلم”، وليس إستخدامه من قبل الجيش اللبناني.
لبنان والمرحلة الخطيرة التي يمر بها
أمام المرحلة الخطيرة التي يمر بها لبنان، وما يرافقها من تضليل سياسي وإعلامي وضغوط أميركية متصاعدة، يمكن القول أن لبنان كوطن وكيان وشعب مهدد بمصيره ووجوده. وقد أثبتت التجارب أن لجوء “المكونات الطائفية” إلى “الحمايات الخارجية” لم يوفر الأمن لأي منها، بل عمق الإنقسامات وأفشل كل محاولات بناء الدولة الوطنية القادرة على إخراج لبنان من دوامة الأزمات المتلاحقة. ويتحمل المسؤولية التاريخية عن البقاء في هذا الواقع “أركان النظام الطائفي”، وهذا الكيان الصهيوني المدعوم من الولايات المتحدة الأميركية.
إن العدو الصهيوني التوسعي والمعتدي يستهدف كل شعوب المنطقة، وبلدانها وأرضها وثرواتها، وهو، إضافة إلى ذلك، يمارس الإعتداءات المتكررة وينتهك السيادة الوطنية، ويحتل أرضاً لبنانية، ويمنع عودة الأهالي وإعادة إعمار بلداتهم. وبالتالي فإن مقاومته واجب، فطالما هناك إحتلال أو تهديد ومخاطر إحتلال هناك مقاومة، وهي حق مشروع لكل شعوب العالم التي تتعرض للاحتلال، وهي أمر بديهي بغض النظر عن موازين القوى، فكيف بالأحرى بالنسبة للدولة المعنية والمسؤولة الأولى عن مقاومة الإحتلال قبل غيرها. أما القول بحصرية السلاح بيد الدولة فيجب أن يتلازم مع مقاومة الدولة للاحتلال بكل السبل والوسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وهو ما افتقدته ولا تزال تفتقده الدولة اللبنانية طوال تاريخها.
لذلك يتوجب على الدولة اللبنانية إتخاذ القرار السيادي الأهم وهو تسليح الجيش اللبناني من مختلف المصادر وتمكينه فعلياً من الدفاع عن الوطن في مواجهة المخاطر المحدقة، دون الرضوخ للإملاءات الأميركية والأطلسية.
كما أن الدفاع عن لبنان هو واجب وطني لبناني، ولا بديل عن مقاومة شعبية وطنية تنتهج العمل المقاوم للدفاع عن أرضها وشعبها خارج الحسابات الطائفية والرهانات الخارجية. فالمقاومة يجب أن تكون مقاومة وطنية وشاملة في إطار مشروع سياسي تحرري وطني واجتماعي تلتف حوله الأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني، وموحداً للجهود والطاقات باتجاه بناء دولة المواطنة والديمقراطية، دولة العدالة الاجتماعية، الدولة المقاومة، التي تحترم شعبها وتصون كرامته.
إن السلاح المطلوب الحفاظ عليه في هذه المرحلة الصعبة هو سلاح المقاومة الشعبية الذي يؤمن مقومات الدفاع عن الأرض وتحريرها من الاحتلال، رفضاً لمنطق الهزيمة فـ ” لست مهزوماً ما دمت تقاوم”.. وقد يكون موضوع تحرير المناضل جورج ابراهيم عبدالله بعد 41 عاماً من الإعتقال التعسفي في السجون الفرنسية، في هذا الوقت بالذات، حافلاً بالدلالات، وأهمها ما يرتبط بالثبات على خيار المقاومة، في مواجهة العدوان المستمر والمتصاعد على شعبنا وأمتنا وأوطاننا.



بينما أسهم النضال ضد الإبادة الجماعية في فلسطين في بلورة جيل جديد من المناضلين المناهضين للإمبريالية والصهيونية، يسعى أنصار الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض تجريم معاداة

عامان من الصمود الأسطوري، وربع مليون، بين شهيد وجريح ومفقود وَلَدَت حالة وعي شعبي أممي بحقيقة الصراع وجذوره، وتنامت حالة تضامن عابرة للبنى الاجتماعية والسياسية في أقطار القارات الخمس، وتحول الرأي العام لصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه داخل عدد من الدول، كانت تعتبر معاقل نفوذ وسطوة إعلامية صهيونية

نعود اليوم إلى دق ناقوس الخطر الذي يهدد بزوال العالم العربي، بدءاً من فلسطين ولبنان، وتالياً سوريا. أما الحل، فيكمن في التحرك السريع لتجميع القوى التي ترفض التطبيع في إطار حركة تحرر عربية جديدة تعلن عن مكوناتها وبرنامجها للحل الجذري وتضع الآليات المرحلية لتنفيذه

اتسعت الفجوة الطبقية بين القلة التي تتحكم في السلطة ورأس المال، وبين ملايين الشعب المصري الذي ازداد فقراً، وبدأت الديون في ازدياد مستمر لأننا لا ننتج إلا قليلاً، ولأنه تم صرف القروض على البنية التحتية وبناء مدن جديدة لا يسكنها أحد إلا نسبة ضئيلة، دون الالتفات إلى أهمية التنمية الإنتاجية وأهمية تنمية الموارد البشرية