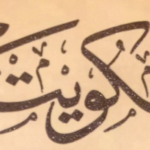في مواجهة مشروع «قانون يادان» الهادف لتوسيع تعريف مكافحة السامية ومعاداتها في فرنسا
بينما أسهم النضال ضد الإبادة الجماعية في فلسطين في بلورة جيل جديد من المناضلين المناهضين للإمبريالية والصهيونية، يسعى أنصار الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض تجريم معاداة

شهدت شوارع أبيدجان وعدد من المدن الإيفوارية الأخرى موجة واسعة من المظاهرات الحاشدة، قادتها قوى معارضة، من أبرزها الحزب الشيوعي الإيفواري، للتنديد بترشح الرئيس الحسن واتارا لولاية جديدة، معتبرة ذلك محاولة مكشوفة لتقويض ما تبقّى من العملية الديمقراطية وإقصاء الخصوم السياسيين. وردّد المتظاهرون شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ووقف ما وصفوه بـ “العدالة الانتقائية” التي تُسلَّط على المعارضة وحدها، بينما يظل الموالون بمنأى عن المساءلة والمحاسبة.
تأتي هذه الاحتجاجات قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل، في سياق سياسي واجتماعي بالغ الاحتقان، وانقسامات أعمق مما كانت عليه البلاد منذ أزمة عام 2011. فرغم مرور أكثر من عقد على تدخل الأمم المتحدة والقوات الفرنسية لفرض حكومة واتارا، فإن جذور النزاع التاريخية والسياسية لم تُعالج، بل تعمّقت، ليبقى وقود الحربين الأهليتين الأولى والثانية محفوظاً في خزائن السلطة، جاهزاً للانفجار مع أول شرارة، في مشهد يعكس استمرار الحلقة المفرغة من الاستبداد والتبعية والتهميش.
وهم التقدّم النيوليبرالي
أبيدجان بأحيائها العريقة ومراكز تسوّقها الحديثة؛ فحيّ بلاتو، مثلاً، يحتضن المغتربين الأوروبيين ومسؤولي بعثة الأمم المتحدة (UNOCI) ونخب الطبقة الوسطى الإيفوارية ببذلاتهم الرسمية الأنيقة. خلال استراحة منتصف النهار التقليدية، تمتلئ المقاهي بروّادها في مشهد يوحي بترف الحياة وازدهار المدينة.
لكن هذه الصورة البراقة تخفي وراءها واقعاً أكثر قسوة؛ فأبيدجان ليست مدينة واحدة، بل مدينتان متجاورتان يفصل بينهما جدار غير مرئي من الفقر والامتياز. خلف الواجهات المضيئة، تتكدّس الأحياء الفقيرة بالعائلات العاملة التي تعيش في ظروف بائسة. حتى في قلب كوكودي، تتجاور الأبراج السكنية بلا مصاعد مع الشقق الفاخرة، بينما في يوبوغون يعيش عشرات الآلاف في بيئة شديدة القسوة تُذكّر بأحياء “أجيجنول” في لاغوس النيجيرية، في تناقض صارخ مع الشوارع الفارهة التي تصطف على جانبيها عمارات فارغة.
في حيّ يوبوغون، ينقطع التيار الكهربائي بوتيرة أعلى بكثير مما هو عليه في الأحياء الميسورة؛ وهو ما يكشف عن التوزيع غير العادل للبنية التحتية في ظل النظام الرأسمالي، حيث تُعطى الأولوية لأحياء النخبة، بينما يُترك الفقراء لمواجهة انقطاع الخدمات، في استمرار لإعادة إنتاج التفاوت الطبقي.
ورغم مشاريع البنية التحتية الضخمة، فإنها تُنفَّذ بمنطق السوق الرأسمالية النيوليبرالية التي يتبنّاها واتارا، المدير السابق لصندوق النقد الدولي، وهو منطق يجعل “التطوير” أداة لإقصاء الفقراء وفرض أعباء اقتصادية جديدة عليهم، ويحوّل المدينة إلى واجهة لاقتصاد يخدم القلة على حساب الأغلبية.
أغلب العمال يتقاضون رواتب تتراوح بين 15.000 و45.000 فرنك إفريقي شهرياً، ومع ارتفاع تكاليف المعيشة، فإن الحد الأدنى للأجور، البالغ 60.000 فرنك إفريقي، غير قادر على ضمان مستوى معيشي لائق. وقد شهدت البلاد احتجاجات واسعة ضد ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء. شركة الكهرباء (CIE)، التي تمت خصخصتها منذ سنوات، مملوكة لشركة “بويا” الفرنسية التي تهيمن على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيفواري.
يعتمد اقتصاد كوت ديفوار بشكل كبير على صادرات الكاكاو والقهوة. ورغم إحراز تقدّم في إنتاج النفط الخام واكتشاف الذهب في الشمال، يظل القطاع الزراعي المحرّك الرئيسي للاقتصاد. يعمل 80% من قوة العمل في المزارع، بينما لا يتجاوز عدد موظفي القطاع العام 150.000 ضمن عدد سكان يبلغ 22 مليون نسمة، إلى جانب آلاف آخرين يعملون في القطاع الخاص، خصوصاً في الموانئ.
تندلع الإضرابات بشكل متكرر في الجامعات والمدارس احتجاجاً على الحسومات في الرواتب والمطالبة بزيادتها. كما شهدت الجامعات احتجاجات طلابية ضد الأوضاع المزرية في مساكن الطلبة وضد أعمال ترميم احتيالية كلفت 110 مليارات فرنك إفريقي (حوالي 191 مليون دولار) دون نتائج ملموسة. تعاني الجامعات من نقص حاد في المواد والمختبرات، ما يمنع الكثير من الطلاب، خاصة في كليات العلوم، من التخرّج. وقد تعرّضت هذه الإضرابات، مثل “إضراب المعلمين ضد الفقر”، لقمع عنيف.
كما شهدت الموانئ إضرابات لعمال النقل، ونظّم مزارعو الكاكاو احتجاجات متكررة على الأسعار المنخفضة. ينتج مزارعو الكاكاو، الذين يبلغ عددهم مئات الآلاف، نحو 1.25 مليون طن من الكاكاو سنوياً، أي ثلث الإنتاج العالمي، لكنهم لا يحصلون إلا على 40 – 50% من سعر السوق العالمي، بينما تستحوذ الشركات الكبرى على معظم الأرباح.
إن اجتماع البطالة الضخمة، والتضخم السريع، وارتفاع تكاليف المعيشة، مع حقيقة أن أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، يجعل انفجار الصراع الطبقي في كوت ديفوار أمراً شبه محتوم.
باريس غرب أفريقيا
حتى عام 1993، كانت كوت ديفوار، التي نالت استقلالها عن فرنسا عام 1960، تُعتبر نموذجاً للاستقرار في غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية. فقد حُفظ هذا الاستقرار طيلة 33 سنة بفضل أول رئيس لها، فيليكس هوفويت- بوانيي، وازدهرت البلاد بمعدل نمو اقتصادي مرتفع، رغم أنها كانت تدير نظاماً رأسمالياً وحكومة صديقة للإمبريالية الفرنسية، وتمكّنت من كبح التوترات الاجتماعية والعرقية وتجنّب النزاعات الداخلية التي ميّزت كثيراً من البلدان الإفريقية بعد الاستعمار.
من خلال ضمان أسعار مرتفعة للفلاحين وتحفيز الإنتاج، استطاع هوفويت – بوانيي (الذي كان هو نفسه مزارع كاكاو) استخدام جزء من عائدات التصدير الرئيسية للبلاد – الكاكاو – لتحقيق تقدّم اجتماعي واقتصادي يفوق بكثير ما حققته المستعمرات الفرنسية الأخرى في المنطقة. في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، أُطلق على كوت ديفوار لقب “باريس غرب أفريقيا”. وقد جذب هذا الازدهار آلاف العمال المهاجرين من دول إفريقية أخرى، مثل مالي وبوركينا فاسو. ولأسباب سياسية متعددة، منها تأمين دعم الناخبين من السكان الأجانب، اتبع هوفويت- بوانيي سياسة منح الجنسية للمهاجرين المقيمين في كوت ديفوار، مما ساهم في ضبط الخلافات العرقية والدينية خلال فترة النمو الاقتصادي.
استمر الاقتصاد في النمو عشرين عاماً بمعدل سنوي يقارب 10% – وهو الأعلى بين الدول الإفريقية غير المنتجة للنفط. لكن معظم هذه الثروة ذهب لإثراء هوفويت – بوانيي ووزرائه الفاسدين. وقد بلغ الإنفاق الباذخ ذروته عندما قرّر تحويل قريته الأم، ياموسوكرو، إلى العاصمة السياسية للبلاد، في مشروع طموح كلّف ملايين الدولارات.
بحلول الثمانينيات، بدأ نفوذ هوفويت- بوانيي يضعف بسبب التراجع الحاد في أسعار الكاكاو والقهوة في الأسواق العالمية، إضافة إلى موجات الجفاف، ما تسبب في صدمات للاقتصاد وأدّى إلى تضاعف الدين الخارجي للبلاد ثلاث مرات. وقد نتج عن ذلك أزمات اجتماعية، إذ دخلت الطبقة العاملة الإيفوارية على خط الاحتجاجات مع إضراب المعلمين عام 1982. وتواصلت الاضطرابات، ففي عام 1990 نفّذ موظفو الدولة إضراباً وانضم إليهم الطلاب المحتجّون.
توفي فيليكس هوفويت- بوانيي في ديسمبر 1993، بعد أكثر من ثلاثة عقود في الحكم، تاركاً وراءه نظاماً سياسياً هشّاً قائماً على شخصيته الكاريزمية وشبكات الولاء الشخصي أكثر من اعتماده على مؤسسات قوية.
التحولات السياسية في مرحلة ما بعد هوفويت – بوانيي
مع وصول هنري كونان بيدييه إلى السلطة (1993–1999)، حاول الحفاظ على تحالفات النظام السابق، لكنه فشل في معالجة التناقضات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة. وقد اتسمت هذه الفترة بتعميق التبعية للرأسمال الأجنبي وتراجع دور الدولة، مما أدى إلى انقلاب عام 1999 بقيادة الجنرال روبرت غوي، الذي مثّل تمرداً لـ”البروليتاريا العسكرية” المهمّشة ضد الفساد وسيطرة النخب القديمة.
وفي عام 2000، وصل لوران غباغبو إلى السلطة عبر انتخابات شابها العنف، ممثّلاً تحالفاً بين البرجوازية الصغيرة والقوميين الرافضين للهيمنة الفرنسية المباشرة. إلا أن حكمه واجه تمرداً مسلحاً عام 2002، قاده شماليون اتُّهموا بالتهميش، مما أدى إلى تقسيم البلاد فعلياً بين الشمال (الذي يسيطر عليه المتمردون) والجنوب (تحت سيطرة الحكومة). وقد كشفت هذه الحرب الأهلية (2002–2007) عن عمق الانقسامات الطبقية والإثنية، حيث مثّل الشمال قاعدة للبروليتاريا الريفية والمهمَّشين، بينما حظي الجنوب بدعم فرنسا والنخب المرتبطة بالرأسمال الدولي.
وصول الحسن واتارا إلى السلطة:
استمرارية النموذج الليبرالي الجديد
بعد أزمة سياسية عنيفة أعقبت انتخابات عام 2010، تدخلت القوات الفرنسية عسكرياً (عملية “اليونيكور” عام 2011) للاطاحة بلوران غباغبو وتنصيب الحسن واتارا، الذي مثّل تحالفاً جديداً بين النخب الشمالية والمصالح الغربية. وعلى الرغم من خطاب “المصالحة الوطنية”، فقد حافظ نظام واتارا على النموذج الاقتصادي الليبرالي التابع، مع تركيز الثروة في يد طبقة برجوازية جديدة مرتبطة بالاستثمارات الأجنبية في الزراعة والتعدين.
الرئيس الإيفواري الحسن واتارا عمل خبيراً اقتصادياً في صندوق النقد الدولي من 1968 إلى 1973، ثم تولّى منصب ممثل ساحل العاج في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا من 1973 حتى 1975. وفي الفترة من 1984 إلى عام 1988، كان مديراً لقسم أفريقيا في صندوق النقد الدولي، وفي مايو 1987 أُضيف إليه منصب مستشار العضو المنتدب في الصندوق.
اليوم، بعد 25 عاماً من تولي حكومته التكنوقراطية السلطة، ما الذي حصدته كوت ديفوار من خبراته الوظيفية في المؤسسات الدولية؟
قدّم الحسن واتارا نفسه باعتباره البديل السياسي للأنظمة القديمة التي حكمت كوت ديفوار خاضعة لسياسات قصر الإليزيه.. لكن الواقع أثبت أن واتارا لم يحافظ على مصالح الرأسمالية العالمية اقتصادياً فحسب، بل حافظ سياسياً على الاتفاقيات الفرنسية المجحفة، ولم يقترب من هيكلة النظام السياسي أو بنيته الإدارية وأعمدته البيروقراطية التي تمثل عصب النظام الرأسمالي الريعي المحلي.
هذه السياسات فتحت المجال أمام موجات عارمة من الاحتجاجات الاجتماعية طوال فترة حكمه، وواجهها النظام بشتى أشكال القمع والبطش. ففي أغسطس 2020، عندما أعلن ترشحه لفترة ثالثة غير دستورية، تظاهر الآلاف بشكل يومي في جميع أنحاء كوت ديفوار. لكن واتارا سحب الشرطة من الشوارع وأطلق ميليشيات حزب RHDP لقمع المتظاهرين بدموية، بهدف تصوير ما يحدث للعالم على أنه اقتتال أهلي “قبلي” بين مؤيدين ومعارضين للانتخابات، وليس انتفاضة شعبية ضد ترشحه غير الدستوري.
وطبعاً تجاهلت باريس انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال تلك الاحتجاجات، لأن الحسن واتارا بالنسبة لها ملاذ آمن للمصالح الفرنسية خصوصاً، والغربية عموماً، في كوت ديفوار.
تشهد كوت ديفوار اليوم أزمة سياسية عميقة تنبع من تراكم تناقضات بنيوية داخل الدولة ما بعد الاستعمارية، حيث تتصاعد الاحتجاجات الشعبية بشكل غير مسبوق ضد نظام الحسن واتارا. هذه الاحتجاجات ليست مجرد رد فعل على قرار ترشحه لولاية ثالثة، الذي يخالف النص الصريح في الدستور القائل بتحديد الرئاسة بولايتين فقط، بل تعكس أزمة شرعية أعمق للنظام السياسي ذاته، الذي يستند إلى تحالف مصالح بين طبقة برجوازية محلية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالرأسمالية العالمية، وبخاصة القوى الإمبريالية التي تحتفظ بمصالح استراتيجية بارزة في البلاد، وعلى رأسها فرنسا عبر شبكات الشركات الكبرى والمؤسسات المالية.
إن الإصرار على تجاوز الحد الدستوري للولايات الرئاسية من قِبل واتارا هو مؤشر على هشاشة النظام السياسي وغياب قواعد اللعبة الديمقراطية الحقيقية، حيث تتحول المؤسسات إلى أدوات لحماية مصالح النخبة الحاكمة. وبهذا، تُصبح الانتخابات مجرد واجهة شكلية لتكريس السلطة، في ظل غياب آليات محاسبة أو تمثيل حقيقي للشعب، مما يؤدي إلى تأجيج الاحتقان الاجتماعي واشتداد التوترات السياسية.
على الرغم من أن شخصية لوران غباغبو تبدو في الأوساط الشعبية رمزاً للرفض الوطني للهيمنة الفرنسية، إلا أن التحليل السياسي النقدي يكشف عن تناقضات جوهرية في مشروعه السياسي. غباغبو لم يكن ثورياً بالمعنى الجذري الذي يغير البنية الاجتماعية والسياسية للنظام، بل كان شعبوياً استغل الخطاب المناهض للإمبريالية لتحقيق مكاسب سياسية شخصية وتعزيز نفوذه في مواجهة خصومه. فمثلاً، إجراءات مثل تأميم البنوك خلال الأزمة عام 2011 لم تكن جزءاً من مشروع تحوّلي أو اقتصادي مستقل، بل كانت خطوات تكتيكية تهدف إلى مواجهة الخصوم داخل السلطة وتثبيت مكانته، دون نية حقيقية لإصلاح جذري أو إحداث تغيير حقيقي في بنية الدولة الرأسمالية الريعية.
ومع ذلك، يبقى غباغبو في الوعي الشعبي، خصوصاً في الجنوب، رمزاً لمقاومة الهيمنة الأجنبية، مما يجعله أداة سياسية للنضال الشعبي، لكن في الوقت ذاته ليس رأس حربة لتحوّل جذري في النظام. وهذا يعكس الأزمة التي تعاني منها المعارضة السياسية في كوت ديفوار، حيث يتنافس اللاعبون على السلطة ضمن حدود النظام القائم، دون تجاوز جذور الاستغلال الطبقي والتبعية الإمبريالية.
بالتالي، فإن الأزمة السياسية الحالية ليست فقط نزاعاً على السلطة بين شخصيات سياسية، بل هي تعبير عن صراع أعمق بين قوى الاستقرار الاستعماري الجديدة التي تحمي مصالح النخبة الحاكمة والقوى الشعبية التي تطالب بالتحرر السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ومن دون معالجة هذه التناقضات الهيكلية، من المتوقع أن تستمر موجات الاحتجاج والتوتر في التصاعد، ما قد يؤدي إلى تفكك النظام السياسي الحالي أو انزلاق البلاد نحو أزمات أشد تعقيداً.

مترجم وباحث في العلوم السياسية المتعلقة بالشأن الأفريقي. كاتب في العديد من المجلات والصحف الأفريقية. شارك في طبعات مترجمة باللغة العربية والإنجليزية في عدة مراكز بحثية بأفريقيا


بينما أسهم النضال ضد الإبادة الجماعية في فلسطين في بلورة جيل جديد من المناضلين المناهضين للإمبريالية والصهيونية، يسعى أنصار الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض تجريم معاداة

عامان من الصمود الأسطوري، وربع مليون، بين شهيد وجريح ومفقود وَلَدَت حالة وعي شعبي أممي بحقيقة الصراع وجذوره، وتنامت حالة تضامن عابرة للبنى الاجتماعية والسياسية في أقطار القارات الخمس، وتحول الرأي العام لصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه داخل عدد من الدول، كانت تعتبر معاقل نفوذ وسطوة إعلامية صهيونية

نعود اليوم إلى دق ناقوس الخطر الذي يهدد بزوال العالم العربي، بدءاً من فلسطين ولبنان، وتالياً سوريا. أما الحل، فيكمن في التحرك السريع لتجميع القوى التي ترفض التطبيع في إطار حركة تحرر عربية جديدة تعلن عن مكوناتها وبرنامجها للحل الجذري وتضع الآليات المرحلية لتنفيذه

اتسعت الفجوة الطبقية بين القلة التي تتحكم في السلطة ورأس المال، وبين ملايين الشعب المصري الذي ازداد فقراً، وبدأت الديون في ازدياد مستمر لأننا لا ننتج إلا قليلاً، ولأنه تم صرف القروض على البنية التحتية وبناء مدن جديدة لا يسكنها أحد إلا نسبة ضئيلة، دون الالتفات إلى أهمية التنمية الإنتاجية وأهمية تنمية الموارد البشرية