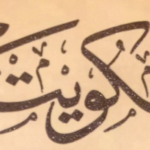في مواجهة مشروع «قانون يادان» الهادف لتوسيع تعريف مكافحة السامية ومعاداتها في فرنسا
بينما أسهم النضال ضد الإبادة الجماعية في فلسطين في بلورة جيل جديد من المناضلين المناهضين للإمبريالية والصهيونية، يسعى أنصار الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض تجريم معاداة

شكَّلَ الصراع العربي– الصهيوني امتداداً لمسار تاريخي طويل من الاستيطان الإمبريالي الصهيوني الإحلالي، الذي مارس التمدد والنهب المنظم للأرض الفلسطينية. وقد تم ذلك عبر ميليشيات صهيونية تعاونت مع بريطانيا آنذاك، الدولة الاستعمارية التي منحته ما سُمي بوعد بلفور. لم يكن وعد بلفور عام 1917 مجرد تصريح ديني عن ما سُمي “بأرض الميعاد”، بل كان جزءاً لا يتجزأ من تثبيت المشروع الاستيطاني الإحلالي الذي يهدف إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأرض بأقل عدد من الفلسطينيين الأصليين بمختلف مكوناتهم الطبقية والاجتماعية وتنوع دياناتهم. آنذاك، كانت النسبة الغالبة للمسلمين، تليها للمسيحيين، بينما لم تتعدَّ الأقلية اليهودية 5%، وكان الجميع يعيشون جنباً إلى جنب كهوية فلسطينية واحدة.
تأسست الحركة الصهيونية على رؤية أيديولوجية ترى في فلسطين “أرضاً بلا شعب لشعب بلا أرض”. وقد استُخدمت الأيديولوجيا الدينية كغطاء سياسي لتبرير الابادة والتهجير. بالإضافة إلى تحويل الأرض الفلسطينية إلى فضاء خالٍ من السكان الأصليين، بما يخدم الهدف السياسي طويل المدى في تهويد الأرض ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل.
تجسّد هذا المشروع عملياً في النكبة عام 1948، عندما طُرد أكثر من 800.000 فلسطيني من قراهم وبلداتهم، ودُمّرت نحو 530 قرية بشكل كامل. وقعت مجازر مأساوية في دير ياسين، واللد، والرملة، وصفد، ويافا، وغيرها، ترافقت مع تدمير الأحياء وحرق المنازل ونهب الممتلكات. أصبحت الأراضي الفلسطينية المحتلة مهيئة لتنفيذ الوعد المشؤوم قبيل الإعلان عن قيام الدولة الصهيونية الاحلالية تحت مسمى (إسرائيل)، وهو ما مكّنها من السيطرة على نحو 78% من الأرض. تحولت أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى لاجئين؛ استقر جزء منهم في الدول العربية المجاورة مثل الأردن ولبنان وسوريا، بينما بقي قسم كبير منهم في الأراضي الفلسطينية التي لم تُحتل بعد (أي الضفة الغربية وقطاع غزة قبل عام 1967)، بالإضافة إلى الفلسطينيين الذين لم يغادروا أراضيهم ويُعرفون بـ”عرب الداخل” أو عرب”48″، وقد واجه الفلسطينيون ظروفاً قاسية من فقدان الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ما جعل النكبة بداية لمسلسل طويل من تشتيت الهوية وتمزيقها فيما سمي لاحقاً – بفلسطيني الشتات، فلسطيني الضفة الغربية، فلسطيني غزة، فلسطيني الأرض المحتلة عام 48 وهكذا أصبح التهجير وفقدان الأرض بداية لمخططات محو الهوية الفلسطينية الجماعية واستبدالها بتجمعات متفرقة موزعة على كل الجغرافيا الممتدة من فلسطين إلى دول الطوق وما بعدها.
مع حرب حزيران 1967، تكبدت الجيوش العربية هزيمة عسكرية قاسية أمام الجيش الإسرائيلي، وكانت الضربة الجوية الإسرائيلية المباغتة العامل الحاسم، إذ استهدفت المطارات العسكرية المصرية ودمرت قواعد سلاح الجو المصري قبل أن يتمكن من الرد، ما منح إسرائيل التفوق الجوي الكامل منذ البداية. أسفر هذا التفوق عن السيطرة الإسرائيلية على كامل التراب الوطني الفلسطيني، بما في ذلك الضفة الغربية، قطاع غزة، والقدس الشرقية. شكلت هذه الهزيمة نقطة تحوّل مفصلية، إذ أضعفت القدرات العسكرية والسياسية العربية وسهلت لإسرائيل فرض سيطرتها المباشرة على السكان والموارد الفلسطينية كاملة (أرض، سماء، مياه، سكان) وهو ما أسس لمرحلة جديدة من الاحتلال والسياسات التي تستهدف تهميش المجتمع الفلسطيني وتقويض حقوقه الوطنية.
في السنوات التالية، أصدرت الأمم المتحدة قرارات مهمة تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير فصدر قرار242 (1967)، وقرار 338 (1973)، وقرار 194/191 المتعلق باللاجئين وحق العودة. هذه القرارات شكّلت الأساس القانوني الدولي للحقوق الفلسطينية لاحقاً، بما فيها الحق المكفول في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم. رغم ذلك، بدأت إسرائيل بوضع أسس الاستيطان في المناطق المحتلة حديثاً، كخطوة أولى في مشروع تهويد الأرض وتوطين المستوطنين على حساب الفلسطينيين الأصليين، مما مهد لاحقًا لبدء سياسات القضم التدريجي من الأرض عبر إنشاء المستوطنات وتغيير الواقع الديموغرافي بالكامل.
الانتفاضة الفلسطينية الأولى
اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى في ديسمبر 1987 نتيجة تراكم سنوات طويلة من القمع الإسرائيلي، الاستيطان المتواصل، والحرمان الاقتصادي والسياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بدأت الشرارة الأولى في مخيم جباليا، عندما وقع حادث أدى إلى غضب شعبي جماعي، لتتحول الاحتجاجات إلى حركة جماهيرية واسعة شملت الطلاب، والعمال، والنساء، والشيوخ في المدن الكبرى والقرى الفلسطينية، وهو ما عُرف باسم “انتفاضة الحجر”. لقد جسدت الانتفاضة وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، ورفضه للسياسات القمعية التي حاولت تهميش المجتمع الفلسطيني وإضعافه، واجباره على قبول البقاء تحت حكم الإدارة المدنية آنذاك التي تقوم بتعيين العملاء كوكلاء لإدارة شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
تميزت الانتفاضة بالطابع الشعبي غير المسلح في بداياتها، حيث اعتمد الفلسطينيون على الإضرابات، والاحتجاجات، والعصيان المدني، واحتجاجات الشارع كأدوات ضغط على الاحتلال. ومع ذلك، لم تخلو من العنف، فقد استهدفت القوات الإسرائيلية المتظاهرين مباشرة، وشنّت عمليات اعتقال جماعية، واستخدمت الحكومة الإسرائيلية آنذاك سياسة سميت (تكسير العظام)، حيث كان الجنود يعتدون على المتظاهرين السلميين بتكسير عظامهم، وحوصرت المدن والقرى الفلسطينية. أسفر ذلك عن استشهاد أكثر من 1.100 فلسطيني وجرح الآلاف، بما في ذلك الأطفال والنساء، ما خلق حالة من الرعب والفزع الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني ورغم ذلك أصر الفلسطينيون على حقهم بالتحرر والحصول على دولتهم الوطنية الحرة.
على الصعيد السياسي، وعلى الرغم من أن الانتفاضة كانت مشروعاً جماهيرياً لإعادة بناء وصقل الهوية الوطنية، ومن ثم تطورت وأخذت أبعاداً أخرى، فقد تم تحويل مسارها إلى إطار سياسي تحت مظلة مفاوضات مدريد، ومن ثم أوسلو، ما حولها من مقاومة شعبية وجماهيرية إلى مسار سياسي رسمي يركز على المفاوضات المقننة في الغرف المغلقة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، مما حد من الطابع التحرري للمشروع الجماهيري لصالح البحث عن تسويات سياسية. ومع ذلك، أسهمت الانتفاضة في إبراز القضية الفلسطينية على الساحة الدولية وتعزيز الهوية الوطنية، مؤكدة على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة المشروع الاستعماري، وفتحت المجال لدخول “الحركات الإسلامية” مثل “حماس” إلى ساحات المقاومة الشعبية، لتشارك في تعبئة الجماهير والتصدي للاحتلال بشكل مستقل عن إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
دخلت القضية الفلسطينية مرحلة جديدة عبر مسار التسوية السياسية وتوج لاحقاً بتوقيع اتفاقيات أوسلو. وهذه المرحلة مثلت تحولاً جوهرياً في المشروع الوطني وعززت من الانقسامات الداخلية في داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية نفسها حيث واجهت المنظمة معارضين لاتفاق أوسلو ومن أبرزهم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي كانت تُعارض نقل التركيز من المقاومة الجماهيرية الشعبية نحو مسار تفاوضي رسمي يحدده المجتمع الدولي، ويضع شروطاً على الفلسطينيين، أبرزها الاعتراف بإسرائيل وفرض قيود على استخدام السلاح.
رغم ادعاءات ما حققه أوسلو من بعض اعترافات دولية هزيلة بالحقوق الفلسطينية وبشكل مجزأ على شكل سلطة فلسطينية منزوعة السيادة لا تتحكم بأمنها بل تقوم وظيقتها الأساسية على التنسيق الأمني وتبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الصهيوني بشكل تام، بقي الفشل في تنفيذ بنود الاتفاق والوعود المستمرة لحل “الدولتين” حبيس المناورات السياسية الإقليمية، واستمر الاستيطان الصهيوني بعبائته الدينية – الإسرائيلية، وغابت عن المشهد خارطة طريق توضح ماهية الدولة الفلسطينية؟ ومتى ستُعلن وكيف؟ مما، أضعف الثقة الفلسطينية في المفاوضات. كما أضافت الضغوط، التي طالبت الفلسطينيين بالقبول بالتسوية والتنازل عن القدس كعاصمة أبدية ضمن تسويات تبادل الأراضي بالقيمة والمثل، مما خلق مزيداً من الإحباط، وأكدت على الحاجة لقيادة وطنية موحدة قادرة على الدفاع عن الحقوق الفلسطينية كاملة وصد مشاريع الاستسلام.
الانتفاضة الفلسطينية الثانية
اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في سبتمبر 2000، بعد انهيار آمال الفلسطينيين من مسار اتفاقيات أوسلو، الذي لم يحقق لهم دولة مستقلة أو حقوقهم الوطنية. جاءت الانتفاضة كرد فعل مباشر على استمرار الاستيطان الإسرائيلي، تدشين الجدار الفاصل، والاعتداءات المستمرة على المدنيين، وكانت ذروة الغضب الشعبي عقب زيارة أرئيل شارون إلى المسجد الأقصى، ما اعتبره الفلسطينيون استفزازاً صارخاً لمقدساتهم.
خلال هذه الفترة، ارتفعت الخسائر بشكل كبير، إذ استشهد نحو 4.973 فلسطينياً، وشُوهت البنية التحتية بشكل منهجي عبر اجتياح الضفة الغربية وتدمير البنية التحتية للمقرات الحكومية ومقرات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات.
مارست إسرائيل سياسة الاغتيالات الممنهجة التي طالت أبرز القادة الفلسطينيين مثل أبو علي مصطفى من الجبهة الشعبية، الشيخ أحمد ياسين الأب الروحي ومؤسس حركة حماس، وعبد العزيز الرنتيسي، وغيرهم العشرات إضافة إلى اعتقال أكثر من 135.000 فلسطيني، بينهم 21.000 ألف طفل وأعضاء في البرلمان المجلس التشريعي الفلسطيني، وأكاديميون وصحفيون. الهدف كان تقويض القيادة والمقاومة، وإرهاب المجتمع الفلسطيني ودفعه للاستسلام والقبول بالشروط المتعلقة بدولة فلسطينية منزوعة السلاح والقدس عاصمة لإسرائيل والاعتراف بيهودية الدولة الصهيونية.
على الصعيد السياسي، أظهرت الانتفاضة الثانية فشل مسار أوسلو بشكل واضح، إذ استمرت إسرائيل في التوسع الاستيطاني، وأدخلت تعديلات على الأرض عبر الجدار الفاصل وتقطيع الضفة الغربية إلى مناطق معزولة. في الوقت نفسه، برز الانقسام الفلسطيني بين تيار المشاركة السياسية الرسمي تحت غطاء منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، والحركات الإسلامية مثل حماس وبعض الأحزاب والجبهات المعارضة مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجبهات أخرى التي حافظت على موقفها من التسوية إلى حد كبير وانضمت إلى حركات المقاومة في قطاع غزة لاحقاً.
من الناحية الدولية، واصل المجتمع الدولي فشله في حماية الفلسطينيين، حيث بقيت القرارات الدولية رهينة الفيتو الأميركي الذي منع أي عقوبات جدية على إسرائيل.
حروب العدو على قطاع غزة وهندسة الإبادة الجماعية
شنت إسرائيل عدة حروب واسعة النطاق على قطاع غزة المحاصر. منذ عام 2008 وحتى العام 2022 وحتى ما قبل عملية “طوفان الأقصى” في تشرين أول / أكتوبر 2023، شنت إسرائيل خمس عمليات عسكرية كبرى على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد ما يزيد عن 4100 شهيد معظمهم من النساء والأطفال بالإضافة إلى عشرات آلاف الجرحى والمعوقين ومبتوري الأطراف، وأحدثت تدمير هائل في البينة التحتية والمنازل والأبراج السكنية والمرافق الاقتصادية والخدماتية.
مع اندلاع عملية “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ظهر هذا التحرك كتفجير لتراكمات قهر طويلة عاشها أكثر من مليوني ونصف مليون إنسان في قطاع غزة المحاصر. جاءت العملية، وفق بيان حركة “حماس”، كرد فعل على محاولات تهويد القدس ومصادرة الحقوق، وكرغبة في كسر الحصار وإنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق الوطنية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. لكنها قابلت رداً إسرائيلياً واسع النطاق تحول سريعاً إلى مشروع إبادة ومحو شامل، يستهدف اقتلاع الإنسان الفلسطيني من وجوده المادي والرمزي وإعادة ترتيب الواقع الديموغرافي لصالح منطق الدولة اليهودية التوراتية الخالصة. وتحقيق حلم “إسرائيل الكبرى من النيل للفرات”.
كشف الإحصاءات حجم الكارثة المهندسة والمخططة بشكل خبيث: وفق وزارة الصحة في غزة منذ السابع من تشرين أول / أكتوبر 2023 تجاوز عدد الشهداء 65.000 شخص حتى نهاية شهر أيلول 2025، وأكثر من 167.000 جريح معظمهم أصبحوا معوقين ومبتوري الأطراف كما تشير التقارير إلى أن حوالي 90% من الضحايا الشهداء هم من المدنيين، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال وكبار السن. عدا عن أكثر من عشرة آلاف مفقود تحت الركام والانقاض.
أدى الحصار المشدد والسيطرة على المعابر إلى استخدام التجويع والتعطيش كهندسة ممنهجة يومية لمنع تدفق الغذاء والدواء والوقود، ما تسبب في تصاعد معدلات سوء التغذية، وارتفاع في حالات الإجهاض، وانقطاع التيار عن أجهزة دعم الحياة في المستشفيات. وصلت حرب الابادة والمحو حداً يُشكِّل ما يُعرَف بالإبادة الإنجابية للفلسطينيين، عبر حرمان النساء الحوامل من الخدمات الصحية الأساسية وارتفاع معدلات الوفيات المرتبطة بالحمل والولادة إلى أكثر من 300% وفق احصائيات وزراة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة للعام 2025. وتم قصف مراكز الخصوبة والانجاب مثل مركز بسمة للإخصاب، حيث أبادت إسرائيل وأزالت عن الوجود ما يزيد عن 5000 عينة من الحيوانات المنوية والبويضات كانت مخزنة لأباء وأمهات فلسطينيين من قطاع غزة يعانون من مشاكل انجابية.
استهدفت الضربات أيضاً الصحفيين والفرق الطبية: استشهد أكثر من 250 صحفيا وصحفية فلسطينيا وجرح العديد من الصحفيين، وتعرضت المستشفيات ومراكز الإمداد الطبي للقصف أو التعطيل بينها مسشتفيات تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، واستشهد عشرات الأطباء والمسعفين، ما أدى إلى تراجع القدرة على تقديم الرعاية الصحية الأساسية. وتم اعتقال آلاف الفلسطينيين من بينهم الأطباء، بينما أفادت تقارير عن حالات تنكيل واعتداءات واغتصاب ضد معتقلين من قطاع غزة، بما في ذلك رجالاً استُخدمت ضدهم أساليب ترهيب جسدية ونفسية في محاولات لكسر الإرادة الشعبية والجماهيرية ودفع الشعب الفلسطيني في غزة إلى الاستسلام من جهة وإلى نبذ المقاومة من جهة والتحريض ضدها في محاولة يائسة لدفع أهل قطاع غزة إلى اعتبارها سبباً في المقتلة والابادة والمحو التي تمارسه الحكومة الإسرائيلية بمباركة أميركية وغربية صهيونية وبعض العرب.
امتدّ الاستهداف أيضاً إلى الذاكرة والهوية؛ فالجامعات والمكتبات والمراكز الثقافية والبرامج التعليمية تعرّضت لأضرار ومضايقات تهدف إلى طمس الذاكرة الوطنية، وهو شكل رمزي من المحو يوازي في خطورته العنف المادي.
تتجلى هندسة العنف الإبادي كذلك في البُعد النفسي والاجتماعي؛ حيث الأطفال والفتيات والمراهقين في قطاع غزة ما زالوا في حالة مؤلمة من التشريد والألم والصدمات المتكررة التي تهدد نموهم العقلي والعاطفي، والكبار من النساء والرجال وكبار السن يعانون استنزافاً نفسياً كل هذا أدى إلى تآكل رأس المال الاجتماعي من جهة وانهيار آليات التضامن من جهة أخرى ما فسح المجال أمام ظهور حالات وتشوهات اجتماعية مثل انتشار العنف الداخلي والسرقة وظواهر الاستغلال الفاحش للموارد وبيع السلع الذي استغلته إسرائيل من خلال الدفع بعناصر مشبوهة تزيد من حالة التشويش والتشوه الاجتماعي وتحوّلت الحركة اليومية إلى معاناة مستمرة بفعل الحواجز والقتل المنظم لطالبي المساعدات وبالتالي أصبحت حياة أكثر من مليوني إنسان معرّضة لهشاشة شديدة تهدف إلى تقويض القدرات المعرفية للمجوعين والمشردين من أجل دفعهم إلى اتخاذ قرارات غريزية للبقاء وبالتالي تدفعهم لقبول أي تسويات تحافظ على حياتهم وحياة أطفالهم حتى لو كانت على حساب حقوقهم الوطنية والإنسانية كفلسطينيين وبالتالي يُصبح مشروع التهجير الطوعي مسألة مشروعة بدوافع “إنسانية”، بينما تتربص الصهيونية من خلف الكواليس للاستيلاء على الأرض وتفريغها من سكانها واستبدالها بالمستوطنين وهو مشروع طرحته حكومة سموتيرش وبن غفير تحت عنوان العودة إلى إعمار قطاع غزة وبناء المستوطنات من جديد.
اليوم التالي بعد حرب الإبادة والمحو على غزة:
بين نزع السلاح ومحور الحقوق الوطنية
منذ اندلاع حرب الإبادة والمحو على غزة وما خلّفته من دمار واسع ومعاناة إنسانية هائلة، تصاعدت الطروحات الدولية والأميركية حول مستقبل القطاع وما يُعرف بـ«اليوم التالي». في قلب هذه الطروحات يتكرر بند جوهري: نزع السلاح الكامل كشرط مسبق لإقامة أي كيان فلسطيني إداري أو سياسي. في ظاهر الأمر قد يُسوّق هذا الشرط كمطلب عسكري للأمن والاستقرار، لكنه في جوهره يمسّ القضية الفلسطينية بأبعاد استراتيجية، إذ يجرد الشعب من حقه في الدفاع عن نفسه ويختزل الكيان الفلسطيني المرتقب من مشروع دولة ذات سيادة إلى جهاز إداري منزوع الإرادة والسلاح ، كما يكرّس التفوق العسكري الإسرائيلي مقابل كيان ضعيف يفتقر لأدوات الحماية والشرعية. يمثل هذا الشرط محاولة لتصفية مشروع المقاومة كجزء من مسار التحرر الوطني، ليُختزل الصراع في إطار أمني ضيق بينما جوهره يرتبط بحقوق سياسية وتاريخية أوسع، ويحوّل أي تسوية مستقبلية إلى اتفاق غير متكافئ يخدم مصالح القوى المهيمنة أكثر من تطلعات الفلسطينيين.
من منظور الخطاب الصهيوني الرسمي، يُقرأ «اليوم التالي» كفرصة للقضاء على قدرة المقاومة وإحراز «نصر جذري» يعيد تعريف واقع السيطرة والابادة والمحو والتهجير والتطهير والتهويد، أما لدى الفلسطينيين، فـ «اليوم التالي» لا يمكن أن يكون أقل من استرجاع الحق الوطني الكامل: دولة فلسطينية مدنية وديمقراطية ذات سيادة على أرضها، قادرة على حماية شعبها، مع الالتزام بحق العودة وصون الكرامة والعدالة.
في مواجهة كل هذه المخططات، لا يمكن اعتبار أي موافقة فلسطينية غير شرعية ولا تحظى بالإجماع الشعبي والوطني أو صادرة عن أطراف خارجية شرعية، فالشعب الفلسطيني ليس مجرد جمهور لتلقي التعليمات، بل هو صاحب الحق الأصلي منذ آلاف السنين في تقرير مصيره. أي محاولة لفرض إدارة مؤقتة أو وصاية تحت غطاء «إعادة الإعمار» أو «الهدوء الأمني» تتجاهل الشرعية الوطنية الشعبية، وتحول الشعب إلى أداة تنفيذية في مشاريع سياسية لا تمثل مصالحه ولا تطلعاته ستفشل آجلاً أو عاجلاً. من هنا، يجب أن يكون موقف الفلسطينيين في قلب أي نقاش حول «اليوم التالي»، بحيث يستند إلى إرادة الشعب ويعكس حقوقه التاريخية والسياسية الكاملة.
ومن هنا تتضح ضرورة أن تُترجم تضحيات الدم والدمار إلى أرضية متينة لنضال يربط بين الحرية والسيادة والعدالة، ويضع الضفة الغربية في مركز أي استراتيجية فلسطينية حقيقية، ويمنع تهويدها وضمها، ويحافظ على قطاع غزة كجزء أصيل من الكيان الفلسطيني التاريخي جيو- سياسياً، بدل فصله وعزله أو محوه بما يخدم المشاريع الترامبية في الشرق الأوسط، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق والقرار النهائي في تقرير مصيره.



بينما أسهم النضال ضد الإبادة الجماعية في فلسطين في بلورة جيل جديد من المناضلين المناهضين للإمبريالية والصهيونية، يسعى أنصار الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض تجريم معاداة

عامان من الصمود الأسطوري، وربع مليون، بين شهيد وجريح ومفقود وَلَدَت حالة وعي شعبي أممي بحقيقة الصراع وجذوره، وتنامت حالة تضامن عابرة للبنى الاجتماعية والسياسية في أقطار القارات الخمس، وتحول الرأي العام لصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه داخل عدد من الدول، كانت تعتبر معاقل نفوذ وسطوة إعلامية صهيونية

نعود اليوم إلى دق ناقوس الخطر الذي يهدد بزوال العالم العربي، بدءاً من فلسطين ولبنان، وتالياً سوريا. أما الحل، فيكمن في التحرك السريع لتجميع القوى التي ترفض التطبيع في إطار حركة تحرر عربية جديدة تعلن عن مكوناتها وبرنامجها للحل الجذري وتضع الآليات المرحلية لتنفيذه

اتسعت الفجوة الطبقية بين القلة التي تتحكم في السلطة ورأس المال، وبين ملايين الشعب المصري الذي ازداد فقراً، وبدأت الديون في ازدياد مستمر لأننا لا ننتج إلا قليلاً، ولأنه تم صرف القروض على البنية التحتية وبناء مدن جديدة لا يسكنها أحد إلا نسبة ضئيلة، دون الالتفات إلى أهمية التنمية الإنتاجية وأهمية تنمية الموارد البشرية