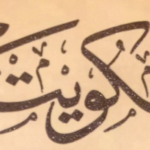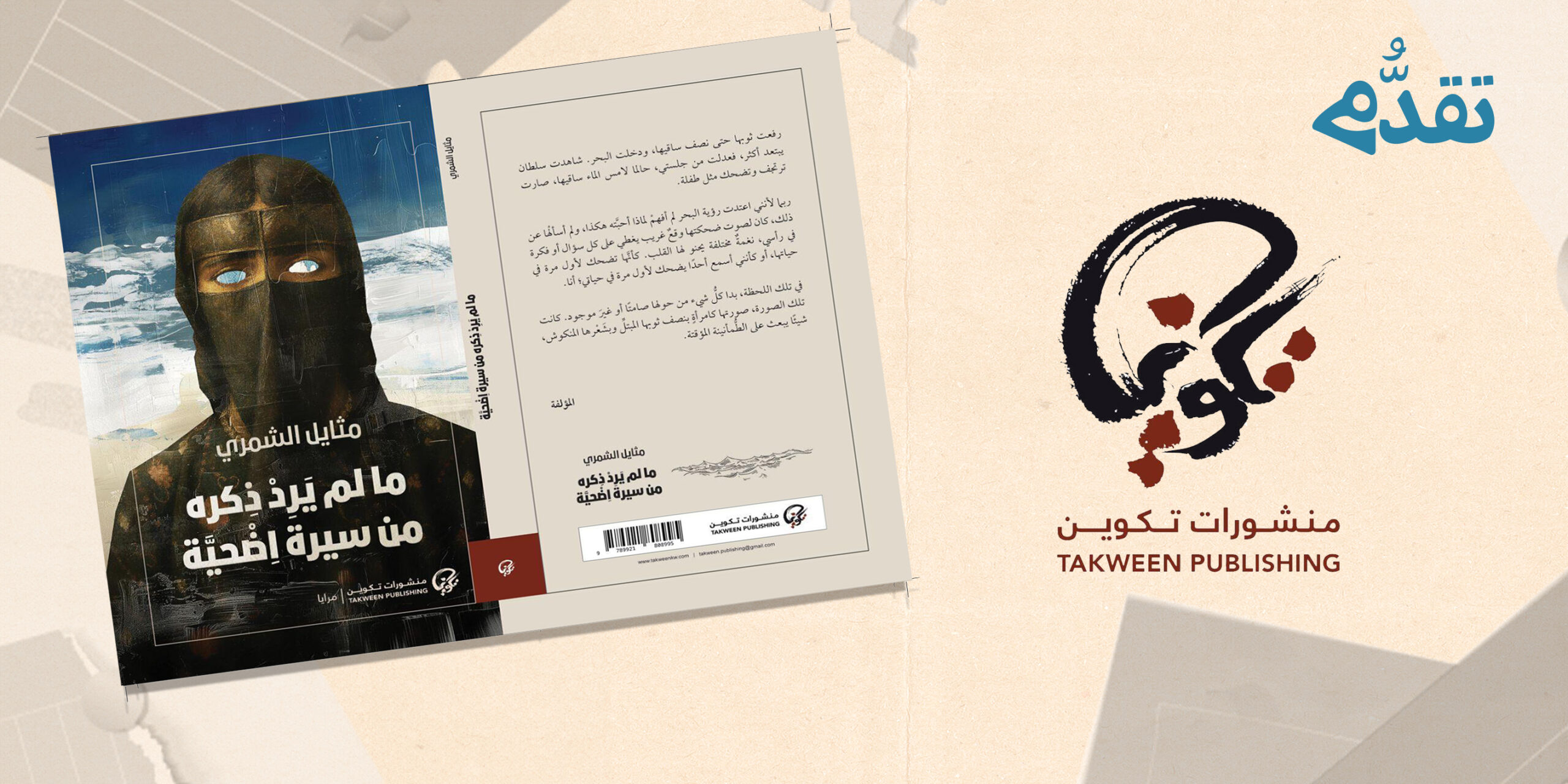
“ما لم يَرِدْ ذِكره من سيرة اِضْحيَّة”
صدر عن منشورات تكوين رواية ” ما لم يَرِدْ ذِكره من سيرة اِضْحيَّة” لـ مثايل الشمري. “الحقيقة ليست مقيَّدة بأن تُوجِد الأشياء أو تحدث، وإنَّما

فريدريك إنجلز رفيق درب كارل ماركس في النضال من أجل الثورة ضد النظام الرأسمالي، وصديق عمره. شارك ماركس في وضع أسس النظرية المادية العلمية، وله تأثيره الواضح عليها ودوره في تطويرها، واستكمال إرث ماركس النظري.
ولد فريدريك إنجلز في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1820 في مدينة بارمن، لأسرة ثرية كانت تمتلك مصانع في كل من ألمانيا وانكلترا. تعرَّف إنجلز على فلسفة هيغل خلال وجوده في برلين وانضم إلى ما يعرف بحركة “الهيغيليين الشباب”، ولكنه قطع مع الهيغيلية، وأيضاً كارل ماركس، في مرحلة اتسمت بتطور فكرهما. قطيعة ليست كما هي في مفهوم ألتوسير لقطيعة ماركس مع هيغل، والمفهوم الباشلاري للقطيعة الابيستيمولوجية، أي ليست قطيعة ميكانيكية، فقد حدَّد إنجلز أس تلك القطيعة بقوله: “حدثت القطيعة مع فلسفة هيغل عن طريق العودة الى وجهة النظر المادية. وهذا يعني ان انصار هذا الاتجاه قد قرروا ان يدركوا العالم الحقيقي – الطبيعة والتاريخ – كما يبدو لكل من ينظر اليه بدون أوهام مثالية مسبقة؛ وقد عزموا على التضحية بلا رحمة بكل وهم مثالي لا يتفق مع الوقائع المأخوذة في علاقتها الخاصة بها(…). ولم يطرح هيغل جانباً ببساطة، بل على العكس، فقد أخذ الجانب الثوري من فلسفته (…) أي الطريقة الديالكتيكية نقطة انطلاق”. (انجلس فريدريك، لودفيغ فورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية، دار التقدم، موسكو، لا. ط، لا. ت.ص. ص. 42-43. التعليم بالخط العريض من عندياتي). يوضح نص إنجلز المفهوم الديالكتيكي للقطيعة الإبيستيمولوجية، أي أنها ليست قطيعة سلبية مطلقة ميكانيكية بل هي قطيعة نفيية مادية ديالكتيكية تبقي ما هو قابل للحياة والتطور والنمو بالارتباط مع تطور الواقع الموضوعي والبراكسيس (الممارسة). وبعد مرحلة “الهيغيليين الشباب” تأثر إنجلز بكل من فريدريش شتراوس، ولودفيغ فورباخ، وبرونو باور.
عام 1844 كان عام التأثير الكبير على تطور فكر فريدريك إنجلز ومسيرته النضالية، حيث تعرَّف على كارل ماركس في باريس في طريق عودته إلى ألمانيا وبدأت مسيرتهما النضالية المشتركة من أجل الثورة على الرأسمالية ووضع الأسس النظرية لهدمها وإقامة نقيضها، الاشتراكية، وتسليح الطبقة العاملة بالنظرية المادية العلمية وإظهار أهمية البراكسيس ومفهوم ارتباطه بالنظرية الثورية، ومحوريته في النضال ضد النظام الرأسمالي للقضاء عليه.

تشارك فريدريك إنجلز مع كارل ماركس في تأليف العديد من الكتب والنتاج النظري، وله مؤلفات نشرها. بعد وفاة كارل ماركس قام فريدريك إنجلز بعمل جبّار كرَّس له وقته وفكره، فقد عمل على نشر الجزءين الثاني والثالث من ملحمة كارل ماركس “رأس المال”، بعد أن حرر المخطوطات التي تركها ماركس ونقحها.
في 5 آب / أغسطس عام 1895 رقد فريدريك إنجلز بسلام، في لندن، مطمئناً على انجاز المهمة الثورية نشر الجزء الثاني والثالث من “رأس المال”، الملحمة النظرية في النضال ضد الرأسمالية وكشف آليات استغلالها للطبقة العاملة وأفق تطورها الذي يمعن بالمزيد من الاستغلال لتحقيق الربح، ولكنها على موعد مع أجلها تستقدمه تناقضاتها ونضالات حفّارة قبرها الطبقة العاملة في خوضها للصراع الطبقي محرِّك التاريخ.
في هذا المقال نلقي الضوء، بعجالة سريعة، على مسائل رئيسة بحثها إنجلز في العلوم والاكتشافات العلمية مظهراً خلفيتها الفلسفية، في ضوء المنهج المادي العلمي، انتقدَ فيها الفهم المثالي والمادي الميكانيكي الميتافيزيقي للاكتشافات العلمية، ووضع أسس الفهم المادي العلمي لتطور العلوم في مختلف الحقول. منهجية مادية ديالكتيكية حدَّدها إنجلز بأنه ليس بصدد وضع موجز حول الديالكتيك وذلك بتأكيده “لم نضع نصب أعيننا هنا مهمة كتابة موجز عن الديالكتيك، بل توخينا تبيان كيف أن القوانين الديالكتيكية هي قوانين حقيقية لتطور الطبيعة، أي أنها تسري على العلوم الطبيعية النظرية أيضاً” (انجلز فريدريك، ديالكتيك الطبيعة، ترجمة توفيق سلوم، ط 2، دار الفارابي، بيروت، 2011، ص. 79). مع تأكيده، في الوقت نفسه، لمسألة رئيسة هي أنه في مجابهة الميتافيزيقا يجب تطوير الطابع العام للديالكتيك بأنه علم عن الترابط الشامل، عن القوانين العامَّة لكل حركة، عن قوانين تطوّر الطبيعة والمجتمع والفكر. وفي كتابه “أنتي دوهرينغ” كتب إنجلز أن المسألة ليست تطبيق قوانين الديالكتيك على الطبيعة بل اكتشافها في الطبيعة واستخراجها منها.
إنجلز وكشف الأساس الفلسفي لقوانين علميَّة
انتقدَ إنجلز في كتابَيْه “انتي دوهرينغ” و”ديالكتيك الطبيعة”، طروحات المعرفة المطلقة بمفهومها الميتافيزيقي، ففي كتابه الأوَّل انتقدَ طروحات دوهرينغ القائمة على الحقيقة المطلقة وأبديتها وما يحمله هذا الطرح من بعد ميتافيزيقي وأيديولوجي يحول دون فهم العالَم وفهم الواقع لتغييره؛ وفي كتابه الثاني عملَ إنجلز على إظهار المضمون الديالكتيكي للعلوم، فكتاب “ديالكتيك الطبيعة” يحتوي، إلى جانب نقده للنزعة المثالية واللا أدرية، على فهم ديالكتيكي للطبيعة ولتطوّر العلم وفيه طروحات علميَّة أثبتها العلم في ما بعد. يعكس كتاب “ديالكتيك الطبيعة” سعة اطلاع إنجلز على فروع العلم وما شهدته من تطورات واكتشافات، ويقوم الكتاب على فكرتَيْن رئيستَيْن عملَ إنجلز، في “ديالكتيك الطبيعة” وفي أعماله اللاحقة، على بحثهما بعمق هما وحدة العالَم، والتطوّر التاريخي للطبيعة.
ومن الموضوعات المهمة التي بحثها إنجلز في “ديالكتيك الطبيعة” إبرازه المضمون المادي الديالكتيكي في علوم الرياضيات والميكانيكا والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، في جانب من تلك الموضوعات التي بحثها إنجلز، بخاصة المتعلقة بالفيزياء، يبرز بحثه الخلاّق لقانون حفظ الطاقة وتحولها الذي كشف فيه بُعده الفلسفي، وتأكيده أنه مع كل اكتشاف علمي هام في العلوم الطبيعية وتاريخها ينبغي على المادية أن تغير شكلها. إنَّ هذا التأكيد يرتبط، بالطبع، بإظهار إنجلز للبُعد الفلسفي للاكتشافات العلميَّة ونقد تأويلها الهادف إلى إنكار الوجود الموضوعي للمادة وفصلها عن الحركة والتطوّر والتغير، ويظهر، أيضاً، ارتباط المعرفة بتطور العلوم ومعرفة العالَم من أجل تغييره.
اقتران المادة والحركة بالمفهوم المادي العلمي
وضعَ إنجلز فهماً جديداً لمبدأ اقتران المادة والحركة في موقع نقيض لمفهومه المادي الميكانيكي الذي يجعل الحركة، مقتصرة على الانتقال المكاني لأجسام لا تتغير داخلياً، هذا ما انتقده إنجلز بوضعه مبدأ اقتران المادة والحركة، فالحركة هي أسلوب وجود المادة ملازمة لها وتشتمل على جميع التغيرات في الكون والعمليات الجارية فيه “بدءاً من الانتقال البسيط في المكان وانتهاءً بالتفكير”. مفهوم أشكال الحركة وتلازمها مع المادة تطوّر خلال مسيرة العلوم التاريخية من الانتقال المكاني الميكانيكي للأجرام السماوية، تبعها نظرية الحركة الجزيئية، الفيزياء، علم الكيمياء، الذرات إلخ… هي أشكال للحركة ميزَ إنجلز بينها على أساس أن لكل شكل من المادة شكل حركته الخاص به و”كلما كانت الحركة أرفع شكلاً يغدو هذا الانتقال المكاني أقل أهمية. إنه لا يستنفد، بأية حال، طبيعة الحركة المعنية، لكنه لا ينفصل عنها”. (انجلز فريدريك، ديالكتيك الطبيعة، مصدر سابق، ص. 87)، والطبيعة، بمجموعها، منظومة متكاملة من الأجسام المادية مترابطة تفعل ببعضها الآخر، الفعل المتبادل بينها يؤلف الحركة، على هذا الأساس يتضح معنى قول إنجلز “إن المادة لا تُعقَل بدون حركة”. هذه النتيجة أصبحت بتحديد إنجلز لها في ديالكتيك الطبيعة حتمية منذ أن تم “إدراك الكون كمنظومة، كترابط متبادل للأجسام”، لذلك فإن الاختلاف النوعي في الطبيعة وتشكيلها ككل واحد مترابط يتطلب كشف الأشكال الأساسية للمادة وحركتها، وكشف، في الوقت نفسه، الترابط بين هذه الأشكال في الكون.
إنه فهم نقيض للنظرة الميكانيكية الميتافيزيقية التي تُعيد أشكال الحركة العليا إلى النقلة الميكانيكية، بفهمها هذا تفهم الحركة فهماً ميكانيكياً غير منفصل عن فهمها للمادة. وبالتالي فإنه على أساس الفهم القائم على منهجية المادية الديالكتيكية النقيضة للميكانيكية ولثنائية الأضداد، يتضح أنَّ الطبيعة في المفهوم الماركسي – اللينيني “مترابطة يؤثر بعضها في بعض فبين الأطروحة فيها والطباق تبادل في التأثير وليست حاصلة من تراكم الأشياء تراكماً عرضياً ولا من ترادف الحوادث ترادفاً مشتتاً”. (اليافي عبد الكريم، الفيزياء الحديثة والفلسفة، لا. ط، مطبعة الجامعة السورية، دمشق، 1951، ص. 178).
السببيَّة، الحتميَّة، الضرورة، الصدفة
أعطَتْ الماركسية بنقدها للمثالية وللمادية الميكانيكية الميتافيزيقية، حركة مادية ديالكتيكية لمفاهيم السببيَّة والحتميَّة، والضرورة والصدفة، بربطها بالواقع وتطوره وظروفه، ففي المنهجية المادية الديالكتيكية نجد بموجبها “أن النتيجة والعلة تصوران لا يصلحان الا في حال تطبيقهما على الحالات الفردية، لكننا لا نكاد ننظر الى الحالات الفردية في ارتباطها العام بالكون في مجموعه حتى تتداخل في بعضها بعضاً، وهي تذوب وتمتزج حين نتأمل في ذلك الفعل ورد الفعل العموميين اللذين تبدل النتائج والعلل فيهما أماكنهما بصورة أبدية، بحيث أن ما هو علة في هذا المكان وفي هذه الآونة يصبح نتيجة في ذلك المكان وفي تلك الآونة، والعكس بالعكس”. (انجلس فريدريك، أنتي دوهرينغ، ت. فؤاد أيوب، دار دمشق، ط1، 1965.ص.ص 28-29). في تحديد إنجلز يظهر الفعل المتبادل بين السبب والنتيجة وإمكانية تبدل مواقعهما وذلك بدراسة العالَم ككل واحد مترابط ديالكتيكياً، وأن العلاقة بين السبب والنتيجة مرتبطة بأشكال الحركة التي تنتقل من شكل إلى آخر، ومن خلال “الفعل المتبادل الشامل وحده، يمكننا التوصل الى العلاقة السببيَّة الواقعية. فلفهم الظواهر المفردة ينبغي انتزاعها من ترابطها العام، وبحثها منعزلة، وعندها تظهر لنا الحركات المتبدلة: إحداها سبباً، والأخرى- نتيجةً”. (انجلز فريدريك، ديالكتيك الطبيعة، مصدر سابق، ص. 269).
انتقدَتْ الماركسية مفهوم الضرورة والصدفة في المادية الميكانيكية التي تتخبط عند بحث التضاد بين هاتين المقولتَيْن، في هذا الإطار طرحَ إنجلز في “ديالكتيك الطبيعة” أسئلة عن النظرة الميكانيكية من مثل كيف يمكن أن تكون المقولتان المنطقيتان، الضرورةُ والصدفةُ، متطابقتَيْن؟ كيف يمكن أن يكون العَرَضي ضرورياً، والضروري عَرَضياً؟ إجابة النظرة الميكانيكية أن الضرورة والصدفة هما مقولتان تستثني إحداهما الأخرى، لأن الشيء أو العلاقة إمَّا أن تكون ضرورية وإمَّا أن تكون عَرَضية، أي إقامة تضاد ميكانيكي ينفي العلاقة بين العَرَضي والضروري، بين الصدفة والضرورة. من هذه الأسئلة وإبراز المنهجية الميكانيكية في الإجابة عنها، يكمل إنجلز نقده للحتميَّة الميكانيكية التي دخلت إلى العلوم للتخلص من الصدفة، القائلة بأن الحتميَّة تسيطر على الطبيعة بأكملها وما يحدث فيها ولّدته سلسلة صارمة بين العلة والمعلول، السبب والنتيجة، أي ضرورة تجعل الحوادث تجري وفق ضرورة صارمة ثابتة، ضرورة انتقدتها الماركسية، وأطلق عليها إنجلز في “ديالكتيك الطبيعة” تسمية “النظرة اللاهوتية الميتافيزيقية للطبيعة”، لأنها لا تتطرق إلى تتبع التسلسل السببي بل هي نظرة قائمة على تضمين مسبق للضرورة في التنظيم الأوَّلي للطبيعة، وهذا ما يحول دون التقدم خطوة واحدة إلى الأمام، لأن في هكذا حتميَّة، في نقد إنجلز لها، يتم بحث حادثة مفردة في ارتباطها السببي بأسباب قصوى وهذا “عبث محض”، لأنه ينسلخ عن الواقع ويبحث في أسباب ميتافيزيقية. من هذا المنطلق فإن الصدفة في المفهوم الماركسي “تخضع لقوانين داخلية (…)، ولا تتقوّم المهمة الا في اكتشاف هذه القوانين”. (انجلس فريدريك، لودفيغ فورباخ…، مصدر سابق، ص. 50).
ركزَ إنجلز في بحثه للسببيَّة والحتميَّة على أن الملاحظة التجريبية لا تستطيع بحد ذاتها إثبات الضرورة إثباتاً كافياً، فالبرهان على الضرورة يكمن في الفعل البشري، في العمل والتجربة وبذلك أعطى إنجلز المعنى الديالكتيكي لمفهوم السببيَّة حيث اننا في الحياة اليومية نراقب المادة المتحركة ويلفت نظرنا “ترابط الحركات الفردية للأجسام الفردية، وكون إحداها شرطاً للأخرى. ونحن لا نجد ان هذه الحركة متبوعة بتلك الحركة فحسب، بل نجد، أيضاً، إن بوسعنا إحداث هذه الحركة المعينة بخلقنا الشروط، التي تحدث فيها في الطبيعة، كما أن بإمكاننا إحداث حركات، لا تصادف، مطلقاً، في الطبيعة (الصناعة) (…). ونستطيع إعطاء هذه الحركات اتجاهاً وامتداداً معينين مسبقاً. وبفضل هذا، بفضل نشاط الإنسان، نبرهن فكرة السببية، أي الفكرة القائلة بأن حركة ما هي سبب الأخرى”. (انجلز فريدريك، ديالكتيك الطبيعة، مصدر سابق، ص. 267). على هذا الأساس تابع إنجلز نقاشه لمفهوم السببية ببحثه لمسألة التعاقب المنتظم (التكرار) الذي أعطى فيه أين تكون ريبية هيوم على حق بتحديده أنه “في الحقيقة، نجد أن التعاقب المنتظم لبعض الظواهر الطبيعية يسعه، لوحده، أن يولِّد تصوراً (فكرة) عن السبيية (…)، لكن هذا لا يشكل، على الدوام، برهاناً، وهنا تكون ريبية هيوم على حق في القول أن التكرار المنتظم لـ (Post hoc) لا يمكن، أبداً، أن يكون أساساً لـ (Propter hoc). لكن نشاط الإنسان هو محك السببية” (إنجلز فريدريك، ديالكتيك الطبيعة، مصدر سابق، ص. ص. 267- 268)، ولكن هذا الجانب في ريبية هيوم انتقد إنجلز منهجيته التي أوصلت إلى مفهوم ميكانيكي ميتافيزيقي للسببيَّة ودحضه، في “ديالكتيك الطبيعة”، بتحديده أنه يمكننا مسبقاً تتبع العمليات السببيَّة بالتجربة، فعلى سبيل المثال عمليَّة اشتعال البارود والاحتراق والانفجار، هي حالة يقول انجلز في “ديالكتيك الطبيعة” بأنه لا يستطيع الريبي قول إنَّ التجربة السابقة لا تعني أن الأمر سيكون نفسه في المرة المقبلة لأنه قد يحدث عدم تكرار الأمر نفسه، هذا القول يثبت السببيَّة لأن المفهوم المادي الديالكتيكي يحثُّ على بحث قاعدة الانحرافات وأسبابها واكتشافها.
إنجلز مفهوم علاقة الرياضيات البحتة بالتجربة وتطوّر المعرفة
بحثَ إنجلز الرياضيات البحتة وحساب التفاضل والتكامل، وعملَ على إظهار علاقة الرياضيات بالتجربة وتطوّر المعرفة التاريخية، وعلاقتها بحاجات الناس، وأن المقادير الرياضية منشأها العالَم الخارجي، هذا المفهوم المادي الديالكتيكي للرياضيات المنطلق من الطبيعة التاريخية للمعرفة، أبرزه إنجلز في كتابه “أنتي دوهرينغ” بتحديده أنه ليس صحيحاً “في حال من الأحوال أن الذهن لا يعالج في الرياضيات المحضة سوى ابداعاته وتخيلاته الخاصة (…). ان الرياضيات المحضة تعالج الأشكال الفراغية والعلاقات الكمية الخاصة بالعالم الحقيقي – يعني مادة عينية تماماً في حقيقة الأمر. أما أن هذه المادة تتراءى في صور مجردة حتى الدرجة القصوى، فذلك أمر لا يمكن أن يخفي الا بصورة سطحية نشوءها عن العالم الخارجي (…). ان الاشتقاق الظاهري للمقادير الرياضية من بعضها بعضاً لا يثبت هو نفسه أصلها القبلي، بل يثبت ترابطها العقلاني فحسب (…). ان الرياضيات، مثلها مثل جميع العلوم الأخرى، قد نشأت من حاجات البشر، من مسح الأرض وقياس سعة الأواني، ومن حساب الوقت ومن الميكانيك. لكنه كما هي الحال في مختلف أجنحة الفكر، فإن القوانين التي استخلصت من العالم الواقعي تفترق في مرحلة معينة من التطور عن هذا العالم الواقعي وتجابه به على اعتبارها شيئاً مستقلاً، على اعتبارها قوانين آتية من الخارج ينبغي للعالم أن يتطابق معها. هكذا حدثت الأمور في المجتمع وفي الدولة، وبهذه الطريقة، وليس بأية طريقة أخرى، طبقت الرياضيات المحضة لاحقاً على العالم على الرغم من أنها مستعارة من هذا العالم نفسه وهي لا تمثل سوى جزء واحد من الأشكال التي تركبه – وهي إنما يمكن تطبيقها لهذا السبب وحده”. (انجلز فريدريك، أنتي دوهرينغ، مصدر سابق، ص. ص. 49-50)
أبرزَ إنجلز أصول حساب التفاضل والتكامل وعملياته في العالَم الواقعي، وأنتقدَ التصور القائل إنَّ المقادير المستخدمة في حساب اللا متناهيات في الصغر هو من المخيلة ولا يقابله أي شيء في العالَم الموضوعي، نقد إنجلز انطلق فيه من أنَّ الطبيعة تقدم لنا أحوال هذه المقادير المتخيلة والهندسة التي تنطلق من العلاقات المكانية، والحساب والجبر للمقادير العددية لها وجودها الموضوعي، فالجزيء “يتمتع، حيال الكتلة الموافقة، بنفس الخصائص، التي يتمتع بها التفاضل الرياضي حيال متحولاته، مع فارق وحيد هو أن ما يبدو في حالة التفاضل، في التجريد الرياضي، مبهماً وغير قابل للايضاح، يغدو، هنا، جلياً بذاته، شيئاً بديهياً، إذا صح التعبير”. وخلصَ إنجلز إلى أنه “بفضل حساب التفاضل والتكامل أمكن للعلوم الطبيعية، وللمرة الأولى، من أن تمثل رياضياً لا الحالات فحسب، بل والعمليات أيضاً: الحركة”. (*)
مفهوم إنجلز للعدد صفر
بحث إنجلز للعدد صفر وتحديد أهميته في الرياضيات والهندسة بإظهار المفهوم المادي الديالكتيكي يعتبر من الأبحاث العميقة في هذا المجال، ففي بحثه لحساب التفاضل والتكامل أعطى فهماً متقدماً للعدد صفر بتحديده أن الصفر، وإنْ كان نفياً لأي كم محدَّد، إلّا أن هذا التحديد لا يجعله خلواً من أي مضمون، لا بل له مضمون محدَّد، فهو الحد الفاصل بين المقادير الموجبة والسالبة، وهو العدد الوحيد الحيادي حقاً، الذي لا يمكن أن يكون لا موجباً ولا سالباً. إنه ليس عدداً محدَّداً جداً، فحسب، بل أيضاً أكثر أهميَّة، بطبيعته، من سائر الأعداد، التي يفصل بينها. وهو العدد الوحيد الذي يدخل في علاقة متناهية مع أي عدد آخر “إن المضمون الحقيقي للمعادلة لا يظهر بوضوح إلاّ عندما ننقل جميع حدودها إلى طرف واحد، وبذلك تتحول المعادلة إلى صفرية، كما هو الحال في المعادلات التربيعية (من الدرجة الثانية)، وهو القاعدة العامة تقريباً، في الجبر العالي. إن التابع لـ (س،ع)=∴ يمكن أن يوضع أيضاً مساوياً لقيمة معينة لـ ص، حتى نفاضل هذا الـ ص (برغم كونه = ∴) مثل أي متحول عادي، ونحصل على مشتقه الجزئي. غير أن عدم كل كمية معينة مفردة يتضمن، هو نفسه، تحديداً كمياً أيضاً. بفضل ذلك، وحده، يمكن التعامل بالصفر”. (انجلز فريدريك، ديالكتيك الطبيعة مصدر سابق، ص.ص. 304-305).
يكمل إنجلز بحثه للعدد صفر بإظهاره أهميته في الهندسة التحليلية، فالنقطة صفر أهميتها لا تكمن في أنها نقطة متميزة بمقدار موجب أو سالب وحسب بل “تكتسب أهميتها أيضاً أنها النقطة التي تعتمد عليها باقي النقاط، بها ترتبط وإليها تضاف وبها تتحدد. وإن أخذت هذه النقطة في حالات معينة بصورة اعتباطية [اقرأ: اختيارية/ تحكمية لأن إنجلز استخدم مصطلح Arbitrary الذي يعني، في حساب التفاضل والتكامل، اختياري/ تحكمي]، إلاّ أنها تصبح النقطة المركزية للعملية كلها، وتحدد غالباً اتجاه الخط الذي يجب أن تندرج عليه النقاط الأخرى. أي النقاط المحدودة لاحداثيات السينات”. (المصدر نفسه، ص. 305). يضيف إنجلز أنه حتى الصفر المطلق لميزان الحرارة ليس نفياً مجرداً بل يمثل حالة محدَّدة للمادة، أي أنه الحد الذي يتلاشى عنده آخر أثر للحركة الجزيئية المستقلة، حيث تفعل المادة ككتلة ليس إلّا. ليخلص إلى استنتاج أنه “حيثما نصادف الصفر، نراه يمثل شيئاً محدداً تماماً. وإن تطبيقه العملي في الهندسة، والميكانيك، وغيرها، ليبرهن أنه – كحد – أهم من كافة المقادير الحقيقية، التي يحدها”. (انجلز فريدريك، ديالكتيك الطبيعة، مصدر سابق، ص. 306).
لقد وضعت النظرية الماركسية – اللينينية، في بحثها للعلوم، أعمال إنجلز، ومخطوطة ماركس في الرياضيات، وكتاب لينين الرائد “المادية والمذهب النقدي التجريبي [الأمبيري]”، الأسس المادية العلمية لدراسة الاكتشافات العلمية النقيضة للفهم المثالي، بمختلف مذاهبة وتياراته، مظهرة غنى المنهجية المادية العلميّة النقيضة للدغمائية، وكيف عملت على جعل العلم، بمختلف حقوله، أداة من أدوات النضال ضد الرأسمالية.
(*) – انجلز فريدريك، ديالكتيك الطبيعة، مصدر سابق، ص. ص. 312، 313، 317. ومقالة انجلز “أصول اللامتناهي الرياضي في العالم الواقعي” جماعة من الأساتذة السّوفيات، موجز تاريخ الفلسفة، ترجمة وتقديم: توفيق سلوم، دار الفارابي، بيروت، ط1، 1989، ص. 459.
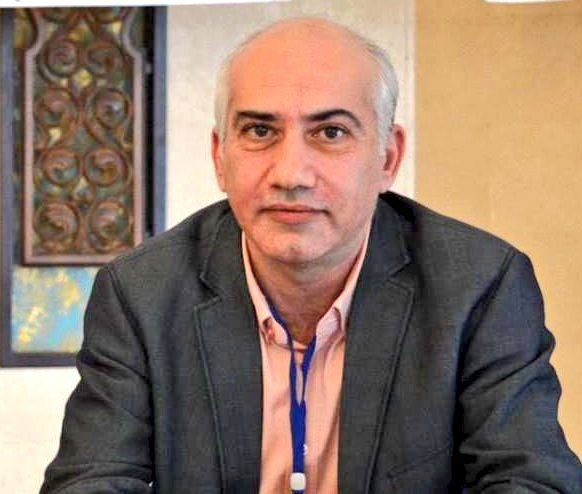
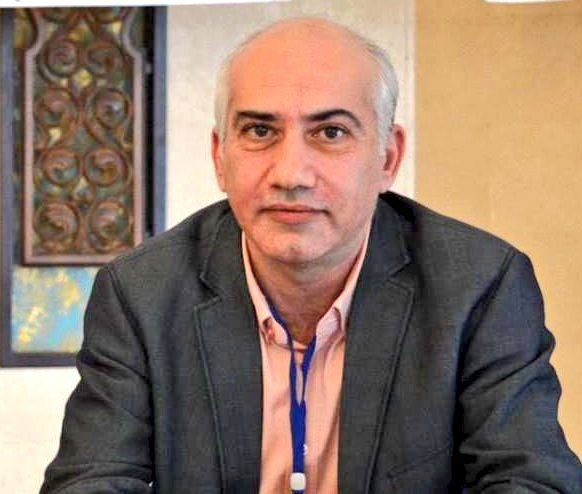
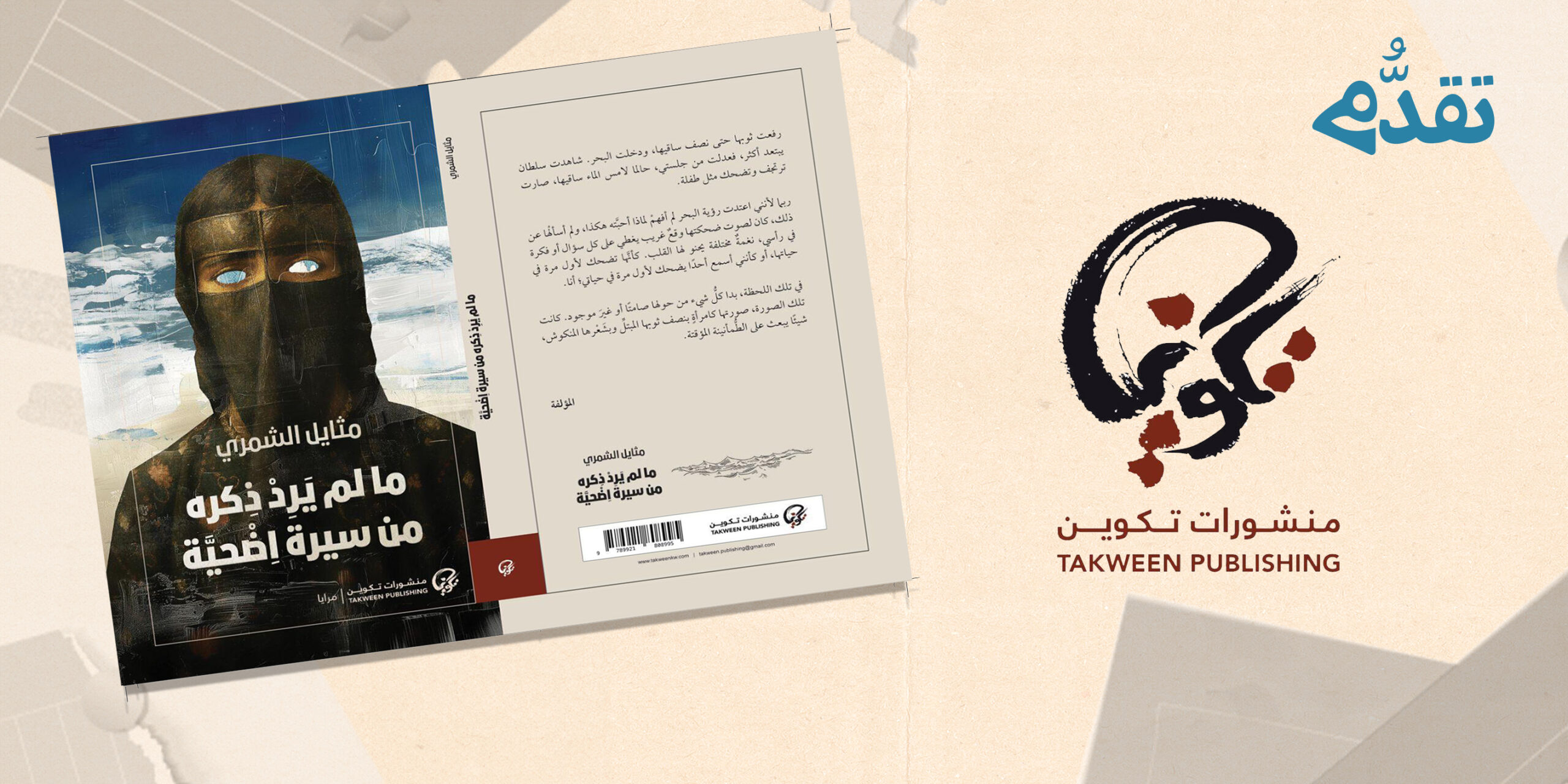
صدر عن منشورات تكوين رواية ” ما لم يَرِدْ ذِكره من سيرة اِضْحيَّة” لـ مثايل الشمري. “الحقيقة ليست مقيَّدة بأن تُوجِد الأشياء أو تحدث، وإنَّما
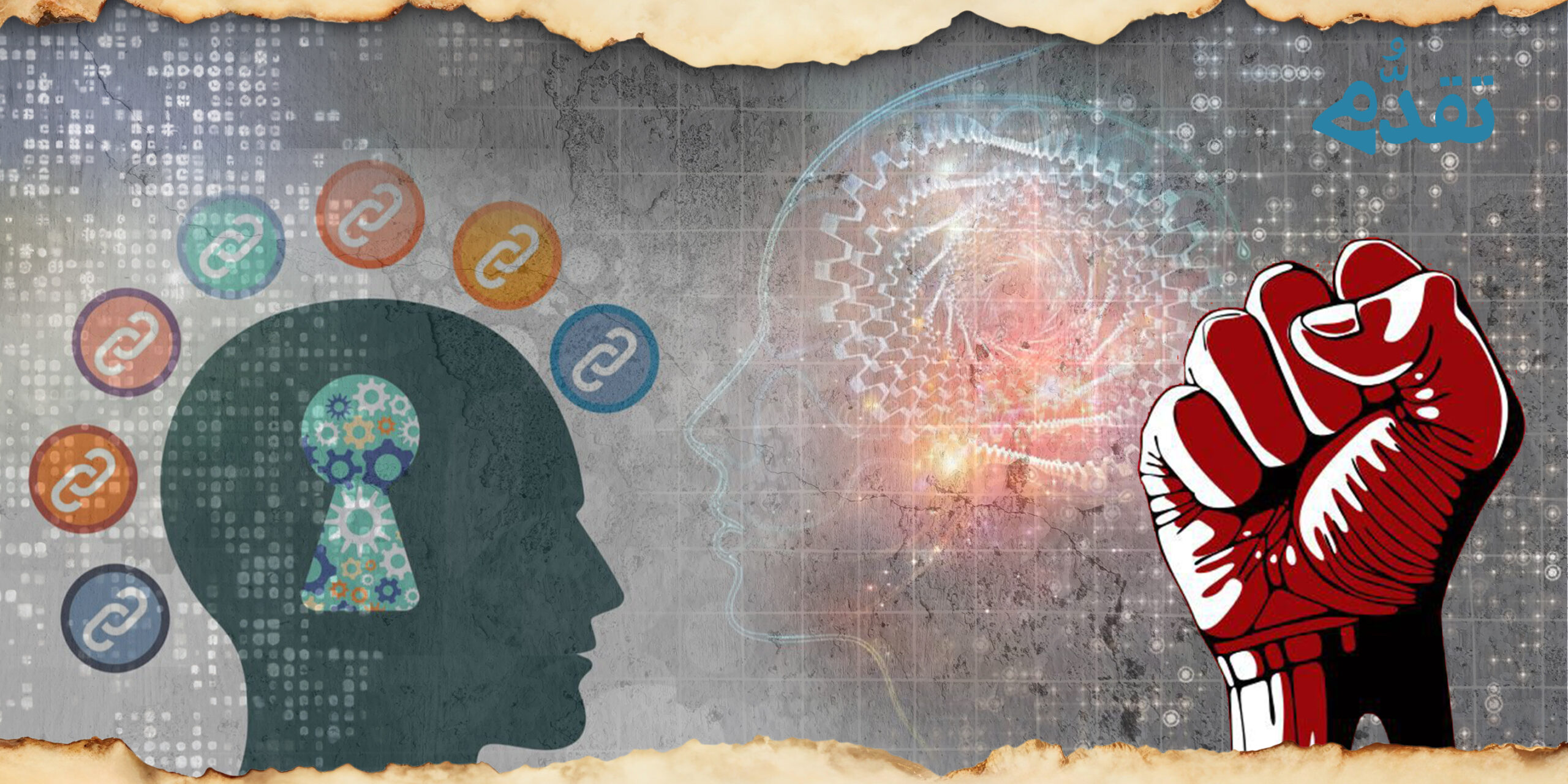
حصر الوضعية المنطقية مهمة الفلسفة بالتحليل المنطقي للغة يعني أتها تئد الفلسفة، والعلم ،والإبداع، تقيد الفلسفة بمجال واحد تصادر فيه باقي مفاهيم الفلسفة ومهمتها المناقضة لها، وتمنع حرية اختيار مفاهيم أخرى لها.

في رواية “مِخْيال معيوف” يبدأ السرد من ولادة معيوف في صحراء الشعيب غرب الكويت، حيث يقضي الأشهر الستّة الأولى من حياته عليلًا قبل نقله إلى

اللغة هي الحاضنة الأولى للهوية، والوعاء الذي تنعكس فيه الحضارة، وأداة الشعوب في صياغة وعيها ومكانتها بين الأمم. وفي زمن العولمة المتسارعة، تتعرض اللغة العربية